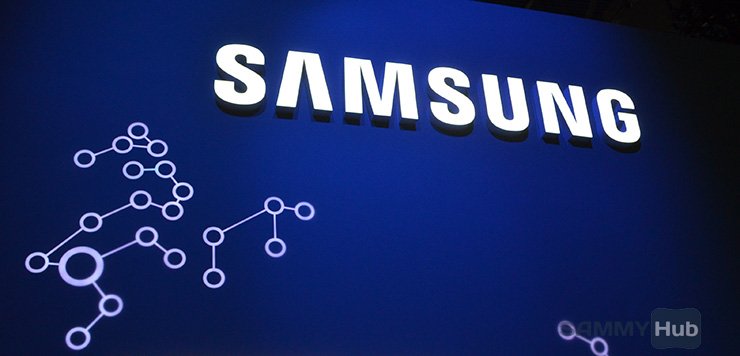أستعير الفكرة، هنا، من رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، إبان الحرب العالمية الثانية، وهو يتحدث عن خطر ترك اتخاذ قرار الحرب وخوض غمارها بأيدي العسكريين. ذلك أن الحرب هي مجال للقرار السياسي الإستراتيجي حصرا، وهو من صميم اختصاص رجال السياسة، وما على العسكريين، سوى السهر على وضع وتنفيذ الخطط الكفيلة بربح الحرب التي تدعو الضرورات السياسية إلى خوضها.
وكذلك يمكن القول، مع تحوير جوهري لفكرة تشرشل، في شأن التعليم عندنا تماما، بحيث لا ينبغي تركه تحت رحمة التجاذبات الحزبية السياسية الضيقة بالتعريف، خاصة ونحن نعاين النتائج الكارثية لمثل هذا السلوك، الذي حول تعليمنا إلى حقل لتجارب فاشلة، في أغلبها، ومدمرة للأجيال علاوة على هدر أموال طائلة في الذي لا طائل يرجى منه. إذ يكفي مساءلة التقارير الوطنية والدولية الجادة للتأكد من كون الحصاد هزيلا جدا، على كثير من المستويات، وفي مقدمتها مستوى الأمية المنتشرة في مختلف الأوساط بشكل مخيف، وخاصة لدى الفئات الفقيرة من المواطنين ، رغم أن القرار الإستراتيجي المعلن للدولة هو تعميم التعليم منذ عقود طويلة. بل إنه كثيرا ما تم الإعلان أن تعميم التعليم في وضع المتحقق في فترات ما.
إن هذا الوضع يسائل الجميع ويحتم على مختلف الفاعلين معالجة المشكلة من أساسها، وليس الإكتفاء بتناول أعراضها ومظاهرها بنوع من التشذيب والترميم حينا، والمراوغة غير المجدية أحيانأ أخرى.
واليوم، هناك من يرغب في اختزال مشكلة التعليم بالمغرب في مسألة لغة التدريس، حيث يتبادل هؤلاء مع خصومهم الإتهامات صباح مساء بخصوص مسؤولية الفرنسة أو التعريب عن واقع تدهور أوضاع التعليم العمومي والحال إن لغة التدريس ليست غير جانب من الجوانب التي اعتورها الخلل، خلال مسيرة المنظومة التربوية منذ استقلال المغرب، إلى درجة يمكن القول معها: إن الإرتجال قد طغى على كثير من قرارات وزراء التربية الوطنية في هذا المجال، لذلك لم يكن التعريب المجرب ضمن استراتيجية بعيدة المدى التي تتطلب إغناء اللغة العربية وإثراءها بمكتسبات العلم الحديث في مختلف المجالات. ولذلك لم يكن حظ الفرنسة بأفضل من التعريب حيث تم تصويره باعتباره مناهضا للهوية الوطنية للمغاربة حينا وحيث تم النظر إليه تارة أخرى بأنه موجه ضد اللغة العربية. وفي كل الحالتين لم بتم التعامل وفق رؤية استراتيجية لدور التعليم في بناء أعمدة مجتمع فاعل قادر على التفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي وهو مسلح بالتكوين والمعرفة الضروريين لرفع تحديات التنمية ومواجهة معوقات التطور.
فأن يعلن وزير التربية الوطنية المغربي أن نسبة المتمدرسين في التعليم التقليدي في البلاد تتجاوز نسبة المتمدرسين في التعليم العصري، الخصوصي والعمومي، مثلا، فهذا يعني أن الأمور ليست على ما يرام ونحن نكاد نودع عقدين كاملين من عمر القرن الواحد والعشرين.
وهناك مسألة أخرى تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي في الوقت الراهن وهي مسألة واقع التعليمين العمومي والخصوصي في البلاد.
وفي هذا السياق تحدث وزير التربية الوطنية عن الدور الإيجابي الذي يقوم به التعليم الخصوصي وأعلن ضرورة دعمه بشكل ملموس حتى يقوم بدوره المطلوب في مجال تعميم التعليم كما تحدث على ضرورة العمل على تمكين أبناء الفقراء من التعليم الخصوصي بما في ذلك في المناطق القروية.
وقد دفع هذا الموقف المعلن للوزير بالكثيرين إلى طرح السؤال الإستنكاري التالي:
ماذا يعني تقديم الدعم للتعليم الخصوصي، إذا لم يكن تحضير الظروف الملائمة للتخلي عن التعليم العمومي؟ إن قول الوزير برغبة الحكومة في استفادة أبناء الفقراء من التعليم الخصوصي عبر استحداث منح يستفيدون منها ليس إلا من أجل إخفاء حقيقة أن الهدف هو التغطية على الإمتيازات التي ستقدم إلى لوبيات التعليم الخصوصي مع أن دراسات كثيرة أثبتت أن جودة هذا التعليم أقل بكثير مما يتم الترويج له من قبل القيمين على مؤسساته المختلفة.
وهناك من يركز على أن الدعم الحقيقي للتعليم يمر عبر الإلتزام بالتوجيهات الملكية خاصة تلك التي جاءت بعد الإعلان عن قصور النموذج التنموي المغربي واستنفاد إيجابياته. إذ مما لا شك فيه أن النظام التربوي سيكون أحد المحاور الرئيسية في كل نموذج تنموي قابل للحياة للعقود المقبلة . ذلك أن القدرة على مواكبة التطورات الدراماتيكية التي تعرفها مختلف مجالات العلم والتكنولوجية تتطلب نموذجا تنمويا متماسكا في مختلف مرافقه، مرنا في تعاطيه مع المستجدات في مختلف المجالات، وواضعا في مقدمة اهتماماته ورهاناته تكوين أجيال قادرة على أخذ زمام المبادرة وابتكار أساليب نوعية في مواجهة تحديات النمو والأزمات المرافقة للتقدم العلمي العالمي.
ويبدو أن استقالة التعليم العمومي عن أداء هذا الدور خطأ استراتيجي كبير، على اعتبار كون هذا التعليم بالذات هو القادر على صهر الشخصية المغربية في بوتقة التقدم لأنها هي الوحيدة القادرة على استحضار المصلحة العليا للوطن في مختلف مراحل العملية التعليمية.
وبطبيعة الحال، فإن اعتماد التعليم العمومي أساسا في النموذج التنموي المنشود، ليس يعني الإنغلاق على المبادرات الاستثمارية الحرة، في هذا المجال، بحيث تؤول إلى الدولة مسؤولية السهر على أن لا يتخذ لنفسه مسارا مضادا للتوجهات الأساسية للدولة لما لذلك من نتائج سلبية أكيدة على تطور البلاد ومستقبل أجياله. وسيكون هذا أخطر بكثير متى تم ترك الحبل على غارب كل من هب ودب لولوج هذا القطاع تحدوه في ذلك بشكل شبه حصري الرغبة في تحقيق الربح السريع على حساب المواطنين الذين فقدوا الثقة في التعليم العمومي معتقدين أن التعليم الخصوصي هو الخلاص.
إن أهمية التعليم الخصوصي ينبغي أن تتجلى في الدور التكميلي الذي يقوم به مقارنة بالتعليم العمومي الذي ينبغي أن يظل العمود الفقري والمحور الرئيس للعملية التربوية في بلادنا.
وإذا أضفنا إلى هذا وذاك مسألة عدم التناسب بين التعليم العصري بفرعيه العمومي والخصوصي مع التعليم التقليدي، لفائدة هذا الأخير، كما تبين ذلك من الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية المغربي بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد بمختلف أسلاكه، فإن كل هذا يدعو إلى وقفة جدية جديدة لإعادة تحديد المسارات بما يتوافق مع بناء المجتمع الحداثي المنشود. وهذا لن يكون إلا بالقطع مع إخضاع التعليم للتجاذبات الحزبية الضيقة أو تحويله إلى نسخة مشوهة للتعليم في هذه البلاد أو تلك من البلدان المتقدمة تحت أي تبرير كان.