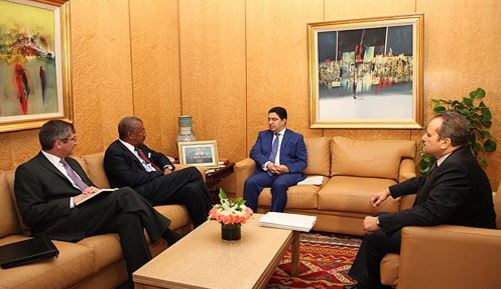هناك دول وقوى سياسية حريصة أشد الحرص على الدفاع عن حقوقها، والعمل على تحقيق مصالحها المختلفة باعتماد الطرق الشرعية، إيمانا منها أنها الطرق الوحيدة القادرة على تحقيق تلك المصالح والدفاع عن تلك الحقوق، دون الاعتداء على مصالح الغير وحقوقه، التي لا تقل مشروعية. إضافة إلى أن كل المكتسبات، التي يتم تحقيقها عبر هذا الأسلوب، مرشحة للاستمرار والتراكم، ما دامت لم تكن محصلة اعتداء يستدعي لانتقام أو نتيجة اغتصاب يفرض على الطرف المغبون واجب القتال من أجل استعادة الحقوق المغتصبة، باعتماد كل الأساليب المتاحة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، كما تنص على شرعية الامم المتحدة في حالات تندرج ضمن استخدام مبدأ حق الدفاع عن النفس.
وهناك دول وقوى سياسية، في المقابل، لا تعير أدنى اهتمام للطرق الشرعية في الدفاع عن ما تعتبره حقوقها، وما تراه هو عين مصالحها. حيث تصبح كل الوسائل مقبولة لديها، بما في ذلك الاعتداء السافر على حقوق الغير ومصالحه، ماديا ومعنويا، بقوة السلاح والعدوان العسكري بمختلف أشكاله وكثافته. إذ قد يتخذ شكل حرب وغزو واستعمار كما قد يتخذ شكل تنظيم حرب عصابات إرهابية اعتمادا على عناصر داخل البلد المعتدى عليه، أو على العناصر التي يتم جلبها من الخارج لهذه الغاية، كما هو شأن كل المرتزقة الذين يدمرون هذا الوطن أو ذاك، مقابل أموال أو منافع أخرى، من نفوذ وامتيازات مادية ومعنوية. وبطبيعة الحال، فإن هذه الدول والقوى لا توفر بهذه الطريقة ظروف الاستفادة من المكتسبات لأمد بعيد، بل إنها، على العكس من ذلك، تماما، تجد نفسها مهددة بفقدانها مجتمعة ودفعة واحدة، أو الواحدة تلو الأخرى، كلما تحركت الدول أو القوى السياسية التي وقع عليها الظلم لاستعادة حقوقها. وهو أمر لا فكاك منه على الإطلاق، بغض النظر عن المدة الزمنية التي يستغرقها ذلك، والعوامل التي ينبغي الزج بها والكلفة المادية والمعنوية المترتبة عنها حتما.
وليس هناك أقوى دلالة على هذا الواقع من نضال الشعوب ومقاومتها للاستعمار المباشر، خلال مختلف العصور. وهو ما توج بنيل الاستقلال السياسي واستعادة السيادة كاملة غير منقوصة، بالنسبة لبعضها، أو تحقيق مكتسبات جدية على هذه الطريق بالنسبة لشعوب اخرى، رأت ان القطع مع الاستعمار والتحرر منه لن يكون ناجزا إلا بقدر ما يتم قطع مختلف أواصر التبعية الاقتصادية أو الثقافية للدول الاستعمارية، حيث يعتبر إعلان الاستقلال السياسي المرحلة الضرورية الأولى، نحو الانخراط في النضال التحرري العميق. وهذا ما يعني أن الدول المغتصبة تجد نفسها في بؤرة التوتر والصراع، تارة للتستر على عدوانيتها تجاه الغير، وتارة لتحصين ما تعتبره مكتسباتها، وتارة أخرى، في مواجهة كل تحرك من أصحاب الحق الحقيقيين يرمي الى رفع الظلم واستعادة ما هو مسلوب منها عنوة في فترة الاختلال الكبير في موازين القوى لصالح قوى العدوان الاستعماري .
هكذا يكون الأسلوب الأول الطريق المختصر إلى نوع من التعايش والسلام المحلي والإقليمي والدولي، بينما يقوم الثاني بدور الصاعق لكل الأزمات السياسية والنزاعات المحلية والإقليمية والدولية، التي تتطور في مستوى ما من مستوياتها الى نزاعات عسكرية لا تبقي ولا تذر.
يقوم منطق الدول الأولى على فكرة المساواة والندية بين الدول في مجالات السيادة، وما يعبر عنها من ممارسات وقدرات، وفِي مقدمتها حرية اختيار الشعب لقياداته، وحق التصرف المستقل في مقدراته وثرواته في مختلف المجالات، وعدم الاعتداء على الدول الأخرى أو التعرض لاعتدائها بأي شكل من الأشكال، وذلك في احترام تام لعدد من المبادئ الاخلاقية والسياسية التي تشجع على توازن المصالح وتبادلها على أنقاض كل أشكال الفرض والهيمنة واحتكار المصالح المادية والمعنوية.
هذا، بينما تعطي الدول الثانية الأولوية لتعظيم مصالحها، التي توضع في مواجهة مفتوحة مع مصالح الدول الأخرى، التي تعمل على حرمانها من الاستفادة من خيراتها وثرواتها، وما يمكن جنيه من رعاية مصالحها والدفاع عنها بالوسائل التي تقرها الشرعية الدولية، دون تأويل مغرض لها لخدمة أجندات معاكسة تماما لنص وروح شرعية الامم المتحدة.
إن هذا التحليل لا يقوم على فرضية مثالية مفادها إمكانية قيام حياة سياسية استراتيجية على المستويات الإقليمية والدولية على درجة من المثالية والتناغم، بحيث تنتفي فيها كل أشكال الاختلاف في الرؤى والاستراتيجيات والتنازع السياسي بين الدول والشعوب، لأن مثل هذا التصور مجرد وهم، ليس له أي قاعدة تسنده على أرض واقع العلاقات الدولية، في مختلف العصور، بل الهدف هو الإشارة إلى أن اُسلوب التعاطي مع قضايا الخلاف وتعارض مصالح الدول ينبغي أن لا ينحصر في استخدام القوة الخشنة التي لن تكون ذات فائدة تذكر إلا عندما تصبح ضرورة ملموسة لإعادة الاعتبار للمقاربات السياسية الدبلوماسية على قاعدة الحوار، لأن استخدام القوة العسكرية لم يكن يوما، ولا ينبغي أن يصبح، غاية في ذاته، لأن ذلك يعني تحويله الى وسيلة لتقويض الأمن والاستقرار العالمي، وهو ما يتنافى مع الغايات الحقيقية للاجتماع البشري ذاته، وليس سلامة العلاقات الدولية فحسب.