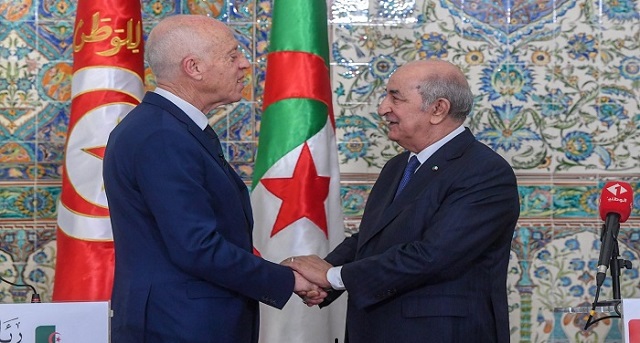بقلم: علي الشامي
مقدمة
لم يعرف المغرب العربي الحديث مشكلة أكثر تعقيدا وخطورة من مشكلة الصحراء (الغربية) المغربية، ولم تدخل حكومات ما بعد الاستقلال في دائرة استنزاف متبادل، منذ حروب التحرير حتى اليوم، كما هي فاعلة لحظة كتابة هذه السطور. الأمر الذي يدفع إلى الظن بأن الاستنزاف نفسه بات هدفا لصراع يشوبه توازن دقيق صعب التجاوز، وبالتالي يصبح، أي الاستنزاف- معادلة سياسية، والصحراء (الغربية) المغربية عقدة مستعصية على الحل، تكمن أهميتها في استمراريتها كذلك، أي كعقدة تلتقي عند أعتابها استحالة الغلبة واستمرارية التوازن.
اعتبارها عقدة لا ينزع عنها مواصفات كونها قضية قائمة بذاتها عند البعض، وخاصة منهم الصحراويين، وإنما يشير إلى كونها مركزا لتراكم مجموعة كبيرة من التناقضات الداخلية والخارجية، التي يستحيل معالجة موضوع الصحراء بشكل نهائي بدون حلّها حلاً جذريا. ففي حين يعتبر الصحراويون المنتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو) أن موضوع الصحراء يشكل مجرد قضية تحرير وطني للشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي، تكتشف مشكلة الصحراء نفسها عن مدى ارتباط أزمة دول المغرب العربي الحديثة بها، ومدى تأثيرها على مجريات الأمور والأحداث في داخل كل دولة وفيما بين هذه الدول جميعها.
فالصحراء (الغربية) تشكل الامتداد الجنوبي للمغرب، والامتداد الشمالي لموريتانيا، والامتداد الغربي للجزائر، أي أنها نقطة الوصل التي تربط هذه الدول الثلاث ببعضها البعض. مما يعطيها، انطلاقا من موقعها الجغرافي، أهمية خاصة في مشروع وحدة المغرب العربي. أما كيف تتحول الأهمية الوحدوية إلى عقدة في وضعية التجزئة، فإن في ذلك ما يفضح المعادلة التي تجعل من الصحراء الغربية تعبيرا لمشاكل أخرى نتجت أساسا عن قيام الدول المذكورة، وعن سيادة منهج التجزئة في المعالجة الرسمية لكافة المشاكل. ولما كانت حكومات هذه الدول تنمو وسط تناقضات ما بعد الاستقلال، ويترافق استقرارها مع ضرورة تأمين التشريع الإيديولوجي-الجغرافي للشعب الذي تحوّل إلى شعوب، والأرض التي استحالت أراضي، والدولة التي ذابت في دول، فإن همّ الصحراويين، أو الشعب الجديد، ينعقد مع هموم الشعوب المحيطة به والتي لم يسبق قيامها ولادته إلاّ بسنوات قليلة.
إذن، تتحول الصحراء (الغربية) المغربية إلى عقدة التجزئة لحظة انخراطها في معادلة الشعب-الدولة، ولحظة احتوائها لكافة الشروط الجغرافية المنعكسة في حاجة دول المنطقة إلى حدود ثابتة جديدة وطويلة الأمد. وبينما يناقض الماضي الحاضر، وتتحول الصحراء من أرض حاضنة لمشاريع الوحدة في المغرب العربي إلى بؤرة جذب لمشاريع التجزئة، تعكس الحلول المطروحة من قبل كافة الأطراف اتجاهاً جماعياً نحو تركيز وتشريع وضعية التجزئة. لا يغيّر من طبيعة هذا الاتجاه اقتراب الحل المغربي من الماضي التاريخي التجاوز للتقسيم الاستعماري، ولا إلحاح الحل الصحراوي الباحث عن الوحدة المستقبلية من خلاله اشتراطه عبور جسر التجزئة.
كان من الممكن لهذه القضية أن تأخذ مسارا آخر أقل تعقيدا لولا أنها ترتبط بعوامل أخرى لعبت، ولا تزال، دورا هاما في دفع الأحداث نحو المزيد من التعقيد والتأزم. فقد ترافق انفجار أزمة الصحراء مع ازدياد الحاجة الأمريكية لنقاط تفجير متنوعة تتمكن بواسطتها من عزل منطقة المغرب العربي عن المشرق، وإبعاد هموم هذه المنطقة بحكوماتها وشعوبها عن همّ المشرق الفلسطيني. وليس مصادفة بدء الحرب الأهلية في لبنان لتطويق الانتصارات الفلسطينية والعربية في نفس الفترة التي تصاعد فيها أزمة الصحراء ، كما أنه ليس مجرد مصادفة أن يتزامن التوقيع على اتفاقية سيناء مع التوقيع على اتفاقية مدريد، وكلتاهما اتفاقيتان تتضمنان مواد للتفجير واستمرار للتناقضات وليس حلولا لها.
تلتقي هذه الحاجة مع ازدياد الصراع الدولي للسيطرة على أفريقيا وإعادة ترتيب التوازن الدولي السوفياتي-الأمريكي والأوربي الغربي بعد الاختلال الذي اعتراه بوصول «ماركسي» إلى السلطة في أثيوبيا، وتحول عدة حركات تحرير أفريقية إلى دول صديقة للاتحاد السوفياتي، وبدء الهجوم السوفياتي الاستراتيجي الهادف إلى إحكام السيطرة على الممرات المائية التي تتحكم برحلات النفط العربي والإيراني إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة. مما يدخل قضية الصحراء ودول المغرب العربي في دوامة صراع دولي يتحكم في مصيرها ويخضعها لشروطه: الاستنزاف الطويل الأمد داخل توازن جزائري-مغربي لا تسمح له التوازنات الدولية بالاختلال لمصلحة أحد الطرفين. وبالتالي، انتظار ما ستؤول إليه الأمور على مداخل البحر الأحمر وفي الشرق الأوسط وإيران الخميني والمحيط الهندي والقرن الأفريقي وأفغانستان ويوغسلافيا ما بعد تيتو وكوبا المنحازة وغير المنحازة وهند أنديرا غاندي والانتخابات الأمريكية والمشاريع الأوروبية بقيادة فرنسا وهوية خلفاء بريجنيف…
ضمن هذا السياق تبدو عملية التأريخ مرهونة بمسار الأحداث، بحيث ينفصل، نسبيا، التاريخ عن التطور الحدثي لمستجداته الراهنة، وتصبح الحاجة لمعرفة هذا التاريخ مدخلا لاستيعاب تواصله اللاحق سلبا وإيجابا، وشرطا لا غنى عنه للإلمام بأهم أزمة معاصرة يعيشها المغرب العربي.
وفق أية منهجية ينبغي التعاطي مع الموضوع: وفق نظرية الحق الشرعي للمغرب الأقصى التاريخي أم وفق مقولة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي؟ وعلى أية مواقف ينبغي الاعتماد في تفسير التاريخ: على مواقف المغرب الرسمي وأحزابه المتعددة الهويات، على مواقف الجزائر الحديثة العهد، على مواقف موريتانيا المنسجمة مع الظروف الطارئة، على مواقف صحراويي تندوف أم على مواقف صحراويي العيون؟ وانسجاما مع أية وجهة تاريخية ينبغي تقديم المعرفة النظرية: مع الاتجاه التاريخي الوحدوي المكبوت أم مع الاتجاه التقسيمي المستقر بعد سنوات العنف الإمبريالي وجغرافية ما بعد حرية المستعمرات؟…
الانحياز للاتجاه الأول يلمح إلى القبول بوجهة نظر المغربي الرسمي والحزبي، فتقوم وحدة المغرب الأقصى (بدون موريتانيا) وتتأجل وحدة المغرب العربي إلى أجل غير مسمى، مما يفتح ثغرة رئيسية في الاتجاه التاريخي الوحدوي نفسه. الانحياز للاتجاه الثاني يلغي الماضي التاريخي وينظّر للتجزئة، ويتوافق مع هدف القائلين بتقرير المصير وقيام دولة صحراوية ستنظر –أي هذه الدولة- فيما بعد إلى موضوع الوحدة وتأخذه بعين الاعتبار، الأمر الذي يخضع الحقيقة التاريخية لضرورات التكتيك، ويبقى المغرب في وضعية سياسية-جغرافية عمل الاستعمار الغربي على ترسيخها منذ أكثر من قرن، وما زال يحلم باستمرارها.
العملية صعبة ومعقدة، حاولنا تجاوزها بمراجعة موضوعية لهذا الموقف والمنهجيات، مع انحياز حذر للاتجاه الوحدوي التاريخي المتعانق مع وحدة المغرب العربي. ودون أن يغلب الانحياز على الموضوعية-لأنه ليس في الكتابة التاريخية موضوعية بالمطلق تلغي الانحياز- بذلنا جهدا كبيرا للخروج من التمايز الفاصل بين الموقف الذاتي وعملية التأريخ بأقل الخسائر العلمية الممكنة. إذ الهدف من هذا العمل ليس مجرد إعلان موقف سياسي بقدر ما هو مساهمة في كتابة تاريخ قضية يجب أن تصل تفاصيلها إلى كل فرد في العالم العربي، وخاصة في المشرق، بعد سنوات الانقطاع الثقافي.
عندما نصل إلى مادة البحث نفسه، تزداد العملية صعوبة. فالكتابات التفصيلية شبه معدومة، ولم تتكاثر إلا في فترات لاحقة ولأسباب تعبوية-دفاعية. فالأطراف المعنية نفسها، وخاصة في منطقة المغرب العربي، لم تكتب عن الصحراء بشكل وافٍ يجعل من الممكن وضع الدراسات المتناقضة في مواجهة مع الواقع، خاصة وأن الكتابات المتأخرة تشهد طلاقا ملحوظا مع الماضي التاريخي. وفي حين يغيب التأريخ الجزائري كليا، وتكرّر المنشورات الصحراوية نفسها مع تركيز على نهضة تاريخية بدأت مع ولادة البوليزاريو، تقدّم المساهمات المغربية، الحزبية خاصة، خدمة كبرى للباحث عن تاريخ قضية أهمل أصحابها تأريخها. دون أن يعني ذلك أن هذه المساهمات موضوعية، بل بالعكس تماماً فإنها لا تخرج عن نطاق كونها داخلة في سياق العمل التعبوي اليومي دفاعاً عن قضية يعتبرها أصحابها غير خاضعة للمساومة، لا على صعيد التكتيك السياسي اليومي ولا على صعيد الكتابة التاريخية. ولما كانت المساهمات المذكورة تبتعد إرادياً عن مفاصل المشكلة الرئيسية، فإنها بالتالي لا تعبّر إلاّ عن وجهة نظر أصحابها، وتزيد على البحث العلمي هموماً أخرى.
دفعتنا هذه الأمور إلى تخفيف التحليل والنقاش المنهجي وتغليب منطق العرض الوثائقي لكافة المواقف، بحيث يمكن لكل قارئ أن يقترب من المقارنة والتقويم حسب استنتاجاته وقناعاته الخاصة، وذلك دون أن ندّعي ممارسة حيادية، أو نغيّب حقيقة كوننا قد ساهمنا إلى حدّ ما في إبراز منهج على حساب آخر وإخضاع منطق التجزئة لمصلحة منطق الوحدة.
وسط صعوبات كهذه، لا يمكن الركون إلى الاستنتاجات المستخلصة من الوثائق والمنشورات الرسمية والحزبية، كما لا يمكن اعتبار الأحكام الخاصة نهائية ومطلقة، سيما وأن مواقف الأطراف المعنية تجسد تناقضات دورية في الموقف المبدئي. ما يمكن الإقرار به عملياً وبشكل ثابت هو أن الصحراء الغربية تمثّل عقدة التجزئة، وأنها أداة كشف وتعرية لمجموعة المبدئيات المتمظهرة في مواقف جميع الأطراف. وموريتانيا تعطي المثل الأكثر وضوحا: من مبدأ موريتانية الصحراء في الستينات، إلى مبدأ تقرير المصير في بداية السبعينات، إلى مبدأ تقسيم الصحراء مع المغرب في أواسط السبعينات مرورا بمبدأ تقرير المصير مجدداً للصحراويين، انتهاء بلا علاقة موريتانيا بما يجري حولها، ومشاكلها تكفيها.
لا يخرج عن هذا تحولات الموقف الجزائري، ولا تناقضات الموقف المغربي من موريتانيا سابقاً ومن تيريس الغربية ووادي الذهب لاحقا، ولا انتقالات التجربة الصحراوية نفسها (من مغربية في الخمسينات، إلى وحدوية بخصوصية صحراوية في الستينات، إلى صحراوية صافية مع البوليزاريو) المبدأ الجوهري ليس في «الصحراء» وإنما تحديداً فيما تعنيه الصحراء بالنسبة للجميع. وهنا بالذات ينبغي البحث عن المشكلة والحل.
كنا نود إضفاء تحليل واف، منهجي وإيديولوجي، على تعددية المواقف المذكورة، بيد أننا فضّلنا البدء بتجميع المواقف وعرضها كمقدمة لمناقشتها، وكمساهمة أيضاً في فتح الحوار الجدّي والهادف انطلاقا من مادة محددة نسعى إلى تعميمها وتوسيع رقعة عارفيها، لكي يلتقي الجهد المتواضع مع جهود أخرى، تساعد مجتمعة على بلورة واضحة ومتكاملة، علّها تساعد على انتشال المعاناة الراهنة من ديمومتها السلبية.
تعمدنا في بحثنا تجاوز العمل الكتبي لكي نقترب أكثر من معطيات المشكلة، فاعتمدنا الحوار المباشر والعمل الميداني وتوثيق المواقف، كما رجعنا في ملاحظاتنا إلى أقوال المسؤولين وإلى النشرات الحزبية والرسمية مع اعتماد نسبي على بعض الكتب التي تحدثت مؤخرا عن القضية وخاصة الكتب الصادرة باللغة الفرنسية والتي تجهلها المكتبات العربية بشكل ملحوظ.
ولما كانت مادة الدراسة مستمدة أساسا من وثائق ونصوص رسمية ومراجع متعددة الصياغة، فقد ارتأينا الحفاظ على نصها الحرفي.
وأخيرا، نتوجه بالشكر لكل الذين ساهموا معنا في إنجاز هذا العمل، من مسؤولين مغاربة وجزائريين وصحراويين، حزبيين ورسميين، وجميع الذين ساعدوا بامكاناتهم المتواضعة على إيصال هذا الجهد إلى مبتغاه المنشود.
علي الشامي
الفصل الأول
وعي الذات واستراتيجية الغرب
ملاحظات جغرافية وسياسية
الموقع الجغرافي لشمال أفريقيا أنتج خصوصية تاريخية، سوف تتمحور حولها مجمل التطورات والبنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية، والتي على أساسها يمكن استيعاب كيفية كون المغرب العربي نقطة جذب لصراعات محلية وعالمية منذ غادر الفينيقيون مدينة صور حتى هذه اللحظة، دون تحديد أو مقدرة على تعيين النهاية. نهاية الصراعات السابقة كانت بداية لصراعات جديدة والترافق الدائم لهذه الصراعات مع التحولات التاريخية كان يفرض منطقه ليس فقط على طبيعة المنتصر بل يطال الدول والإمبراطوريات، نشأتها وانحطاطها، مرورا بمجمل الإنتاج الفكري والحضاري.
من الزاوية الغربية لمدينة وعلى امتداد الشاطئ الحار للمحيط الأطلسي وصولا إلى خط الاستواء ونهر السنغال، ومن الزاوية الشرقية لطنجة وعلى امتداد الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى البحر الأحمر عبر مصر، تمتد الحدود المائية التي تربط المغرب العربي بالسنغال وغينيا ومنها إلى أعمق أفريقيا، وتربطه بمصر وفلسطين ومنها إلى المشرق العربي وعمق آسيا الصغرى، كما تفصله عن أوربا من ناحية المتوسط وعن أمريكا من ناحية الأطلسي، مشكّلة في نفس الوقت الممر المائي شبه الوحيد الذي يربط أوروبا بالمغرب العربي، والذي بواسطته يمكن الوصول إلى أفريقيا كلها وآسيا مرورا بالوطن العربي. كما أن اتصال المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط يتم بعبور منطقة مغربية تمتد من طنجة إلى سبته.
الأهمية البرية للمغرب العربي لا تقل حساسية عن الأهمية البحرية. فالانتقال من شمال أفريقيا إلى جنوبها ووسطها أو منها إلى السودان والحبشة وصولا إلى الصومال والشاطئ العربي للمحيط الهندي، يجعل من الممرات البرية نقاط مواصلات ذات أهمية قصوى للأمن والتجارة على حد سواء. من خلال هذه الممرات يلتقي المغرب العربي من ناحية الشرق بليبيا ومصر، ومن ناحية الجنوب والجنوب الشرقي بمالي والنيجر وتشاد والسودان، وذلك من خلال الصحراء الكبرى التي تربط هذه الدول جميعا بباقي أفريقيا وتوصلها جميعا إلى الحدود البحرية. هذه الحدود الجغرافية أعطت للمغرب العربي الميزة الاستراتيجية الأولى التي تدعمت بميزة أخرى، وهي عقدة طرق المواصلات التجارية، التي، إذا أضيفت للميزة الأولى، تشكل المجال الحاسم والإطار شبه الوحيد الذي يحتوي كل التاريخ المغربي بتعقيداته وصراعاته.
الوطن العربي، أو العقدة المركزية للتجارة العالمية، ليس سوى تجمع العقد الصغيرة لطرق المواصلات وممرات القوافل البرية والسفن البحرية الدائمة التنقل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، والتي تخترق العالم العربي ذهابا وإيابا حاملة البضائع والثقافات، ومساهمة في قيام الإمبراطوريات والحضارات.
الموقع الجغرافي للمغرب العربي جعل منه عقدة أساسية في طرق المواصلات التجارية التي تربط أوروبا بأفريقيا وأفريقيا بآسيا من ناحية أولى، وتربط المناطق الأفريقية ببعضها البعض من ناحية ثانية. السفن البحرية-التجارية المحملة بالفضة والنحاس والقصدير من أسبانيا والبرتغال والجزر المجاورة لا يمكن أن تصل إلى أفريقيا إلا عبر الشمال الأفريقي والصحراء الكبرى، حيث تتشكل مرافئ البحر المتوسط والمحيط الأطلسي المحطات الأساسية للقوافل الأوروبية، التي سوف تنتقل بقوافل برية إلى زبائنها، ومصادر البضائع الأفريقية الأخرى. بالمقابل، فإن الذهب السوداني، والعاج وجلود الفهود والأفاعي والعبيد من أفريقيا الاستوائية والوسطى تصل إلى أوربا عبر نفس الطريق بحركة معاكسة. يضاف إلى كل ذلك البضائع القادمة من الهند والصين وبلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية وآسيا الصغرى وإيران ومصر التي يشترط وصولها إلى أوربا المرور بالمغرب العربي وعبور طرقه البرية والبحرية.
أدت هذه الوضعية إلى قيام مدن-ممرات للقوافل التجارية كانت السيطرة عليها كافية لإسقاط أعتى الإمبراطوريات وأقواها. ومعظم المدن في المغرب العربي تتصف بميزة الممر: تقاطع الطرق البرية أو مرفأ بحري. إن مدينة قرطاجة التي بناها الفينيقيون في تونس عام 1101 قبل الميلاد كانت محطة تجارية لقوافل الشرق قبل أن تكون جسر الحضارة الفينيقية إلى عالم البربر. كذلك مدينة لوكسيس على الشاطئ الأطلسي للمغرب الأقصى. إن السيطرة على سجلماسا، بوابة الصحراء، كانت الخطوة الأولى لمشروع إسقاط إمبراطورية وقيام أخرى: السيطرة على طريق تازا كان يستتبع غالبا قيام السلطة في فاس أو مكناس، والسيطرة على سجلماسا كانت الطريق السالكة إلى سلطان مراكش. والعملية ليست تركم مصادفات، وإنما نتاج طبيعي لعالم يعيش على التبادل السلعي والبضائعي تخضع صيرورة الدول فيه إلى نظام صارم وصراع دائم الاشتعال للدفاع أو للسيطرة على طرق المواصلات وعقدها في الشرق والجنوب.
إن التاريخ القديم للمغرب العربي كان تاريخا دائم التوتر تحكمه قوانين الحرب وصراع الإمبراطوريات الكبرى.على شواطئه وممراته الداخلية كان الفينيقيون والرومان واليونان والفرس والبيزنطيون والعرب المسلمون يتناوبون السيطرة بعد صراعات دامية كانت تطيل عمر أحدهم أو تقضي على الإرث الحضاري لآخر. في قلب هذه المعادلة كان سكان المغرب العربي يخوضون صراعا داخل الصراع، في محاولة لرفض سيطرة الآخرين وصنع تاريخ جاهدوا لتحديد شروطه وأسسه بأنفسهم.
كان وعي الذات يتنامى ويترسخ في وسط نار لا تعرف الانطفاء. تناقض مستمر بين ذات تريد أن تصنع تاريخها و«الآخر» الذي يريد أن يفرض تاريخه: صراع المركزة. الموقع الجغرافي-الاستراتيجي للمغرب العربي وخصوصية كونه عقدة للتجارة وطرق المواصلات استتبع ضرورة قيام سلطة مركزية قادرة على فرض سيطرتها على الممرات والموانئ وتأمين رحلات آمنة لقوافل التجارة. الصراع الدائم كان يدور بين قوى تحاول فرض المركزة من الخارج وسكان يريدون مركزة من الداخل، والتناقض ذو دلالات اقتصادية وثقافية في آن واحد. اقتصادية لحظة تعبيره عن صراع ضد السيطرة الخارجية والنهب والإخضاع، وثقافية لحظة تمسك البربر بتاريخهم وتراثهم ورفضهم العنيد لكل المحاولات «الحضارية» التي كانت تستهدف منح البربر وجودا تقاس شروط استمراره بضرورة استمرار التبعية للآخر.
الفتح العربي لشمال أفريقيا والأهمية التاريخية للإسلام في توحيد سكان وقبائل المغرب العربي غيرت معادلة صراع المركزة. لسنا هنا بصدد تقديم تبريرات للفتح العربي ودخول البربر في الإسلام، وإنما نحاول إبراز حقيقة ثابتة وهي أنه منذ الفتح العربي لغاية الآن، والإسلام يشكل عامل الوحدة الذي استطاع العرب والبربر المسلمون في أفريقيا الشمالية أن يعتمدوا عليه في مواجهة الأطماع والمخططات الأوربية منذ القرون الوسطى. العرب كانوا واعين للأهمية الاستراتيجية لشمال أفريقيا، جغرافيا وتجاريا، أهمية تطال نتائجها المشروع العربي-الإسلامي بأكمله.
الصراع العربي-البربري الذي استمر ما يقارب نصف القرن من 647 إلى 700 م (من 26 إلى 81 هـ) انتهى بأسلمة البربر وبدخول المغرب العربي تحت سلطة الخليفة الواحد، وفي ذلك فائدة للطرفين: العرب استطاعوا تأمين حدودهم في مواجهة أخطار البيزنطيين، والبربر شكلوا مع القبائل العربية قوة قادرة على فرض سيطرتها على مناطقها والدفاع عنها في مواجهة العدو الخارجي المشترك.
ومنذ تلك اللحظة بدأت مرحلة جديدة في تاريخ تلك المنطقة، مرحلة لا تلغي إطلاقا ولا لمرة واحدة الأهمية الاستراتيجية المذكورة آنفا. على العكس تماما، فإنها كانت تثبيتا لهذه الأهمية وتدعيما لها بأسس إيديولوجية وبشرية وعلى المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة. إن مصيرا مشتركا كان قد بدأ يشيّد دعائمه في تلك المنطقة. البربري الذي كان يتعامل، ولفترة طويلة، مع العربي بوصفه غريبا ودخيلا، اكتشف أن هذا الأخير يعطيه قوة غير محدودة ويشاركه مصيره ويواجه معه الهجمات الأوربية. والعربي الذي كان يتعامل، ولفترة متأخرة، مع البربري بوصفه فاتحا، اكتشف أن وحدته ومساواته مع هذا الأخير ليست فقط حاجة تكتيكية لحماية الوجود الإسلامي في أسبانيا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمة العربية-الإسلامية كلها.
الإسلام، قوة التوحيد الأساسية بين العرب والبربر، تدعّمت بحضارة عربية إسلامية مغربية ومشرقية، بمصير مشترك، منتجة بذلك وضعية جديدة غيرت تاريخ تلك المنطقة وأعطته أبعادا سياسية وإيديولوجية سوف تتجندل على أعتابها كل المحاولات الخارجية المستهدفة السيطرة من خلال التجزئة بين عرب وبربر من ناحية وبين قبائل ومناطق كل طرف من ناحية أخرى.
بدأت «الذات» تتلمس طريقها وتثبت قدرتها على بناء نفسها حضاريا وسياسيا، فتقدم نفسها حامية لطرق المواصلات وفارضة شروطها على الغرب، بينما يجتهد هذا الأخير في إثبات هزال هذا المنطق، تارة باللجوء إلى فضل الآخر في صنع التاريخ المحلي لشمال أفريقيا، وطورا بالبحث عن مفارقات وتناقضات الإنتمائيين العربي والبربري لسكان المنطقة، وذلك طبعا ضمن مخطط للسيطرة على المدخل البحري والبربري لأفريقيا وآسيا ووضع اليد على أهم طرق مواصلات التجارة العالمية.
ما يهمنا من كل ذلك الإشارة إلى الموقع الجغرافي للمغرب العربي وأهميته الاستراتيجية سابقا وحاضرا، وإلى مفاصل السياسة الغربية المرتكزة على نفي «الذات» وإلحاقها بالآخر من خلال تجزئة المغرب العربي. «الإشكالية الاستعمارية في جملتها هي المقصود بالرفض، تلك التي ترى في المغرب متفرجا غريبا ولا واعيا على تاريخ يصنع فوق أرضه».(1).
محطات الاتجاه الوحدوي ونشأة الدول
داخل المنطقة التي حاولنا في الصفحات السابقة رسم خطوطها التاريخية تتعايش مجموعة من القبائل، كانت تناقضاتها وعدم قدرتها على توحيد نفسها وفرض سيطرتها عاملا هاما من العوامل التي سهلت دخول الإمبراطوريات القديمة. غلبة منطق العصبية القبيلة كان المانع الأكثر قوة لقيام دولة مركزية واحدة في شمال أفريقيا. وبالتالي فإن عملية التاريخ لمجتمع شمال أفريقيا لا يمكن أن تعطي أحكاما علمية دون الإلمام التفصيلي بتطور البنية القبلية لهذا المجتمع. المهمة صعبة ومعقدة ولكن تجاوزها ينتج تأريخا لا يمكن وصفه إلا بثرثرة سياسية.
إن الحد القاطع الذي يفصل بين حرية القبيلة وتعددية مراكز التقرير السياسية وبين الحاجة الملحّة لتنظيم مركزي يدخل مجموع البنى الاجتماعية في مشروع تأسيس سلطة واحدة فوق المجتمع، تضبطه وترسخ أقداما محلية ثابتة على مفترقات الطرق والمدن الساحلية، كان قد بدأ ينحني أمام اتجاه المركزة. «الموضوعي» كان يفرض احتواء «للذاتي» بحيث تصبح عملية اللامركزية السائدة وحرية القبيلة الرحم الذي ستولد منه مركزية صارمة تخضع القبائل جميعها لسلطة القبيلة الأقوى، دون أن يلغي ذلك البنى الداخلية للمجتمع الأهلي: الانتماء السياسي للفرد والصراع الدائم بين العصبيات القبلية القوية للاستيلاء على السلطة المركزية الواحدة. لكن، كل هذا التطور الانتقالي يستمد أصوله الإيديولوجية والمؤسسية من الإسلام، وتحديدا بعد الفتح العربي لشمال أفريقيا.
النموذج الذي جرى إقراره في الجزيرة العربية سوف يتكرر في المغرب العربي. الإسلام، الذي استطاع أن يحتوي التناقضات القبلية ويلغي التقسيم السياسي ويحرر العرب من هيمنة الفرس والبيزنطيين والأحباش، كان نواة الوحدة لسياسية للقبائل العربية وأساس قيام الدولة العربية المركزية الواحدة. إن استمرار الصراعات القبلية حول السلطة السياسية والغلبة لم يأخذ أبدا منحى استقلاليا للعودة إلى قوانين السياسة ما قبل الإسلامية. أصبح اتجاه الوحدة المركزية والمركزة فوق الرغبات الذاتية، والتطور التاريخي للمشروع الإسلامي كان أقوى بكثير من رغبة سيد قبيلة وعشقه لحرية البداوة التي كان استئصالها، رغم صمودها البطولي، شرطا من شروط تكوّن السلطة الواحدة (الخلافة).
لم يخرج المغرب العربي عن هذه القاعدة. الفتح العربي-الإسلامي الذي كان في بداية الأمر احتلالا لبلاد البربر أصبح فيما بعد وجودا سياسيا يوحّد تناقضاته الإسلام وضرورات الدفاع عن الذات ضد مشاريع الإمبراطوريات المحيطة الدائمة الاستنفار في الجانب الآخر للبحر الأبيض المتوسط. ومنذ بداية القرن التاسع وحتى دخول العثمانيين على شواطئ ليبيا والجزائر كانت القبائل العربية والبربرية تتصارع في شمال أفريقيا في معركة دائمة من أجل السلطة الواحدة. القبيلة لم تعرف حدودا لسيطرتها، ولا تدّعي نهاية لمشروع غلبتها.
الحدود التي تفصل حاليا بين دول المغرب العربي لم تكن، ولا في يوم من الأيام، إشكالية جغرافية أو سياسية تحول دون امتداد سلطة مراكش أو فاس أو تلمسان الخ… والهويّات الثقافية والاجتماعية، الموحّدة إيديولوجيا، لم تتربع في أحضان بُنى «وطنية»، كما أن هذه الأخيرة لم تتعرف على نفسها إلا مؤخرا. وعندما حاولت أن تبحث عن تاريخ تشكّلها الوطني اللاحق، وجدت انقطاعا عن الأصل، فبدأ الوطن بالتاريخ المعاصر، أما الماضي، فإنه لشدة تعقيداته لا يمكن الركون إليه في تفسير ما آلت إليه الأمور بعد قدوم قافلة الغرب.
المهندس الاستعماري هو الذي خطّ الحدود في أجزاء إمبراطورية الموحّدين، والعنف الغربي، العسكري والحضاري، أدخل نظرية الوطن ليخلق الأوطان في مجتمع كانت وحدته الجغرافية والسياسية والإيديولوجية سلاحه الأقوى في مواجهة الغرب.
لسنا بصدد تاريخ لتلك المرحلة، إذ أن ذلك يستلزم عملا آخر هادفا. ما يهمنا هنا هو تقديم بعض الملاحظات المتعلقة بوضعية المغرب العربي منذ الفتح الإسلامي الموحّد إلى التدخل الأوربي المجزّئ.
أولا، إن شمال أفريقيا قبل الفتح العربي كان منطقة صراع دولي من أجل السيطرة على مداخل أفريقيا وعلى الممرات الداخلية لقوافل التجارة العالمية، برا وبحرا. المركزة السياسية كانت شرطا لأمن الحركة التجارية، وعليه، فإن جهود الإمبراطوريات، من فينيقيين على بيزنطيين، كانت تصب كلها في هذا الاتجاه.
ثانيا، الفتح العربي لم يكن شذوذا عن القاعدة. فهو محاولة مركزة من الخارج أصبحت مع الإسلام وحركة التعريب مركزة قوامها وحدة وصمود الداخل ضد تهديدات الخارج «المسيحي»، وفي هذا سر بقاء العرب في شمال افريقيا وخروج «الدخلاء» الآخرين بتعدد هوياتهم.
ثالثا، الحالة الأولى واستمرار الحالة الثانية كانتا تعاملا موحِّدا للشمال الأفريقي. فلم يكن ينظر إليه كوحدات جغرافية مستقلة، ولم يكن الانتماء السياسي انقساميا إلا على مستوى القبيلة. الأرض واحدة، حدود التملك فيها تحددها قدرات القبيلة على الثبات ومجال ترحالها الدائم الحركة في مساحات تمتد من الأطلسي إلى ليبيا عابرة الصحراء وجبال الأطلس أن تصادف شريطا للحدود.
رابعا، إن البنية القبيلة لمجتمع شمال افريقيا سلاح ذو حدين. فهي قد تكون عاملا مساعدا على تبرير واقع التجزئة، وتكون أيضا عاملا مؤسسا لواقع الوحدة والمركزية. الإشكالية يمكن تحليلها من خلال عملية رصد تاريخية لتصادم البنى المحلية والدخيلة. تصادم الذات والآخر الذي كان يستتبع، وفق ميزان القوى، إخضاع الثاني للأول ونمو وعي الأول لذاته. هذا التصادم سوف يساعد التأريخ الاستعماري على أدلجة التجزئة من خلال التطوع باختراع تفريقات وتمايزات حادة ليس بين الذات والآخر وإنما بين قوى الذات نفسها بحيث تكون مهمة «الآخر» ضبط نتائج تناقضات البنية الداخلية لمصلحة الجميع.
إن صمود البنية القبيلة والإعادة الدائمة لإنتاج نفس العلاقات الاجتماعو-سياسية كانت تتم دائما على قاعدة مواجهة الذات للآخر، ووعيها لمصالحها. والانتقال من مستقر جغرافي-مكاني لقبيلة ما، أو إعادة تكرار نمط إنتاج سابق لغزو أجنبي ما، كانت يترافق بحقيقتين تاريخيتين لا يطالهما شك: إعادة إنتاج العلاقات نفسها تجاريا وحربيا، واللجوء إلى القبيلة بوصفه «عودة إلى الذات» في وضع تاريخي محدد، وكالنتيجة والتعبير عن تاريخ محاصر، تعبير متحول إلى مؤسسة، «والذي سيؤدي كرد على جميع المحاصرات اللاحقة. لسنا ندري من أين انطلق التاريخ المغربي، ولكننا نعلم إلى أين لم يستطع الوصول وهذه المسيرة المتوقفة لها اسم هو القبيلة»(2).
والأدلجة الاستعمارية لإستراتيجية التجزئة في المغرب العربي أصبحت الخبر اليومي لعباقرة القوميات المحلية شرعيين ومعارضين، تقدميين ورجعيين، الذين باتوا عاجزين عن رؤية التاريخ بدون نظارات الغرب. الذين أصبحوا لا يعرفون ذاتهم إلا بواسطة الآخر، دون أن يلغي ذلك جهدهم التبريري لإثبات العكس. هذه الألجة قامت وتقوم على تفريقات قاطعة بين العنصر المحلي والعنصر الدخيل لا تلبث أن تتحول إلى تفريقات تطال أسس المجتمع برمته: تفريقا جغرافيا (مدن، أرياف صحراء)، اقتصاديا (تجارة، زراعة، تربية ماشية في البادية)، لغويا (لاتينية، بربرية، عربية)، عريقا (بربر، عرب) وسياسيا (تعددية السلطات القبلية واستقلاليتها عن بعضها البعض). كان سقف هذه الأدلجة منح هذه التفريقات حدودا كخطوة تمهيدية لتحويل القبائل المقيمة داخل الحدود تلك إلى شعوب وبالتالي تشريع تحويل التاريخ المحلي إلى تواريخ.
نحن لا نحاول إلغاء التمايزات داخل الوحدة وإنما الوحدة تطويق التحويل القسري لهذه التمايزات إلى وحدات. النظام القبيل لم يكن مطلقا نظاما صافيا، واضحا ومتجانسا، ولكنه أيضا لم يكن انعكاسا لتعددية أوطان تحكمها قبائل. الوطن كان واحدا، بين جدرانه تتنافس قبائل هدف أقواها وأضخمها الاستبسال في الدفاع عن واحديته.
خامسا، كان ابن خلدون محقا عندما اكتشف القانون الذي ينقل التناقضات القبلية إلى مستوى سياسي، وكان بذلك المؤرخ الذي أكّد إمكانية استمرار التناقضات داخل الوحدة، وحتمية الانتقال في أشكال العمران من البداوة إلى الحضارة، من اللامركزية السياسية إلى السلطة المركزية الواحدة القائمة على غلبة قبلية. الإسلام والفتح العربي كانا حجر الأساس لمرحلة هذا الانتقال.
يقول ابن خلدون: «إن القبيل….لكل واحدة منها التغلب على حوزتها وقومها… وان غلبتها واستتبعتها، التحمت بها أيضا، وزادتها قوة في التغلب إلى قوتها، وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد، وهكذا دائما حتى تكافئ بقوتها قوة الدولة: فإن أدركت الدولة في هرمها، ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة أهل العصبيات، استولت عليها وانتزعت الأمر من يدها، وصار الملك أجمع لها.»(3).
«إن أنصار السلالة الحاكمة، الشعب الذي أقامها والذي يساندها، عليهم أن يتوزعوا فرقا في مختلف الممالك والقلاع التي استولوا عليها. يجب احتلال البلد لأجل التمكن من حمايته ضد العدو، فرض احترام سلطة الحكومة المركزية. ولهذه الفرق من خلال صلاحيتهم، مهمة جباية الضرائب واحتواء المغلوبين… خلال عدد كبير من القبائل، ثمة واحدة أكثر قوة من الأخريات مجتمعة، فتسيطر عليها من اجل توحيدها واحتواء…»(4).
«وصار الملك أجمع لها…. احتلال البلد لأجل التمكن من حمايته ضد العدو، وفرض احترام سلطة الحكومة المركزية… فتسيطر عليها من أجل توحيدها واحتوائها…» السلطة الواحدة، الحماية ضد العدو وتوحيد القبائل عبارات تعني ببساطة أن المغرب العربي منذ الفتح الإسلامي كان واحدا، لا أوطان ولا شعوب، ولحظات انفجار تناقضاته كانت محاولة إعادة فرض وحدته ومركزيته السياسية بشروط أخرى.
كيف يمكن لتاريخ المغرب العربي أن يثبت هذه الحقيقة؟ وكيف لم تؤد نزاعات القبائل وتغيرات السلطة المستمرة إلى قيام «الوطنية» التي يتحدث عهنها «الغربيون» الجدد؟
سنوجز في الرد الذي سيكون تأريخا، عملية مراجعة سريعة لتحولات السلطة في المغرب العربي هدفها الأساسي إبراز عدم الثبات الجغرافي لقوى السلطة باعتبار أن المساحة المطلوبة للغلبة تشمل كل المغرب العربي ولا تخفي حلما للعبور نحو المشرق من بوابة مصر.
الفتح العربي لشمال افريقيا وتدفق القبائل العربية إلى تلك المنطقة ظل يترافق مع مواجهات مستمرة بين قوى المجتمع الجدد. معركة الانتشار الإسلامي التي بدت وكأنها حسما نهائيا مع مطلع العام 700 كانت في الحقيقة مدخلا لصراعات جديدة سوف تؤدي لاحقا إلى قيام سلطات محلية مستقلة عن الخليفة العباسي.
مجموعة عوامل تضافرت لتدفع الأحداث إلى هذه الوجهة. إن بُعد المغرب العربي النسبي عن مركز الخلافة جعل حمايته بواسطة جيوش المركز مهمة مكلفة وصعبة. وبالتالي فان اتجاه السلطة سيصبح ملزما بالاعتماد على قوى تلك المنطقة نفسها في حماية الدولة الإسلامية في المشرق وما وراء البحر الأبيض المتوسط، بحيث تصبح هذه المنطقة العمق والقلاع التي تقف في وجه الغزوات الخارجية القادمة من الغرب (أوروبا) وتصبح منطقة المشرق حصنا في وجه الغزوات القادمة من الشرق (آسيا). اقتسام مهمة الدفاع عن وحدة المشروع الإسلامي خلق نتائج متوافقة في العمق متناقضة في الظاهر. التوافق كان يعني أن وضع المنطقتين قد التحم استراتيجيا، فهزيمة المشرق على يد الصليبيين مثلا كانت تستتبع تهديدا مباشرا للمغرب، كما أن اندحار المغرب تحت وطأة الهجمات الأوروبية القادمة من وراء الأندلس سوف يضع تلقائيا مصر والمشرق تحت نيران مدافع الكاثوليك.
هذا المصير المشترك كان يحث قوى المشرق للتحرك نحو المغرب في كل لحظة كان فيها هذا الأخير يتعرض للخطر، والعكس بالعكس. وضعية كهذه كانت تعزز اتجاه الوحدة بين المشرق والمغرب وتضع مجتمعات الدولة الإسلامية أمام امتحان عسير الدفاع عن الذات وتصليب تماسكها، وخاصة وأن الطرفين كانا يعتبران أن الخطر الخارجي يشكل تهديدا مصيريا لا يمكن مقارنته بأعظم التهديدات التي تنتجها التناقضات الداخلية للمجتمع العربي-الإسلامي في بدايات تشكّله.
ظاهريا، كانت التناقضات الدائرة من ناحية بين المغرب والمشرق كمنطقتي جذب محورية، وبين قوى المجتمع الغربي من ناحية ثانية، تأخذ منحى تكتيكيا أكثر منه استراتيجيا، بمعنى آخر، أن تناقضات النوع الأول كانت قد أصبحت تناقضات داخل مجتمع واحد، وهذا ما يفسرّه الوجود الدائم للإسلام كإيديولوجية التناقض التي لا تنزعها أية إيديولوجية أخرى، وتثبته النتائج السياسية التي لم تأخذ صيغة نسف للوحدة القائمة. بمعنى أن استقلال منطقة عن أخرى كان مرحليا وتكتيكيا في صلب إستراتيجية هدفها إخضاع منطقة لسلطة منطقة أخرى. أما تناقضات النوع الثاني، والتي لم تكن كلها بين قوى مغربية صافية، فإنها كانت نموذجا مصغرا ومحليا للنوع الأول. الصراع الدائم حول السلطة في المغربي العربي بين قبائل مشرقية ومغربية تارة وبين قبائل مغربية تارة أخرى كان يدخل في مشروع توحيدي دائم التوتر وعدم الاستقرار ولكنه ثابت. القبيلة الأقوى تملك هدف إخضاع القبائل الأخرى والسيطرة على السلطة الواحدة. بديهي أن تناقضات كهذه تسمح بتفسير صعوبة استقرار وحدة المغرب العربي، ولكن نتائجها وحركية انتقالها التاريخية وتناقضات صيغها السياسية لا تسمح بتاتا بتحويل مناطق النفوذ المؤقتة إلى حدود ثابتة كمقدمة لتشكل وطن-قبلي-إسلامي في شرق المغرب أو غربه.
ما يزيد في تدعيم هذا الاتجاه، أن الحركات المناوئة للخلافة العباسية لم تكن دائما بقيادة مغربية أصلية، بل أن القوى والفرق السياسية-الإسلامية، التي كان المغرب قاعدة لها ومنطلقها، كانت تضم مشارقة ومغاربة، عربا وبربا، يجمعهم هدف إسقاط السلطة واستبدالها. هذا التشابك، رغم تعقيدات مراحله ونتائجه، كان يربط أكثر فأكثر المشرق العربي بالمغرب العربي مصيريا، كما كان يدفع بقوة المجتمع المغربي نحو التماسك، والأسباب طبعا إستراتيجية، اقتصاديا وسياسيا وفكريا.
إن وعي الذات القومية كان يتبرعم في خضم هذه التناقضات، ويزيد في تصليبه أن هذه الذات كانت مستقرة لقرون طويلة في مواجهة الآخر، «الغرب». كان الخطر الخارجي يدفع بإلحاح نحو تماسك داخلي فكري وسياسي ويرغم الذات على تطوير وعيها لذاتها، حاضرا ومستقبلا. ومنذ تلك اللحظة، ووسط مجتمع تشوبه تناقضات حادة، كانت «الذات» تتوضح وتتفانى في صراع مصيري مع الغرب، في نفس الوقت ستسمح فيه لهذا الغرب بالانتصار عليها وتفتيت قواها.
طيلة القرن الثامن الميلادي كان شمال افريقيا جزءا من الخلافة الأموية التي كان مركزها دمشق. كونه كذلك فإنه قد ارتبط بالمشروع العربي-الإسلامي بشكل يدخله في صلب تناقضات هذا المشروع، دون إهمال التطورات الداخلية للمجتمع المغربي نفسه. أي أن وحدة عربية قد تأسست بين المشرق والمغرب دون إلغاء نهائي لتناقضات كل منهما التاريخية أو المستجدّة. القرن الثامن كان انعكاس تطورات الوضع في المشرق على بنية المغرب العربي السياسية والإسلامية. الجيوش العربية القادمة من منطقة الخلافة حملت معها إلى المغرب إيديولوجيات تبرير صراع العصبيات القرشية حول الخلافة أو صراع العصبية القرشية مع غيرها (الخوارج). (5)
قرن الانتفاضات المحلية (القرن الثامن الميلادي، من 81 إلى 84 هجري) انتهى بصياغة بداية استقلال سياسي متفاوت المراحل بين المجتمع المغربي وقواه السياسية من ناحية ومركز الخلافة العباسية من ناحية ثانية، وخاصة منذ وفاة يزيد بن حاتم حاكم القيروان (170 ه- 787 م).
صراع العصبيات القرشية على السلطة (هاشميون، أمويون، زبيريون) طال المجتمع المغربي وجعله أرضا خصبة لقوى الصراع وخاصة الخوارج وذلك طيلة القرن الثامن وأواخر القرن السابع. بعد سقوط الخلافة الأموية على يد العباسيين عام 750 م، كانت التأثيرات المتبادلة تتجه وجهة أخرى. فمنذ اللحظة التي بدأت فيها العصبيات الهاشمية (عباسيون وعلويون) تتفاقم، كان واضحا أن كليهما يبحث عن منطقة نفوذ كحصن وكمجال لانتشار الدعوة. أدت هزيمة الانتفاضة العلوية، التي قادها شيعة علي بن أبي طالب في المدينة عام 785 م (168 هـ) إلى ضرورة البحث عن ملجأ آخر للمعارضة العلوية. فكانت رحلة إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فرارا من المدينة إلى مصر ومنها إلى المغرب حيث أسّس بداية السلالة العلوية الادريسية في مدينة سبتة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، في عام 860 م. كانت سلطة الأدارسة قد بلغت أوج عظمتها وحولت مدينة فاس إلى مركز سلطة وثقافة، وامتد نفوذها ليشمل معظم المغرب وذلك حتى لحظة انهيارها عام 985 ميلادية. الأدارسة القادمون من المشرق قادوا المغرب منذ ولاية إدريس الأول عام 788 إلى ولاية الحسن عام 922 م في اتجاه معارض للسلطة العباسية، معارضة تهدف إلى استلام السلطة وإزاحة العباسيين لا يغير من طبيعتها حالتا الانكفاء والفشل اللاحقتان.
تأثير المد الشيعي والإدريسي لم تقف عند حدود فاس بل تعدتها إلى تونس التي بدأت تحذو حذوها في الخروج عن السلطة العباسية.
فالخلافات التي أعقبت وفاة يزيد بن حاتم ألزمت هارون الشريد بإرسال إبراهيم بن الأغلب، الذي كان حاكما لمدينة «الزاب»، إلى تونس ليتسلم السلطة فيها ويخفف من نفوذ الأدارسة.
استقلال بني الأغلب عن الخلافة العباسية، في المرحلة الأولى من حكمهم، وتعاطفهم مع الآراء الشيعية وأفكار الأدارسة أوجد حالة من الوفاق أسفرت عن تقوية إمارتهم، تقوية بدأت تعطي ثمارها في الامتداد والتوسع على طول المناطق الساحلية الافريقية والبحر الأبيض المتوسط. أدت هذه التطورات الداخلية إلى شن هجمات متتالية على سواحل ايطاليا وفرنسا وجزر قرصرة وسردينية والتي انتهت بالاستيلاء على جزيرة صقلية وذلك على مدار أكثر من نصف قرت (212-262 هـ، 727-787 م).
الأغالبة، أحفاد إبراهيم الأول، أعادوا ارتباطهم بالخليفة العباسي وظلوا يتعاطون العملة المركزية الصادرة من بغداد، مما حول الآراء الشيعية والادريسية إلى قنوات تمرد أدت إلى إضعاف بنية السلطة المحلية ومهدت لانتصار الفاطميين المعرضين للعباسيين والذين أنهوا سلطتي الأدارسة وبني الأغلب، الذين انهزم آخرهم زياد الله الثالث عام 909 م.
كان مشروع الأدارسة تأسيسا لوحدة مغربية سوف يعمل الفاطميون على توسيعها نحو المشرق معززين بذلك باتجاه الوحدة بين المغرب والمشرق.
دون أن التدخل في كيفية وصول إدريس الأول إلى أوليلي Oulili عام 788 م بعد دعوة وتبشير استمرا أكثر من عشرة أعوام، فإن تاريخ هذه الأسرة يشهد ميلاد هذا النوع. الإمام الإدرسي الأول كان يعمل على تأسيس مركز جديد لسلطة معارضة للعباسيين في نفس الوقت الذي كان ينشر فيه الدعوة الإسلامية. صيغة هذا المشروع دخلت حيز التنفيذ مع إدريس الثاني الذي يعتبر أساس نجاح المشروع التوحيدي. وإدريس الثاني كان من أب عربي وأم بربرية، الأمر الذي ذلل عقبات كثيرة أمام خطواته السياسية.
بدأت معالم هذا الاتجاه تتوضح منذ بداية القرن التاسع حيث تأسست مدينة فاس (عام 808 م) وضربت العملة الادريسية. كما بدأت سياسة تعاطف وتأييد عبرت عنها موجة الهجرة العربية باتجاه فاس قادمة من قرطبة عام 814 م ومن بعدها القيروان اثر عودة الأغالبة إلى الولاء العباسي. هجرات تحمل في طياتها فروقات مذهبية ذات تأثيرات حاسمة تجمع بشكل أساسي كل المعارضين للأمويين والعباسيين على حد سواء.
بديهي أن تدفع هذه التحولات بالأدارسة إلى بدء سياسة الامتداد الجغرافي والسياسي، خاصة نحو السيطرة على مفترقات الطرق الساحلة شرقا وجنوبا والتي بواسطتها يمكن تحقيق هدفي توسيع المشروع الإدريسي وتطويق محاولات الهجوم المضاد. وفق هذا السياق نفهم الأهمية الإستراتيجية للسيطرة على مدينة تلمسان وشيلا ثم نفيس –هذه المدن تربط منطقة النفوذ بطرق المواصلات التجارية المتجهة من الشرق إلى الشمال مرورا بالسهول الأطلسية، وصولا إلى بلاد السوس والجنوب المراكشي مع مشاريع العبور نحو الأندلس، اثر سقوط الخلافة في قرطبة. (6)
سياسة التوحيد الفاطمي التي بدأت مع مطلع القرن العاشر تمت على قاعدة تناقضات مذهبية وصلت إلى ذروتها في امتداد الفرق الشيعية وتشعّب اتجاهاتها وتغلغل دعاتها في أطراف الخلافة العباسية وخاصة في اليمن والمغرب وإيران. ترافق كل ذلك مع ولادة الإسماعيلية كفرقة شيعية سرية تعتمد تراتبا تنظيميا سوف يساعدها فيما بعد على التحول إلى قيادة سياسية فاعلة (المرشد والدعاة).
محاربة المركز في نقاط ضعفه: الأطراف. إستراتيجية تطويق المركز التي أجاد إتقانها الاسماعليون لحظة توجههم إلى شمال افريقيا حيث كان معقل الخليفة العباسي، بلاد بني الأغلب، يلحظ حركة قلق وانحدار. فشل أول أعقبه هجوم ناجح انتهى بسقوط مدينة سطيف عام 904 م تلتها مدينة طينة عام 905 م.
انتهت المرحلة الأولى بسحق جيوش زياد الله الثالث الأغلبي على يد أبو عبد الله الشيعي (وهو الاسم المستعار للداعي الاسماعيلي الذي كان يؤسس ويمهّد الطريق لسيده عبيد الله المهدي).
بعد هزيمة الحركة القرمطية سارع المهدي الذي يعود نسبه إلى الإمام علي مغادرا السلمية في سوريا متوجها إلى المغرب عام 902 م فوصل إلى سجلماسا حيث أسرها أميرها المدراري. مهمة تحريره من الأسر دفعت الداعي أبو عبد الله إلى التوجه نحو الغرب والجنوب فاحتل تاهرت وسجلماسا وأطلق سراح سيده الذي ما لبث أن أعلن نفسه أميرا للمؤمنين وباشر بتحويل الانتصار إلى دولة بنى إدارية وعسكرية سوف تعمل الضرائب على تقويتها ويعمل التنظيم السري على انتشار نفوذها في طول الإمبراطورية الإسلامية وعرضها، فسياسته كانت إذن كلها مرسومة. وبقيت إيديولوجيته على تشددها كما كانت قبل انتصاراته العسكرية: فسُمي قاضيا شيعيا وغير عبارات الآذان والألوان الرسمية… وإلى هذا الإطار يجب إرجاع حادث أبو عبد الله إلى مكانه. لقد طرحت المشكلة نفسها في الفترة التي كانت الإمبراطورية العباسية تتكون من (تعارض المنصور وأبو مسلم). إنه يعبر دائما على التناقضات بين الضرورات الإيديولوجية لدى طائفة والضرورات الأكثر تسامحا لدى الدولة. «إلا أننا لا ندرك دائما في هذه الأزمات من يكون الإيديولوجي المتشدد ومن هو السياسي المعتدل. وعلى أية حال فقد اعدم أبو عبد الله وأخوه العباس في تموز 911 م، وسجل عبيد الله بسرعة فائقة إرادته في إخضاع الإمبراطورية بأكملها، فهدفه هو أن يكوّن لنفسه جيشا قويا وخزينة حرب ويستأنف بأسرع ما يمكن طريقه إلى الشرق. وكمركز لهذه السياسة، أقيمت عاصمة بحرية (المهدية) بين سوس وصفاقس. وفي عام 921 م انتهت الأعمال التي بدأت عام 912 م.» (7).
إستراتيجية كهذه كانت تتطلب مركزا مستقرا لقيادة المشروع الفاطمي وإيصاله إلى الشرق العربي. لتحقيق ذلك كانت القيادة الفاطمية ملزمة بخوض مواجهات مع مناطق النفوذ المغربية والسيطرة على الطرق التجارية، حروب وتحالفات بدونها لم يكن لذلك المشروع، تحقيق أهدافه.
إعلان عبيد الله نفسه خليفة عام 910 م واحتلال تاهرت وسجلماسا كان يدفع الاتجاه العام نحو المركزة (خاصة وأن هاتين المدينتين تشكلان سوقين كبيرين في تقاطع طرق يسيطر على محاور التجارة الصحراوية والشرقية).
إن الإسراع بتعميم استنتاجات للمشروع الفاطمي تحت وطأة العاطفة القومية سوف ينتج بدون شك مغالطات تستتبع بدورها حالة ارتباك منهجية. إن قراءة دقيقة لتاريخ الفاطميين تستلزم مراجعة للبنى الداخلية الاقتصادية والاجتماعية التي وسط تناقضاتها وتعقيداتها، كان الامتداد الفاطمي يستمد حيثيات استيعابه: صراع مثلث الأطراف بين ثلاثة مراكز سلطوية: العباسيون في بغداد، الفاطميون في المغرب والأمويون في الأندلس. تناقض قبلي تاريخي دخلت حساباته في ثنايا التوحيد الفاطمي (صنهاجة وزناتة). يضاف إلى كل ذلك محورية الحروب المتعددة الانتماء والأسباب حول طرق ومدن التجارة التي كانت السيطرة عليها شرطا أساسيا لنجاح المشروع الفاطمي. وفق هذا السياق نفهم لماذا دارت الحروب الفاطمية ضد الأدارسة وحلفائهم والسلطة العباسية ورموزها الأغالبة والأمويين المسيطرين على مناطق الذهب الصحراوي المتحول إلى نقود بعد عبوره سجلماسا إلى فاس وأغمات، ولماذا كانت المعاركة طاحنة حول تازا، مكناس، سجلماسا، تلمسان، فاس وتاهرت. بل أكثر من ذلك، لعبت الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط والأهمية الحيوية للتجارة دورا حاسما في تطور سلطة الفاطميين وشمولها لعموم المغرب العربي دور سوف يكون في أساس تزعزع هذا المشروع التوحيدي والذي سوف يركز تناقضا ذا استمرارية بين سادة المدن وسادة الطرق التجارية.
الدولة الفاطمية، التي كانت في نهاية القرن العاشر قد وحدت تحت سلطتها جميع المناطق الساحلية لشمال أفريقيا ووصلت مصر بالمحيط الأطلسي، وضمت جزيرتي صقلية وسردينية، بدأت تعيش لحظة انهيارها ساعة قرر المعز لدين الله الفاطمي نقل عاصمة سلطته إلى القاهرة: على أنقاض دولة الوحدة سوف تنشأ إمارات ثلاثية الحكم حال قِصر عُمْر المشروع الفاطمي دون استئصال جذورها الدفينة. إمرات سرعان ما تنهار تحت ضربات المرابطين والموحدين: إمارة بني زيري، التي أسسها في صنهاجة عامل الدولة الفاطمية يوسف بلكين بن زيري عام 972 م واستمرت إلى عهد الحسن بن علي (1121- 1148م) الذي سقط تحت وطأة الهجمات المتكررة لجيوش رجار ملك صقلية والتي أعيد توحديها على يد الأمراء الموحدين.
إمارة بني حمّاد، التي تأسست في بجاية، إحدى مدن الجزائر، كمحاولة لتطويق نفوذ بني زيري، كانت نقطة وصل بين تونس الزيرية ونشأة مراكش (المركز الأقصى). هذه الإمارة التي تأسست على يد حماد عام 1007 انقرضت مع مجيء الموحدين الذين انهوا حكم يحي بن العزيز عام 1152 م. (8)
أما المغرب الأقصى (مراكش) فإنه يجعل من الصعب الحديث عن إمارة شبيهة بإمارات بجاية وتونس وإن كانت خارج نفوذ هاتين الإمارتين. سقوط الأدارسة استتبع بعد انهيار الوجود الفاطمي محاولات استقلال سياسي قامت بها قبائل البرابرة والمكناسة والمغراوة دون أن تؤدي هذه المحولات إلى استقرار يذكر. مجيء المرابطين أنهى هذه الوضعية كما أنهى معها إمارة بجاية في الجزائر.
ثلاثة عوامل كانت في أساس تشكل دولة المرابطين: العمل الإيديولوجي-الديني الذي أدى بانتشاره في شمال افريقيا إلى إفقاد التلاحم القبلي لبعض ركائزه.
العامل الاقتصادي-التجاري، الذي كان يتمركز في المدن-الدول، عاد ليعطي لحركة التجارة أهمية سياسية. إن التجارة المنظمة لمسافات بعيدة جدا والتي تعبر قوافلها نقاط اتصال إستراتيجية بعيدة عن مراكز السلطة (المخزن)، يضاف إلى ذلك انتشار العملة على حساب التبادل البضاعي، أسفرت عن ضرورة قيام دولة قوية قادرة على حماية وتنظيم حركة التجارة، وبالتالي فالقوة (القبلية) القادرة على الاضطلاع بهذا الدور تملك وحدها مفاتيح السلطة السياسية (9).
العامل السياسي كان انعكاسا لضعف داخلي وتهديدات من الخارج. في أواخر القرن الرابع الهجري كانت شمال افريقيا تلحظ انهيار الدولتين الأموية والزيرية اللتين أصبحتا إمارات بدون قوة. كما كان الشرق العربي-الإسلامي، والبيزنطي أيضا، قد بدأ مرحلة تراجع وانحطاط في مقابل نهوض الغرب الأوربي.
إلى جانب هذه العوامل كان التحضير لغزو شما افريقيا وهجمات سكان جنوى وبيزا للاستيلاء على جزيرتي قرصرة وسردينية، وتعاظم قوة الايطاليين في الجنوب المطل على الأبيض المتوسط، كل ذلك كان يمهّد لمواجهة إسلامية-مسيحية سوف يكون تاريخ المرابطين محاولة تجاوزها بانتصار.
وصول الفتح العربي إلى مداخل الصحراء وإعادة بناء مدينة سجلماسا الإستراتيجية أعاد التعامل بين الداخل والصحراء وأعطى لهذه الأخيرة أهمية تقريرية في مصير الاقتصاد المتطور الذي بدأ يحدث تأثيرات بنيوية في حياة القبائل البدوية (الصنهاجيين خاصة) الذين بدأوا ينتقلون من حياة الترحال إلى حياة الثبات قوامها الوحدة بين القبائل وتأسيس قوة قادرة على الإلمام بشروط التجارة.
من وسط هذه التطورات ومن الصحراء تحديدا سوف يبدأ نجم المرابطين بالظهور ناقلا المغرب المراكشي والجزائري واسبانيا إلى العصر الإمبراطوري.
في الصحراء بدأت تتأسس قاعدة الانطلاق للمشروع المرابطي: تقوية اتحاد قبائل لمتونة بعد إعادة بنائه، الهجوم على التجمعات السكانية المسيطرة على طرق التجارة الصحراوية في الشمال والجنوب، احتلال سجلماسا عام 1503 م ثم العودة إلى الجنوب واحتلال أوداغوست بعد هزيمة سود غانا الذين كانوا قد سيطروا عليها منذ عام 1040 م. وبهذه الخطوات يكون المرابطون قد سيطروا على التجارة الصحراوية وطرقها الأكثر أهمية.
أعقب هذه الانتصارات مرحلة التوسع نحو الشمال حيث استطاع أبو بكر بن عمر، بمساعدة ابن أخيه بن تاشفين، احتلال تارودانت وماسا ونفيس واغمانت وتادلا على التوالي. وبهدف مواصلة السيطرة على الطرق التجارية، واصل الجيش المرابطي زحفه لمحاذاة أطراف الأطلس وصولا إلى سفرد وفاس.
بعد أن بنى يوسف بن تشفين مدينة مراكش، الواقعة على ملتقى طرق المواصلات، جعلها عاصمته وبدأ منها عملية تنظيم وتوسيع دولته: تحويل مراكش إلى مركز نقدي (سوق للذهب ومركز وحيد لإصدار العملة) وذلك على حساب موقع سجلماسا، إعادة بناء الجيش وتقويته بفرق لرماة السهام وذلك ضمن مخطط التحضير لحملات الفتح في الشرق والشمال.
سبق الفقهاء الجنود في عملية تحضير إديولوجي لمشروع سياسي-مذهبي سوف يصطدم بإرث الوجود الشيعي والخوارجي بشكل خاص. ففي عام 1068 بدأ الهجوم على البارغواتا، أعقبه سقوط فاس عام 1069 م. وبين أعوام (1070-1080) بدأت المدن تسقط الواحدة تلو الأخرى تحت قبضة المرابطين ابتداء بتازا، بوابة الشرق، وغرسيف ووجدة وتلمسان ووهران وصولا إلى الجزائر المدينة. ولم يوقف تقدم المرابطين إلا تدهور الوضع في الأندلس وبداية التحضير لهجوم «مسيحي» باتجاه الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
قبل أن يبلغ القرن الحادي عشر نهايته كان غرب المغرب العربي لأول مرة، من الصحراء إلى البحر الأبيض المتوسط، قد تحول إلى سلطة سياسية واحدة.
يمكن القول أن هذه السلطة كانت قد تحولت إلى إمبراطورية تحتوي ثلاث مناطق منفصلة عن بعضها ومرتبطة بالسلطة السياسية في مراكش، عاصمة الإمبراطورية.
كان هناك منطقة الصحراء التي تبدأ جنوب مراكش من وادي درعا إلى حدود السنغال والتي كانت تتمتع باستقلال سياسي ذاتي بقيادة تحالف قبائل لمتونة –وهو أساس الدولة المرابطية- ومنطقة المغرب الغربي أو الأقصى والتي تضم الجهات الجنوبية والشرقية الشمالية، وأخيرا منطقة الأندلس التي يفصلها عن باقي الدولة البحر الأبيض المتوسط.
الحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عن الأندلس من خطر الأوربيين المسيحيين كان الشغل الشاغل للمرابطين منذ مطلع القرن الثاني عشر. مهمة صعبة ومكلفة، سوف تنهك قوى المرابطين وتمهّد لانهيار دولتهم.
إمبراطورية المرابطين التي أسسها أبو بكر بن عمر بن وركوت عام 1056 م ودعم ركائزها ووسع حدودها يوسف بن تاشفين 1087 م انهارت عام 1147 م في عهد إسحاق بن علي حفيد يوسف، فاتحة الطريق لوحدة أخرى قادمة من الغرب: الموحدون.
ما هي عوامل الانهيار المرابطي؟ هل سبب ذلك «استرخاء أولئك المحاربين الصحراويين في ظل بساتين قرطبة الوارفة» أم تراجع حركة التجارة الصحراوية؟
دون أن نلغي أحد هذين العاملين نوافق على إخضاع مجمل العوامل لغلبة الإيديولوجية الإسلامية التي كانت تحتوي كافة العوامل وتوجهها وتوحّدها في مواجهة إيديولوجية أخرى بدأت أطماعها تطل من اسبانيا الكاثوليكية. أو كما يحلل عبد الله العروي حركة الانهيار قائلا: «نرى جيدا أن المسألة الإيديولوجية كانت قد غذت أساسية لأنها التعبير المركز عن جميع المشاكل الأخرى: مشكلة حرب لا نهاية لها في اسبانيا، مشكلة دولة ياهضة التكاليف (يقتضيها سكان المدن)، وأخيرا مشكلة تثبيت طائفة سياسية كانت تتكون انطلاقا من المدن-الدول ومن التجمعات المحلية، وإذا لم تكن هذه الطائفة مدعمة يوميا بإيديولوجية معدّة فإن القوى المحلية توشك أن تضعف فعاليتها.» (10).
وسط بينة معقدة من المذاهب السلامية كانت تنمو عملية تكوين إيديولوجي سوف يتجه بقوة وجهة سياسية، بحيث يمكن القول بأن الاتجاه الروحي-الديني كانت محاولة تحصين وتمهيد لمشروع سياسي تتحدد نتائجه بشموله الديني نفسه.
ما نقصده بذلك هو البداية الإيديولوجية لإمبراطورية الموحدين التي أقامت الدولة الواحدة في كل افريقيا الشمالية (المغرب العربي).
بديهي أن يساهم الانتماء الإيديولوجي في تبيان الخصائص السياسية للمشروع التوحيدي الجديد. وبسبب غموض المسألة وتعددية الاتجاهات المذهبية، فإن اتخاذ موقف فكري من الاتجاه التوحيدي الذي بدأه ابن تومرت يكاد يكون صعبا قبل تحول المشروع السياسي إلى حقيقة.
في بنية تتجاوز فيها الباطنية الشيعية، بنفوذها القوي في المغرب، والمذهب المالكي، الذي حاز على شرعية سياسية في عصر المرابطين، متوافقة مع نتاج المحاولات اللاهوتية الفقهية، التي نسقها الباقلاني المتوفي عام 1013 م، والأحاديث والدراسات الفقهية، التي نشرها ابن حزم المتوفي عام 1111 م، في مثل هذه البنية، يكون المخاض الفكري لا شك عسيرا. وكان لزاما على ابن تومرت أن يخرج من بلاد السوس على السفح الشمالي لجبال الأطلس الداخلية متوجها إلى قرطبة ليحمل معه ارث ابن حزم ويواجه به ارث الغزالي، مناقشا محاورا.
بعد رحلة العراق وقرطبة كان أبو عبد الله بن تومرت الذي كان يحارب بشدة آراء المشبهين والمجسمين، قد أصبح واقفا بين المعتزلة والأشاعرة: معتزلي لأن اختيار الاسم «الموحّدون» يرجع إلى المعتزلة المعروفين «بأهل العدل والتوحيد»، واشعري لأنه واجه المشبهة والمجسمة بتمثل عقلاني لتعريف الله وصفاته مستخدما الاستدلال والقياس والتفسير المجازي للقرآن. ولكي تصبح الاديولوجية سياسية، والمبشر زعيما، كان على ابن تومرت البربري واجب البحث عن أصل عربي يربطه بقريش وبالهاشميين تحديا: أن يكون المهدي الجديد للدولة الجديدة (11).
عام 1121 أعلن بن تومرت نفسه إماما وبدأ يستعد لطرح موضوع السلطة السياسية.
وكانت عودته من المشرق عام 1116 عابرا الإسكندرية وتونس وبوجي وتلمسان وفاس ومكناس ليستقر مؤقتا في مراكش، تشير إلى محطات المشروع السياسي التوحيدي (طرق الساحل) التي تتعارض مع محطات الوسط التي اتبعها من قبله الفاطميون، والمرابطون.
طريق العودة كان طويلا، وكان ذلك مقصودا. إذ أنه خلال طول المسافة لم تكن الاديولوجية هي مجال التكون بل المشروع السياسي نفسه الذي كانت الرحلة انعكاسه الزمني. كما أن توقفتا المتعمد أمام المسار الإيديولوجي لنشأة الموحدين لم يكن محاولة الشروع بمناقشة فلسفية للانتماء التومرتي. حاولنا، تحديدا، وضع السياسة وسط مخاض فكري بالغ الأهمية، كما حاولنا أن نقول أن الانطلاق من بلاد السوس إلى قرطبة والعراق لم يكن مجرد رحلة مؤمن بربري يبحث عن الله، بل كان، وبدقة متناهية، بحثا عن إيديولوجية موحدة لمشروع سياسي موحد كان يرى في تحدّي الغرب وتفكك المشرق بدايات نهاية مؤلمة لمشروع الرسول الإسلامي، نهاية كان يرغب ابن تومرت في إجهاض بداياتها (12).
بعد وفاة أبو عبد الله محمد بن تومرت عام 1128 م، وبعد أزمة خلافة استمرت ما يقارب السنتين بين عبد المؤمن وأبو حفص، استلم قيادة الحركة أخوه عبد المؤمن الذي أصبح عمليا زعيما لقبيلة مصمودة البربرية منذ عام 1130 م.
وعبد المؤمن يعتبر المؤسس السياسي والعسكري لإمبراطورية الموحدين. فقد استطاع خلال سنوات معدودة، انطلاقا من عام 1140 م، توحيد كافة مدن المغرب العربي بما فيها طرابلس، مسيطرا بذلك على القمم والسهول، الساحل والصحراء، المخزن وبلاد السيبة.
عام 1140 هزم جيوش المرابطين واحتل وهران وتلمسان وتازا وفاس وسبته وسلا، وفي عام 1146 م دخل مراكش منتصرا، وكان قبلها بعام قد أرسل جيشا إلى اسبانيا تمكن بواسطته، وبعد خمس سنوات، من ضمها إلى دولته. بعد إتمام السيطرة على اسبانيا والمغرب الأقصى اتجه الموحدون نحو الشرق فأنهوا حكم بني حماد عام 1152 م وطردوا النورمانيين، الذين خلقوا بني زيري في تونس عام 1158 م، وانهوا تقدمهم باحتلال طرابلس الغرب.
إذن من حدود مصر الساحلية، إلى حدود الأطلسي، مرورا بجميع سواحل افريقيا الشمالية وصولا إلى اسبانيا كانت دولة الموحدين من عام 1130 إلى عام 1269 م قد ثبتت الاتجاه التاريخي للمغرب العربي، اتجاه لم يضعف بشكل ملحوظ إلا بعد هزيمة غير متوقعة في لاس نافاس عام 1235 م والتي انتهت بانسحاب الموحدين من اسبانيا.
هزيمة «المسلم» أمام «المسيحيۑ»، وتراجع الأول عن حماية العمق الإسلامي في اسبانيا، كانت مدخلا لتناقضات داخلية سوف يؤدي تفاقمهما إلى تفتيت أهم مشروع توحيدي عرفته المنطقة منذ الفتح العربي. ففي عام 1172 م، وقبل الهزيمة أمام «الايبريين»، احتل صلاح الدين الأيوبي طرابلس. وفي 1228 استفاد ممثلو الموحدين في تونس (بنو حفص) من الضعف العام فأعلنوا تأسيس إمارة مستقلة. وحذا حذوهم بنو زيان في مدينة تلسمان التي أعلنوا منها استقلالهم في إمارة عام 1235 م. فلم يبق من سلطة الموحدين إلا المغرب الأقصى الذي كانت موازين القوى فيه تميل لمصلحة قبيلة بني مرين الجبلية التي لم تتردد في حسم الأمور لمصلحتها واحتلال مراكش عام 1269 م واضعة بذلك اللمسات الأخيرة على مشروع لم يكن مقدرا له هذا الانهيار السريع. (14).
ما ذكرناه لا ندعي كونه تأريخا ولا مساهمة في مشروع تأريخ. إنه محاولة قراءة للخطوط العريضة لتاريخ منطقة كانت منذ الفتح العربي في حالة حرب ضد غرب يسعى إلى تفتيتها والسيطرة عليها للعبور منها إلى المشرق العربي.
قوانين تاريخية لتكوّن الدولة السياسي باتجاه وحدوي حاولنا رصده بمنظار وعي الذات لنفسها: الوحدة كعامل استقلال وقوة في مواجهة الخارج. سقوط دولة وقيام دولية. استمرارية التناقضات السياسية والاقتصادية لم تغير في بنية الاتجاه نفسه، سوى مراحل ثباته الزمنية: الإسلام عامل وحدة، العلاقة مع المشرق تبادلية ومصيرية، السلطة المحلية لا «تهندس» حدودا ولا تغلق على نفسها في منطقة جغرافية ما. الادارسة القادمون من الشرق العربي، الفاطميون المغاربة الذاهبون إلى المشرق العربي، المرابطون القادمون من الصحراء والموحدون الهابطون من جبال السوس، عرب وبربر كانوا يصنعون تاريخا مليئا بالصعوبات والمنافسات المحلية.
حقيقة لا يخفي هذا التاريخ بروزها في كل لحظة انتقال أو انهيار وهي أن التناقضات المحلية كانت خاضعة باستمرار لإستراتيجية توحيدية تتعامل مع مجتمع المغرب العربي بوصفه وحدة ذات تمايزات وبوصفه تمايزات تسعى لفرض الوحدة.
هذه الإستراتيجية كانت تعكس معرفة «الذات» لحاجاتها وقدرتها على تحديد توجهاتها السياسية، يقابلها إستراتيجية أخرى كانت قد بدأت في محاصرة الشرق بجحافل الصليبيين، الذين زحف لصدهم الفاطميون من الغرب إلى فلسطين وطاردوهم إلى أنطاكية، بشن هجمات متتالية على الأندلس والجزر المتوسطية والأطلسية. ومنذ سقوط إمبراطورية الموحدين سوف تشهد الإستراتيجية الأولى تراجعا ملحوظا سوف يعمل التدخل العثماني على دعمه بإيقاف تقدم الغرب. ولكنه في نفس الوقت سينتهي مقدما للغرب نفسه منطقة ساعد بسياسته على ترسيخ تمايزاتها التي من خلالها ستدخل إستراتيجية الغرب لتحوّل هذه التمايزات، بالقوة، إلى وحدات سياسية: شعوب وأوطان.
تراجع المشروع الوحدوي وبدايات الانقسام
تحولات الوضع في المشرق العربي وحسم معركة اسبانيا لصالح الكاثوليك، يضاف إليها انهيار القوة المحلية القادرة على مواجهة آثار هذه التحولات، أدخلت المغرب العربي في مرحلة جديدة بدأت مع مطلع القرن السادس عشر واستمرت لغاية القرن التاسع عشر. الميزة التاريخية للوضعية الجديدة كانت تحويل شما افريقيا إلى ساحة سجال استراتيجي للهيمنة دارت رحاه بين الدولة العثمانية وأوروبا. ففي الوقت الذي شملت الغلبة العثمانية مناطق المشرق الغربي كان حتميا اتجاه الخلافة الفتية نحو افريقيا. كما أن سقوط اسبانيا بيد فردينان والملكة إيزابيل عام 1492 م، وإخراج المسلمين من شبه الجزيرة الايبرية كان أيضا بداية التقدم الأوروبي إلى مداخل افريقيا من ناحتي الأطلسي والأبيض المتوسط.
التدخل العثماني توقف عند حدود إمارة الجزائر والتدخل الأوروبي وصل إلى سبته ومليلية متجاوزا جبل طارق، وبينهما بقي المغرب الأقصى منطقة مستقلة تحارب المد العثماني شرقا والخطر الأوروبي شمالا وغربا. ومنذ 1587 م تحديدا كانت ليبيا وتونس والجزائر قد تحولت إلى ثلاث ولايات عثمانية بحيث انعقدت علاقات سياسية جديدة وضعت الاتجاهات التوحيدية على هامش التطور اليومي للأحداث التاريخية منتجة بذلك سلطة عثمانية في شرق المغرب العربي وسلطة شريفية في المغرب الأقصى (مراكش). سلطات فوق المجتمع لم تغير تجديدات البنية السياسية الفوقية من طبيعة الانتماء القومي إلا في فترة لاحقة وبعد ثلاثة قرون من الفصل الجغرافي والتمايز السياسي.
منذ مطلع القرن السادس عشر وبوادر التدخل العثماني في المغرب العربي تسير نحو الظهور بحيث أن منتصف القرن كان قد وضّح السياسة المبدئية للسلاطين الجدد. السيطرة العثمانية على القسم الشرقي من المغرب وقسمه الأوسط كانت نتيجة صراع دائم الحركة بين أطراف متناقضة المصالح تتغير تحالفاتها وفق موازين القوى: العثمانيون، الأوربيون وسكان المناطق المذكورة. كما كانت سيطرة ناقصة، بمعنى أنها لم تكن شاملة لكل المغرب العربي مما أوجد حلقة ضعف مركزية في المشروع العثماني: عدم القدرة في الوصول إلى المحيط الأطلسي. وناقصة أيضا لأن سلطة المشروع المذكور لم تستطع بلوغ كافة المناطق الواقعة تحت نفوذها.
سيطرة عثمانية غير هادئة، في حالة استنزاف دائم أمام محاولات حثيثة لاختراق ثغور السلطة، سيطرة غير شاملة لعدم تمكن السلطان العثماني من ممارسة سيطرة فعلية إلا في المناطق المحاذية للبحر الأبيض المتوسط.
أما عمق البلاد فقد كان، بسبب بعده عن مركز السلطة وعن مصدر الخطر الاستراتيجي (الأوروبي غالبا)، شبه مستقل، تخضع السلطة فيه للبنى الاجتماعية المحلية التي كانت سائدة –قبائل بشكل خاص. (15)
أما السيطرة نفسها فتدخل في تطور تاريخي خاص. أدى ضعف الإمبراطورية الموحدية إلى استقلال الجزائر التي أعلن عمال الموحدين فيها بنو زيان عن قيام إمارة جعلوا تلمسان عاصمة لها من 1235 إلى 1393 حيث عادت لتسقط من جديد في يد بني مرين المراكشيين وتتوحد مع المغرب الأقصى. في مطلع القرن الخامس عشر كانت الموانئ الجزائرية، بجاية ووهران، إضافة إلى طرابلس الغرب قد وقعت تحت سلطة الجيوش الاسبانية. عجّل هذا الانتصار الأوروبي بقدوم العثمانيين الذين استفادوا من أحداث «لسبي» فاحتلوا جزيرة حربي الواقعة مقابل الساحل الليبي (طرابلس) حيث بدأوا من هناك، بقيادة عروج بربروسة بشن هجمات بحرية على مواقع الجيش الاسباني انتهت بتراجع بني مرين عن الداخل الجزائري وانكفائهم نحو الغرب المغربي.
وفي عام 1515 وصل عروج إلى الجزائر معلنا بداية دخول هذه المنطقة تحت نفوذ السلطنة. ثلاثون عاما من التوتر والتصادم واجهت الدخول العثماني وانتهت بإحكام السيطرة: عام 1518 جرى تعيين خير الدين واليا على الجزائر بعد وفاة أخيه عروج، في عام 1530 سقطت قلعة بي تن الجزائرية التي كانت لا تزال في قبضة الاسبان، أما مدينة وهران فلم تسقط إلا عام 1708. أما التمركز الفعلي للسلطة الجدية فقد بدأ بعد وفاة حسن آغا عام 1544. (16)
بدءا من هذا العام أصبح الباب العالي صاحب القرار والسلطة السياسية المباشرة في الجزائر، حيث تحولت السلطة المحلية إلى باي لارباي يُعيّن مباشرة من قبل بابا العالي (17). أول ابي لارباي كان حسن باشا الذي بدأ حكمه اثر وفاة حسن آغا عام 1544. لكي يتمكن الوالي العثماني من ضبط الوضع الداخلي وتحديد منطقة نفوذه السياسي والعسكري عمد إلى تقسيم الجزائر إلى أربع مناطق:
1- منطقة مدينة الجزائر وضواحيها، وبعض المرافئ الهامة، وهي تدار من قبل الباشا مباشرة.
2- منطقة الجنوب وتسمى تيتري، تأسست عام 1548 وعاصمتها مدينة ميديا، وتدار بواسطة باي يعينه الباشا.
3- منطقة الغرب، المتأسسة عام 1563، تبدلت فيها العواصم لأسباب غير واضحة، وعلى الأرجح لأسباب عسكرية. فقد كانت عاصمتها الأولى مازونا والثانية مسكرة والثالثة وهران. أما قائد المنطقة (الباي) فيعينه الباشا أيضا.
4- منطقة الشرق، تأسست عام 1567، عاصمتها قسنطينة، وتدار بواسطة باي يعينه الباشا.
لم يستطع الباشا فرض سلطته على كل المناطق، وكما أشرنا آنفا، فان مناطق عديدة بقيت خارج النفوذ الفعلي للعثمانيين، محتفظة بسلطتها القبلية السائدة. كما كان الحال مع الملك كوكو، الذي كان حاكما على المنطقية الجبلية كلها. كذلك «شيخ بني عباس» الذي كان يحكم منطقة توغودت. (18). دون أن يعني ذلك «استقلالات» إيديولوجية عن الخلافة الإسلامية المرمّز إليها بالخليفة العثماني. بمعنى آخر، أسفر عدم الاهتمام بعمق المنطقة وانشغال العثمانيين بالثغور عن إبقاء مناطق محددة تخضع لسلطاتها المحلية التي لم تضع نفسها في مواجهة «المركز» بشكل حاد.
من بداية السيطرة العثمانية إلى بداية التدخل الفرنسي، عرفت الجزائر أربعة أشكال من السلطة السياسية، وذلك خلال أربع مراحل قطعها الوجود العثماني من 1546 إلى 1830.
المرحلة الأولى، وهي مرحلة الباي لارباي، امتدت من 1546 إلى 1587.
المرحلة الثانية، وهي مرحلة الباشوات الثلاثيات –أي أن حكم الباشا يدوم ثلاث سنوات فقط- امتدت من 1587 إلى 1659.
المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الاغاوات، امتدت من 1659 إلى 1671.
المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الديات-الداي- التي امتدت من 1671 إلى 1830 وانتهت مع احتلال فرنسا للجزائر في نفس العام.
وضعية المغرب الأوسط –الجزائر- تحت الحكم العثماني، كان يشوبها توتر داخلي بين رموز السلطنة العثمانية والزعماء المحليين. توتر كان يزداد أو يخف حسب درجة الانتفاضات الريفية ودرجة الخطر الخارجي وخاصة الاسباني. ورغم فشل الداي محمد بن عثمان 1766-1791 في محاولة إعلان نفسه ملكا للجزائر فإن النفوذ السياسي للزعماء المحليين كان يتعاظم بشكل أصبح معه القول بثنائية السلطة ممكنا.
 مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير