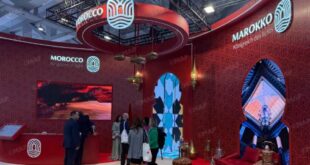لم يخل مسار الحراك العربي من تعقيدات وارتباكات، عكسها تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في عدد من الدول، كما هو الشأن بالنسبة لليبيا وسوريا واليمن.
وإذا كان ذلك، يعكس حجم المشكلات الداخلية المختلفة التي تراكمت على امتداد عقود عدة، في علاقة ذلك بعدم القدرة على تدبير الاختلاف والتنوع بصورة ديمقراطية داخل المجتمع، وعدم اعتماد آليات العدالة الانتقالية كسبيل لطي صفحات قاتمة من تاريخ هذه الدول، إضافة إلى هشاشة المؤسسات القضائية والتعليمية ومختلف القنوات الوسيطة من نقابات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، وعدم انخراط عدد كبير من النخب المثقفة في مواكبة وتوجيه الحراك، فإن العامل الخارجي ظلّ حاضراً ومؤثراً في مسار هذا الحراك، بالسلب تارة أو الإيجاب تارة أخرى.
وتشير الممارسات الدولية إلى أن التداعيات المرتبطة بغياب الديمقراطية وعدم احترام حقوق الإنسان، تتجاوز حدود الدول، حيث تفرز معضلات كبرى في علاقة ذلك بتنامي المجاعات والهجرة واللجوء بحثاً عن فضاءات مستقرة وآمنة، إضافة إلى كونها تتسبب أحياناً في اندلاع صراعات سياسية وعسكرية داخلية، تصل شرارتها إلى دول الجوار والمحيط الدولي، بما يشكل مسّاً بالسلم والأمن الدوليين.
وقد كان لذلك أثر كبير في ظهور اجتهادات فقهية عدة تدعم التدخل الدولي بدواعي حماية حقوق الإنسان ودعم الممارسة الديمقراطية، رغم تصادمها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، كسبيل لتجاوز الإكراهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها الأنظمة الشمولية في هذا الشأن.
كما أن منظمة الأمم المتحدة ذاتها باشرت مجموعة من التدخلات في هذا الصدد من خلال مجلس الأمن باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين، سواء كان ذلك عبر تدخلات زجرية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحالتي الصومال وكوسوفو، في سنوات التسعينات من القرن المنصرم، أو تعلق الأمر بسبل دبلوماسية، ضمن عمليات الأمم المتحدة التي سعت إلى تقديم المساعدة لدعم التحول الديمقراطي في عدد من الدول في علاقة ذلك بوضع القوانين الانتخابية ومراقبة الانتخابات ودعم الحوار والمصالحة بين مختلف الفرقاء السياسيين، وفرض احترام وقف إطلاق النار والمساهمة في وضع مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادتها.
وتندرج في هذا السياق كل من تجربة كمبوديا، حيث قامت فيها الأمم المتحدة بتدبير السلطة الانتقالية، وكذلك تجربة هاييتي التي سعت فيها الأمم المتحدة إلى دعم المصالحة الوطنية وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد، خلال الفترة نفسها.
من المؤكد أن العامل الخارجي لا يمكن أن يحسم في التأسيس لنظم ديمقراطية بدول الحراك، إلا إذا كان هناك ما يدعم ذلك داخلياً بالأساس، فدوره (أي العامل الخارجي) يظل متوقفاً على توجيه الأحداث – لا صناعتها – خدمة لمصالح أطرافه في أغلب الأحوال.
إن المبالغة في المراهنة على العامل الخارجي في هذا الصدد، أو الاعتقاد بنظرية المؤامرة في تفسير الحراك، ينطويان على قدر من الإساءة لإرادة الشعوب، بل إن في ذلك تنكر لحقائق ومعطيات موضوعية وواقعية ولد معها الحراك ولادة طبيعية في دول نخرها الاستبداد والفساد.
لا تخفى آثار العوامل الخارجية في مسار الديمقراطية، فوجود “جوار ديمقراطي”، غالباً ما يدفع إلى اعتماد إصلاحات وتغييرات بصورة تلقائية واستباقية درءاً لأي انفجار مطلبي في الداخل، تحت واقع الانبهار بتجارب هذا الجوار. أو السعي لإحباط التحول في مهده بالتواطؤ مع النظم الإقليمية المهدّدة، عبر دعمها بالمال والسلاح والتحرك الدبلوماسي.
لا تخفى تأثيرات مواقف وسلوكات المنظمات الدولية الحكومية، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وغير الحكومية كمنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين في توجيه الأحداث، والشيء نفسه بالنسبة إلى المحاكم الدولية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي بإمكانها تحريك مسطرة الإحالة والمتابعة في حق المتورطين في جرائم إنسانية خطرة تندرج ضمن اختصاصاتها.
كما يتخذ هذا العامل أشكالاً أخرى مرتبطة بتسليح أحد الطرفين أو التدخل العسكري لدعم الحراك، كما حدث في ليبيا عندما تدخل حلف “الناتو” بتنسيق مع الأمم المتحدة لحسم المشكلات مما عجّل بإسقاط نظام القذافي.
وفي دول الحراك، كان لمواكبة الصحافة الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي لتطور الأحداث أثر كبير في بلورة رأي عام دولي، كان له الأثر الإيجابي في حسم الأوضاع في اتجاه معين.
وفي مقابل ذلك، لا تخفى أيضاً الانعكاسات السلبية التي يسببها التلكّؤ في الاعتراف بالمعارضة/المقاومة أو سحبه وإصدار المواقف والتصريحات وبخاصة من القوى الدولية الكبرى، إزاء القوى المعارضة واتهامها بالعمالة أو “الإرهاب”، علاوة على التحرك من داخل الهيئات والمنظمات الدولية في هذا الصدد. كما يمكن أن تلعب المعونات الإنسانية والتقنية والعسكرية، دوراً مهماً في حسم الأمور لمصلحة طرف داخلي أو آخر.
لقد أثبت مسار الأحداث في المنطقة، ضعف العامل الدولي في دعم الحراك، مقارنة بحضوره في تجارب دولية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لدول أوروبا الشرقية في بداية التسعينات من القرن الماضي، لاعتبارات ذاتية مرتبطة برفض هذا التدخل رسمياً وشعبياً في دول المنطقة، وللتلكؤ الغربي الحاصل في هذا الشأن أيضاً.
فقد تبين في كثير من الأحيان أن عدداً من القوى الدولية وفي سعيها لحماية مصالحها، ظلت حريصة على دعم الاستبداد بكل الوسائل الاقتصادية والمالية والتقنية والعسكرية، وهو ما برز بشكل جلي في الحالة السورية التي تطرح مسؤوليات جساماً أمام الأمم المتحدة، وتضع الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تنامت في العقود الأخيرة على المحك، وتجعل مختلف الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية أمام اختبار حقيقي لقياس مدى توافر الجدية في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، بعيداً عن أي اعتبارات أو خلفيات سياسية ومصلحية ضيقة.
* باحث أكاديمي من المغرب/”الحليج”
 مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير