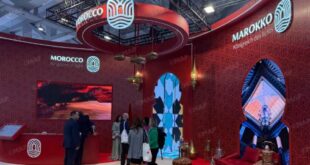تقديم
يرمي هذا العمل إلى استبيان ملامح القاعدة الفكرية التي على أساسها قامت دعوة المرابطين في صحراء صنهاجة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وبذلك فإن هذه المراجعة تندرج في سياق المساهمة في إحياء تاريخ الحقبة المرابطية، الذي لا يزال بحاجة إلى دراسات معمقة تقدم معطياته بوجهها الحقيقي، لا سيما وأن بعض دارسي هذه الحقبة قد حاولوا إبقاء التاريخ الثقافي المرابطي وشواهده غميسة أو هامشية. ومن ذلك زعمهم أن هؤلاء الظواعن الصحراويين قد قضوا على رونق الحضارة الزاهر في الأندلس وأعدموا الذِّمَاء الباقي من الثقافة في المغرب([1]). وهو مردود منطقياً وتاريخياً.
لكن هناك أعمالاً لها قيمتها التي لا تنكر، أنجزت حول المرابطين، لكنها مع ما تحوزه من دقة معرفية، لم تتناول بشمولية دور العامل الفكري في تاريخ الحركة. وقد يكون هذا القصور راجعاً إلى اعتبارات منهجية بحتة فرضت نفسها على مُنْجزي تلك الأعمال، كضرورة تركيزهم على قضايا بعينها([2])، أو لاندراج إسهاماتهم ضمن حقول أخرى غير تاريخ الذهنيات([3]).
وبالرغم من ذلك فإن هناك قراءات بارزة حاولت وضع الحركة في سياقها الفكري – الإصلاحي، حيث لفتت الانتباه إلى منْزلة الحركة المرابطية من المد السني الأشعري الذي ساد المشرق إبان صعود الحركة، كما أكدت على دور قادة هذا المدّ في التهيئة للدعوة المرابطية، معتبرة بذلك عبد الله بن ياسين وسلفه من الفقهاء، جزءاً من شبكة الدعاة السنيين العباسيين الذين حاولوا الالتفاف حول الحركات الباطنية وذلك بتطويقها من الشرق والغرب الإسلاميين.
ونحن نقبل هذا الطرح في خطوطه العريضة لكنه يظل مثغوراً ما لم يُفهم الدور الذي قامت به المدرسة الأشعرية في التمهيد لعملية توحيدية حاسمة كتلك التي قام بها ابن ياسين وأمدها ومهّد لها فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي، دون أن يعني ذلك أي حضور بارز للأشعرية في التّديُّن المرابطي.
والمعروف نشر المرابطين للإسلام السني في الصحراء والمناطق التي افتتحوها، لكن المتفحص لهذه الوحدة العقدية يلاحظ غياب دور واضح فيها للأشعرية، رغم أن هذه الأخيرة كانت من مشمولات الخطاب الفكري المرابطي، من حيث وجود الأفكار الأشعرية لدى كبار العلماء المشارقة وبعض المغاربة ممن كانوا شيوخاً لسلاسل فقهاء المشروع المرابطي. وكذلك بالنظر إلى مقتضيات الظرف التاريخي التي جعلت الحركة المرابطية جزءاً من حركة المدّ السني المعنية.
ومن هنا ينبغي التساؤل عما إذا كان المحمول السياسي للأشعرية ممثلاً في الشرعية العباسية هو وحده الذي انتقل إلى الفضاء الفكري الممهّد للحركة؟ وما هي الظرفية المركبة التي اكتنفت علاقة الأشعرية بالفقهاء في المغرب الإسلامي ثم الإسلام المرابطي.
وهل يتعلق الأمر بكون الدعوة المرابطية لم تكن أبداً إلا مشروعاً مالكياً خاصاً بهموم الفقهاء في المغرب الأقصى؟
أم أن حقل الدعوة المرابطية وخصوصيته كانت هي العوامل الحاسمة في عملية الاختيارات الفكرية الكبرى للحركة المرابطية؟
إنه للإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، يقتضي الأمر الحديث عن طبيعة الإسلام الصنهاجي بوصفه المجال الذي غيرت فيه دعوة الحق ومنه انطلقت فاتحة وموحدة.
خصوصية حقل الدعوة المرابطية
يبدو أن صنهاجة الصحراء قد تعرفوا على الإسلام لأول مرة بعد اصطدامهم بحملات الفتح العربي، وهو الاصطدام الذي مس بشكل خاص المجموعات الصنهاجية الأكثر تغلغلاً في السوس الأقصى([4])، إلا أن هذه العملية لم تؤدّ إلى أسلمة المغزوِّين لأن المصادر تحدثت بعد ذلك عن سرايا عربية ظلت تنطلق من السوس في اتجاه الصحراء وافترض أنها وصلت إلى حدود نهر السنغال([5]).
والمفهوم أن هذه العمليات الحربية الخاطفة كانت موجهة ضد الاتحاد الصنهاجي الذي يقوده أمراء عشيرة “أنْبيتا” اللمتونية، والذي استمر مسيطراً على أودغست 306 ﻫ/ 918 م([6])، حيث أنه بعد انفراط هذا التحالف لم تشر المصادر إلى حملات أخرى على المنطقة. فهل يتعلق الأمر بحصول سكان الصحراء آنذاك على درجة من الأسلمة كافية لحمايتهم من بطش الفاتحين؟
نحسب أن الأمر كان كذلك وإلا لما ذكر الإخباريون أن صنهاجة في تلك الفترة كانوا على السنة مجاهدون للسودان، وأن رئيس حلفهم عبد الله بن تفاوت كان «من أهل الفضل والدين والحج والجهاد»([7]).
إلا أن هذا الإسلام «السني» و«الجهاد» ضد مشركي السودان قد لا يعني تعميق الأسلمة بين الصنهاجيين بدليل سطحية إسلامهم التي كشف عنها بدءاً أمر المرابطين. بل إن قصارى ما يمكن فهمه من تلك «السنية» هو تميز الإسلام الصنهاجي على ما يجاوره من الدوائر الدينية والمذهبية المنتشرة آنذاك حول الصحراء، ومن هنا لم ينسب الصنهاجيون إلى أي من تلك الفرق والمذهب، وبذا لم يصنفوا ضمن الكتابات التي أشارت إليهم إلا في عداد أهل السنة([8]).
ولكن هل كانت هذه الخصوصية التي اتسم بها إسلام صنهاجة الأول، عاملاً حاسماً من بين المؤثرات الهامة الأخرى، في الاختيارات الفكرية للحركة المرابطية؟ أو بتعبير آخر هل إن سنية المرابطين كانت مرتبطة بحقل الدعوة الأول؟ بحيث ما كان لهذا الحقل أن يتقبل أسلمة لا تستجيب لخصوصيته التاريخية “العقدية” التي ميزته عن الدوائر المذهبية المحيطة به؟
إن الباحثين([9]) يربطون بين المشروع المرابطي وعملية المد السني التي بدأها الأشاعرة على مستوى المشرق، أي أنهم يعتبرون الحركة المرابطية عملية تطويق من الغرب للمذهب الإسماعيلي استكمالاً للدور الذي قام به السلاجقة شرقاً، وبالتالي فإن رحلة زعيم صنهاجة الصحراء يحيى بن إبراهيم الكدالي إلى الحج كانت قد تأثرت بهذا المد السني، خصوصاً وأن موسم الحج غالباً ما يكون مرتعاً خصباً للفرق الإسلامية التي تتلقف فيه حجاج الآفاق لتنشر بينهم مبادئها وآرائها([10]). فمن غير المستبعد أن يكون الدعاة السنيون (في مكة؟ في المدينة؟ في القيروان؟) هم الذين بادروا بالاتصال بيحيى بن إبراهيم وعرضوا عليه مرشداً ومربياً ليعرف قومه على شؤون الإسلام وأحكامه([11])، أو لعلهم أحالوا الأمير الصنهاجي إلى قادة المالكية في القيروان لقربهم من بلاده نسبياً، ولدرايتهم بشؤون الغرب الإسلامي([12])، ومن هنا يصبح داعنة المرابطين الأول عبد الله بن ياسين وخلفاؤه وأشياخهم مندرجين في سلسلة من الدعاة السنيين العباسيين([13]).
إننا نقبل مثل هذه الطروحات لكنها مع ذلك تظل قائمة ما لم يفهم الدور الذي لعبته الأشعرية في التمهيد للحركة المرابطية أو بمعنى آخر ما لم تفهم صلة الأشاعرة بالمشرق بشبكة الفقهاء المالكيين التي نظرت لحركة المرابطين، أو بمعنى آخر أي بكلمة واحدة قياس منْزِلة العقد الأشعري من المشروع الفكري المرابطي عموماً.
البعد الأشعري للحركة المرابطية
أولاً يجب التذكير بموقف المالكية عموماً من علم الكلام ومن العقائد التي تستخدمه لإكمال «معقولية» أنساقها الفكرية.
لقد كانت العقيدة السلفية التي يرأس القائلين بها الإمام مالك وباقي الأئمة الأربعة «عقيدة خالية من أساليب علم الكلام وأهله، تقرر العقائد بدءاً ولا تعالجها عقلاً»([14]). أما بناء الخطاب «الكلامي» الأشعري من عقيدة أهل السنة، التي أصبحت تجمع بين عقيدة أهل السلف وآراء الأشاعرة، فقد تَمّ مع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي كان متكلماً معتزلياً ثم تحول إلى عقيدة السلف ولكنه حمل معه آراءه الكلامية فحاول بناء عقد سني وسطي بين رأي أهل الحديث والأثر “السلف” الدعاية إلى التزام حرفية النصوص وتجنب استعمال العقل، وموقف الاعتزال الداعي إلى جعل العقل رائداً مما جعل مذهب الأشعري على حد رأي الباحثين([15]) يعكس تيارين فكريين متعارضين ظلاً متعايشين في مذهبه. ومن هنا إبهامية المذهب الأشعري وازدواجيته، ومن هنا أيضاً ذلك الموقف الحذر إن لم نقل المعارض الذي يوجبه به هذا العقد في الأوساط السنية، فابن الجوزي، وهو من الحنابلة المتأخرين ذهب إلى اعتبار الأشعري أحد المسؤولين عن «تلبيس العقائد» حيث يقول: «إن الأشعري ظل على مذهب المعتزلة زمناً طويلاً ثم تركه، وأتى بمقالة خبط بها عقائد الناس»([16])، وهذا ما يفسر الخصومة الشهيرة بين الحنابلة والأشاعرة في بغداد.
أما المالكيون فقد كان موقفهم متشدداً في رفض علم الكلام أسوة بالإمام مالك الذي حارب علم الكلام بشدة، خصوصاً في مسألة الصفات وعلاقتها بالذات. كما كان يرفض الرد العقلي على البدع، لأنه في رأيه رد بدعة ببدعة. وتظهر سلفية عقيدة مالك في أنه كان([17]) يغلب التنْزِيه في الصفات، ويأمر بأن بفهم الآيات المتحدثة عن الصفات (كما جاءت) لا بمعنى إجرائها على ظاهر النص فحسب، بل ويشترط أن لا يؤدي ذلك إلى مشابهة الله بالمخلوقين([18])، إلا أن النفس الأشعري مع ذلك قد تسرب إلى آراء وكتابات فقهاء المالكية بالقيروان خصوصاً إبان ظهور شيخ الأشاعرة ببغداد أبي بكر الباقلاني (ت. 404 ﻫ/ 1013 م) ([19]) الذي انتشرت آراؤه وكتبه وتوزع أتباعه في أمصار الإسلام، وكان من أعظم المتصلين به من بين المالكيين في القيروان المنظر الأول للمشروع المرابطي الفقيه أبو عمران الفاسي (ت. 420 ﻫ/ 1028 م) فهل انتقلت الأشعرية عبر هذا الفقيه إلى فقهاء المشروع المرابطي؟ أم إن هناك خصوصية في مستوى التلقي المعرفي بين المعنيين إلى جانب عوامل خاصة بحقل الدعوة الأول حالت دون حضور قوي للأشعرية في الإسلام المرابطي في الصحراء والمغرب؟
خصوصية التلقي المعرفي
لقد اعتمدت الدعاية السنية على الأشعرية كخطاب سني وسطي، إذ لم يكن لعقيدة السلف أن تقاوم، في نظر أصحاب هذا المشروع، الحركات الباطنية وفرق الزندقة المتشعبة بالموروث العقلاني الفلسفي والآراء والأفكار الغامضة لحضارة ما قبل الإسلام. غير أن الأشاعرة قد عرفوا نهضتهم البارزة بشكل خاص على يد القاضي الباقلاني الذي كان ظهوره بالغ الحسن الأشعري فتصدر للإمامة في طريقته فهذبها ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار([20]) فضلاً عن أنه كان مالكي المذهب بل إنه قد «انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته»([21])، وقد نشر الباقلاني تلاميذه في الأقطار من أجل الدفاع عن الأشعرية([22])، فهل انتقلت الأشعرية ومحمولها السياسي إلى فكر الفاسي فنقلها هو بدوره إلى أتباعه؟ إن الفاسي كان يعلن التزامه بالشرعية العباسية ويدافع عنه([23])، ولعل هذا هو ما انتقل إليه من المحمول السياسي لذلك التأثير الأشعري، أما عن علاقته بالأشعرية فإن الفاسي كان أولاً قد شد الرحال من بلده فاس إلى القيروان وبها تفقه بأبي الحسن القابسي([24])، ورغم أن القابسي لم يكن تلميذاً للباقلاني لكنه من طبقته حيث توفيا في نفس السنة (3-404) واشتركا في بعض التلاميذ. لكن الذي لا شك فيه هو أن القابسي قد اطلع على أشعرية الباقلاني وأفاد منها، فقد كانت له رحلة إلى المشرق([25])، غير أنه من الواضح أن القابسي لم يكن يلقن تلاميذه غير آراء مالك في العقيدة والتي هي في الأساس «عقيدة أهل السلف»([26])، كما لم يؤثر عن صنهاجة الصحراء أنهم اتصلوا بهذا الفقيه عبر استفتاءات وأسئلة موجهة إليه تماثل تلك التي كانت تصله من تجار القيروان والغرب الإسلامي ممن كانوا ينتشرون في الصحراء، خصوصاً في مدن تادمكه وأوداغست([27]). ومن هنا لم يتعرف أبو عمران على الأشعرية من خلال القابسي ولكنه إن كان قد عرفها فمن طريق المالكية وشيخه الباقلاني، فقد شد أبو عمران الرحلة إلى المغرب وعندما وصل إلى بغداد اجتذبته حلقات فقه العلوم([28])، وللوهلة الأولى يجب التأكيد على أن الفاسي لم يدرس حسب رأي عياض السبتي على الباقلاني غير علم الأصول([29])، إلا أن عملية التلقي هذه قد تركت في نفس الفاسي أثراً عميقاً جعلته يتحدث عنها قائلاً إن شيخه الباقلاني «سيف أهل السنة في زمانه، وإمام متكلمي أهل الحق في وقتنا (…) وقد رحلت إلى بغداد وكنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي الحسن القابسي وأبي محمد الأصلي وكانا عالمين بالأصول فلما حضرت مجلس القاضي أبي بكر رأيت كلامه في الأصول والفقه والمؤالف والمخالف حقرت نفسي وقلت: لا أعلم من العلم شيئاً ورجعت عنده كالمبتدئ…»([30]). إن الفاسي هنا يتحدث عن آراء شيخه باعتبارها «طريقة أهل الحق» وهو مفهوم فضفاض لا يعبر عن اقتناعه بأراء الأشعرية، وذلك لأنه لم يدرسها ابتداء إلى جانب معارفه من الفقه والأصول التي رده الباقلاني فيها “كالمبتدئ” ثم إنه من المأثور عن الفاسي أنه وصل إلى بغداد وهو لا يحسن إقامة الدليل “الكلامي” على قضايا الشريعة([31])، اللهم إلا إذا كانت عودته إلى القيروان وما حسمه فيها من قضايا كانت تشوش عقائد العامة([32]) واقعاً يؤكد حصوله على زاد أشعري تلقاه في بغداد وأبقاه طي الكتمان جرياً على سنن اتخذه الباقلاني إزاء علوم “الأوائل”([33]). ومهما يكن الأمر فإن الفاسي لم يعلن “آراءه” الأشعرية في القيروان بل بقي ينشر مورث الأصول الذي تلقاه عن الباقلاني، وعلوم الحديث التي درسها على أبي ذر الهروي في مكة([34]). كما أنه لم يترك نصاً يفيد تأثره بالعقد الأشعري بل إن تآليفه قليلة نادرة أشهرها “كتاب التعاليق على المدونة” وهو مؤلف في فقه المالكية قليل التداول([35]). وحتى إذا كان الفاسي قد تعمق في الفقه الأشعري وآراء أهل الكلام فإن هذا الجانب من زاده العلمي لم ينشر بين تلاميذه خصوصاً وجاج بن زلوه الذي درس عليه داعية المرابطين عبد الله ابن ياسين، والظاهر أن أبا عمران الفاسي كان يؤثر في تلاميذه بكيفيات مختلفة تعاليمهم الفكرية ومشاغلهم الخاصة، لذا كان منهم من غلب عليه التأثر بالفقه ومنهم من تأثر بعلمه في العقيدة إلى جانب علمه في الفقه وعلى حسب ذلك كانت آثارهم ونتائجهم([36]). فلعل هذا التقليد وحده هو ما انتقل من الفاسي إلى وجاج ثم إلى ابن ياسين ومن هنا عمل هذا الأخير على إشاعة العقد السلفي في الصحراء ولم يستطع أن يخرج على ذلك السنن المالكي الصارم رغم أنه كان قد دخل الأندلس ودرس بها علوماً كثيرة وصف معها أن كان مشاركاً في بعض العلوم التي قد تكون زاداً من “علوم الأوائل([37]). ورغم أهمية هذه العوامل في الحد من انتشار الأشعرية بين فقهاء المرابطين الأول إلا أنها عوامل تظل متصلة بتقاليد المعرفة أي بالنسق الفكري وآلياته، وهي بذلك على أهميتها، تبقى غير حاسمة في الإجابة عن أسباب غياب الأشعرية في عملية الأسلمة المرابطية على مستوى صحراء “الملثمين”.
مستوى الحاجة الفكري
إننا نحسب أن خصوصية الحق الذي نشطت فيه دعوة فقهاء المالكية بالقيروان ثم بالمغرب الأقصى والصحراء، هي الفيصل في عملية الاختيارات العقدية الأساسية للحركة المرابطية. إذ أن تبني أي نسق فكري أو سياسي من قبل دعوة أو حركة يظل مرتبطاً أشد الارتباط بمدى الحاجة إلى توظيف هذا النسق أو ذاك من أجل إنجاح المشروع المستهدف. ومن هنا كانت حاجة القوى السنية في المشرق إلى العقد الأشعري (الذي يحتفظ بقليل أو كثير من المشروعية السنية السلفية وتحذق أصحابه أساليب الحجاج والنظر) لمواجهة الخصوم الباطنيين المتسلحين بموروث الفكري الغنوصي والمانوي وآراء الملل والنحل المختلفة أي أن طبيعة التهديد قد حددت منذ البداية نوعية السلاح والأمر نفسه يصدق على محاولة الحركة الإسماعيلية في الغرب الإسلامي، حيث نجحوا سياسياً بفضل تركيزهم على الجانب التنظيمي السياسي واكتفائهم على مستوى الأفكار بنشر فكرة المهدوية بغية جمع الولاء القبلي البربري حول فكرة الدفاع عن حق آل البيت([38])، ولم يحاولوا نشر آراء الإسماعيلية في مستوياتها الباطنية في نفس المحيط البربري بين مجموعات لا تستطيع تقبل واستيعاب الأفكار الباطنية المعقدة إلا إذا تبلورت في شعارات تحرك العواطف، ومن هنا فإن طبيعة الحقل الذي واجهته كل الدعوات ضمن الإطار الإسلامي ونوعية الخصوم كانت هي العوامل الأساسية التي بلورت نوعية الخطاب الذي تستلزمه كل دعوة وحركة. ونفتقد أن تلك الخصوصيات وغيرها من الظروف هي التي وعاها المالكيون في إفريقية ومنهم انتقلت إلى دعاة المرابطين الأول فساهمت بذلك في اختياراتهم الفكرية الأساسية فضلاً عن تأثير حقل الدعوة في الصحراء وظرفيتها السياسية في المغرب وطبيعة القائمين بالدعوة نفسها كل ذلك ساهم في نفس عملية الاختيار، ذلك لأننا إذا لم ننطلق من هذا المنحنى لا نستطيع سوى تقديم إجابة عائمة عن الأسباب التي جعلت ابن ياسين يتنكب المنهج الأشعري بل وأساليب علم الكلام من أساسها، ويولي وجهة شرط المالكية النصانية وآرائها التي تلائم الوسط البدوي الذي ينوي بعض الدعوة من أعماقه، إننا يمكن أن نرجع هذا التوجه وخصوصيته الدعوية إلى مستويين اثنين:
أولاً: الخصوصية النسقية للمالكية: تتمثل هذه الخصوصية في التقليد العلمي المأثور عن مالك بن أنس والقاضي برفض «الرد العقلي على أهل البدع لأنه في رأيه رد بدعة ببدعة، ويرى ضرورة الرد عليها بالنقل»([39]). ولذا فإنه إذا جاء بعض أهل الأهواء كان يقول: «أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه»([40]). وهو تقليد ازداد صلابة على يد فقهاء الغرب الإسلامي سواء منهم أولئك الذين تلقى عنهم ابن ياسين فقه المالكية أو غيرهم من “الأعلام” الذين يندرج هو نفسه في سلكهم وقد تدعم هذا المنحى واشتد أثره في فكر ابن ياسين عندما خبر بنفسه طبيعة المناوئين لدعوته في صحراء الملثمين.
ثانياً: محدودية عنصر الخصوم: لنفترض أن العقد الأشعري وما يصطنعه أصحابه من أساليب الحجاج والنظر كانت جلية واضحة في خطاب الدعوة المرابطي عند ابن ياسين، فضد من سيوظف هذا الأسلوب الفكري المجادل، وعنصر الخصوم الذي استدعى اصطناع مثل تلك الأساليب عنصر غير حاضر في صحراء الملثمين حضور يتأسس وجود أصحابه في إطار مشروع فكري إيديولوجي. ذلك أن صحراء الملثمين كانت تعرف بشكل خاص وجود نحل وديانات وفرق تتراوح بين الأديان السماوية والأفكار الوثنية إلى جانب المجموعات التي تعتنق آراء الفرق الإسلامية المبتدعة([41])، ولم يكن حضورها في المنطقة إلا حضوراً سياسياً واقتصادياً مما جعل مناوءتها ومصاوأتها من قبل المرابطين تغلب منازلة بالسيف والسنان لا بالقلم واللسان. ولعل هذه الخصوصية الدعوية هي التي جعلت بعض الباحثين يعتبر الدعوة المرابطية في الصحراء قد قامت بنشر الإسلام السني بدل مثيله الإباضي الذي كان قد انتشر في المنطقة على يد الدعاة الأباضيين الأول([42]).
ويبقى السبب الحاسم في غياب الأشعرية من الفضاء المرابطي هو السبب الهيكلي المتمثل في عدم تقبل البدو الرحل للنّزعات الباطنية، والعقائد الموغلة في التجريد الذي تدق به عن أفهام “العامة”. ناهيك عن أن حضور المتكلمين السنيين الأشاعرة المتمحضين لمعلم الكلام إلى الصحراء كان قليلاً وهو إلى ذلك ضئيل التأثير.
ففي العهد المرابطي الأول وصل إلى الصحراء قادماً من أغمات المتكلم الأصولي أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي المرادي القيرواني (ت. 489 ﻫ)([43]) «وقد كان الحضرمي أول من أدخل علوم الاعتقادات إلى المغرب الأقصى»([44])، وبالتالي فإن حقل الأشعرية لم يكن أمامه معبداً بانتفاء وجودها ابتداء في المنطقة، ولذلك لم يؤثر عن الحضرمي أنه نشر في صحراء الملثمين آراءه في العقد الأشعري رغم أنه صاغ هذه الآراء ضمن أرجوزات مختصرة سهلة الحفظ([45])، وما دامت لم تبق لنا منها أثرة أو نماء يبني عليه المتأخرون فمعناه أن صاحبها لم يستطع إشاعتها في الأوساط الصحراوية، أو حاول ذلك، ولكنها كانت محاولة لم تؤت ثمارها لانتفاء الحاجة إليها أصلاً.
ومن هنا يمكن تفسير كون شخ الأشعرية بأغمات أبا الحجاج موسى الكلبي الضرير كان آخر أئمة المغرب فيما أخذه عن الحضرمي من علوم الاعتقادات بالمغرب الأقصى([46])، وبعده توارت الأشعرية إلى حين، وبذلك يمكننا اعتماد قولة العروي([47]) التي مؤداها أنه بعد استتباب أمر المرابطين حدث التخلي عن الكلام الأشعري رغم مقام الباقلاني؟ وهو سؤال نعتقد أنه في غير محله نظراً لكونه لا يفسر كيف يتم التخلي عن نسق فكري لم يتقبل منذ البداية أو يستخدم عملياً، ثم لأن الطابع المذهبي المالكي قد طغى منذ البداية على مشروع الحركة المرابطية فضلاً عن أن أهل الصحراء قد تقلبوا هذا المذهب وبسهولة تفسر نجاح دعوة المرابطين واستمرارها في المنطقة.
البعد المالكي للحركة المرابطية
يبدو أن العوامل التي أدت إلى ضمور الأشعرية في الإسلام المرابطي، كانت هي الفاعلة لتمكين المذهب المالكي في الصحراء، وفي القاعدة الفكرية للحركة المرابطية. فطبيعة المذهب المالكي من حيث جوهره، هي طبيعية قوامها الإبعاد عن أساليب أصحاب علم الكلام والمنطق أي عن الرأي. ومن هنا ذلك التقليد المالكي القائم على كراهة ما ليس تحته عمل من قضايا ومسائل الأحكام، بحيث أصبح المذهب المالكي «لا يقوم على الرأي والقياس بقدر ما يقوم على النص والنقل وعلى الأثر والرواية»([48])، ولعل هذا جمعيه هو الذي جعل المذهب المالكي يمثل الوجه الآخر لعقيدة السلف التي هي على الأرجح العقد الذي تقبله أهل الصحراء لبساطته ووضوحه. ولعل هذا الواقع هو ما عناه ابن خلدون حين قرر «إن البداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس أو من في حكمهم من أهل صحراء المغرب، ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا لأهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل المذهب المالكي عندهم غضاً ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب..»([49]).
إن هذه الخصوصية التي امتاز بها المذهب المالكي على مستوى نسقه الفكري، هي ما نحسبه البريق الذي ذهب إليه جماعات صنهاجة الصحراء لكونهم بدواً رحلاً لا يستطيعون، كحالهم مع العقد الأشعري، تقبل الأنساق الفكرية التي تميل إلى التعقيد أو تتبنى الأساليب الاستدلالية المفضية إليه. ومن هنا كان الصنهاجيون يميلون دائماً إلى الأفكار التي تلائم حياتهم المتمثلة في زهد موغل في البساطة، وورع صارم يتمثل في صرامة الأحكام و”سد الذرائع”([50])، إلى جانب قدرة مشهورة على التكليف مع الواقع وما يطرحه بين الحين والآخر مثل إشكالات تستدعي انزياحاً مقابلاً لها على مستوى المدونة المالكية([51]).
ولا ننسى أن ارتباط المشروع المرابطي بشبكة من الفقهاء المالكيين قد جعل الخطاب السياسي للحركة يتخذ وجهته المالكية منذ اللحظة الأولى، ناهيك عن أن قيام الدولة المرابطية قد مكن للمذهب المالكي بين “الرعية” بل وبين أهل الحكم أنفسهم. وتوقر هذا الأفق السياسي والإيديولوجي الداعم للمذهب المالكي يمكن فهمه بالاستئناس بقول لابن حزم([52]) مفاده أن مذهبين انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان وهما مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك بن أنس، ويتأكد تلازم السياسي الديني في المجال السلطوي المرابطي وارتباط صحراء الملثمين بهما، من مراجعة فتويتن وردتا في “المعيار المغرب..”، كبراهما([53]) للفقيه ابن رشد([54])، والصغرى([55]) للفقيه ابن حمدين([56])، وكلتاهما إجابة عن استفتائين وردا من مرابطي الصحراء بشأن الأموال المختلطة وكلها من المواشي التي خاطها المال المغصوب الناتج عن عملية السلب والنهب التي ظلت بعض قبائل المنطقة تعرفها، ربما قبل بدء أمر المرابطين، ومهما كان الطابع الفقهي للأسئلة وطبيعة الردود وملابساتها، فإن توجيهها إلى هذين الفقيهين يدل على نوع ما من الارتباط بالوجه الرسمي للمذهب المالكي، إذ إن المعنيين كانا من كبار قضاة الحكم المرابطي، فابن حمدين كان من أبرز متزعمي عملية الإحراق المشهورة لكتاب “الإحياء” لأبي حامد الغزالي([57])، أي أنه كان يتبنى علناً خطاب الدولة وعنه ينافح، أما ابن رشد فقد ظل من كبار فقهاء الحكم المرابطي، رغم أنه كان من الذين وقفوا من عملية “الإحراق” موقفاً صامتاً يفهم أنه كان “للإحياء” أكثر مما قد يكون عليه([58])، إلا أنه ظل يحترم الشرعية المرابطية ويذكر رموزها بالتعظيم([59]).
وإلى جانب هذا التعلق الصحراوي بالمذهب الرسمي للدولة و”ممثليه” لدى مركز الحكم، ترد إشارات هامة ضمن فتوى ابن رشد تؤكد حضور الوجه الآخر لعملية التعلق نفسه، وهو الوجه السياسي، فالفتوى الرشدية تشير إلى أن «الأموال المختلطة المشار إليها كانت تقدم منها الهدايا لأمير المسلمين ناصر الدين»([60])، وهو لقب أمراء المرابطين منذ عهد يوسف بن تاشفين (480-500 ﻫ/ 1087-1106)([61])، ناهيك عن أنها تصرح كذلك بوجود أمير مولي على الصحراء وقبائلها من قبل أمير المسلمين نفسه، الأمر الذي يؤكد أن المنطقة ظلت على تبعيتها القوية للسلطة المرابطية في مراكش، وجهازها الإيديولوجي المرابطي، على الأقل حتى عهد علي بن يوسف بن تاشفين (500-537 ﻫ/ 1102-1142)، ومن هنا يمكن تفسير الأسماء التي ترد في نصوص غميسة عن أمراء صنهاجيين في الصحراء بأنها تعني الولاة المعنيين من قبل الحكم، في مراكش على المنطقة([62])، ومن نفس السياق يمكن فهم نفس الأصداء التي تتردد ضمن الروايات المحلية المدونة في موريتانيا اليوم([63]). أما الفضاء الإيديولوجي المرابطي فلربما ظل موجوداً في الصحراء بحكم بقاء الحكم المالكي مسيطراً فيها، ثم بحكم التقليد الذي يذكر البكري أنه استمر بين الصنهاجيين، والذي يقضي بأنهم كانوا لا يقدمون للإمامة إلا من صلى خلف ابن ياسين([64]).
ومهما كان دور هذه الملابسات في إبقاء المذهب المالكي الإطار الأمثل لإسلام الصحراويين وعلاقتهم بالمرابطين، فإن مستويات التلقي المعرفي وخصوصيات التلقي تظل هي الأساس في ترسيخ المالكية بين “طبقة الفقهاء المرابطين”، التي احتضنت منظري الحركة المرابطية ودعاتها الذين بعثوا المشروع التوحيدي المرابطي والمذهب المالكي في الصحراء.
طبقة فقهاء المرابطين
إن المتفحص لكتب التراجم يلاحظ اندراج أبي عمران الفاسي([65]) وتلاميذه ومن تخرجوا عليهم معاصري هؤلاء ضمن طبقة من الفقهاء موزعة على مجالات مدينية قبلية وساهمت بدرجة أو بأخرى في التهيئة للمشروع المرابطي ثم في إنجاحه فيما بعد.
دراساته في فاس: رغم أن هذه المدينة كانت قد عرفت فئة من علماء المالكية المتمكنين أمثال أبي ميمونة دراس بن إسماعيل (ت. 375 ﻫ/ 968 م) والذي كان قد دخل الأندلس على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر فرابط في ثغورها وهو لا يزال يطلب العلم([66])، ومن طبقته يرد اسم موسى بن يحيى الصدين (ت. 388 ﻫ) وأصله من فاس، وكان «كبير فقهاء بلده وشيخهم الشهير بوقته وبعده..»([67]). ورغم أن هذه الأسماء قد مهدت للمالكية في فاس، إلا أنها لا تنتمي للطبقة المعينة، لكن هناك جملة أسماء أخرى عاصرت الفاسي فاندرجت بذلك في سلك المالكية الممهدة للحركة المرابطية، بحكم الروابط التي جمعتها مع فقهاء اتصلوا بأبي عمران بطريق مباشر أو من وجوه معرفية غير مباشرة كالأسانيد وما شاكلها. ومن أبرز هذه الطبقة ترد الأسماء الآتية:
– هناك الفقيه عثمان بن مالك و«زعيم فقهاء المغرب بوقته»، والمرجح أن أبا عمران قد درس على ابن مالك هذا، لأنه توفي سنة (444 ﻫ) ولأن فقهاء فاس قد أخذوا عنه على ما يذكر صاحب “المدارك”([68]).
وقبل أن يرحل أبو عمران إلى القيروان أخذ عنه في فاس وجاج بن زلوه اللمطي (ت. 445 ﻫ)([69]) وعلى هذا الأخير تتلمذ فقهاء جزولة.
– جزوليون: من أشهر هؤلاء عبد الله بن ياسين الجزولي (ت. 451 ﻫ) وقد ولد في بلاد جزولة، بقرية تمنارت([70])، وقد أعمل الرحلة في شبابه إلى الأندلس وبها مكث سبع سنين «فحصل علوماً كثيرة، ثم عاد أدراجه ليدرس على شيخه وجاج في إطار المرابطين»([71]). وهناك الأخوان الجزوليان اللذان تتلمذا على وجاج أيضاً، وعاصرا ابن ياسين ولعلهما شاركا في الحركة المرابطية قبل وبعد وفاته، والمعنيان هما أبو القاسم وسليمان ابنا عذرا (عدو) الجزوليان والأول منهما كان من أصحاب وجاج بن زلوه اللمطي الفقيه «حسب القاضي عياض»([72]). أما الثاني فهو القائم بأمر المرابطين بعد عبد الله بن ياسين لكنه لم يمكث على رأس الحركة طويلاً إذ توفي سنة (452 ﻫ)([73]).
– من المصامدة: من غير الجزوليين يرد اسم أيوب بن محمد([74]) الذي كان فقيه المصامدة لعهده، ووصف بأنه من أهل العلم، ويبدو أنه أعمل الرحلة إلى المشرق حيث لقي أبا عمران وغيره من شيوخ القرويين [القيروانيين]، حيث كان القيروان محطة تقليدية لطلاب الأندلس والمغرب المتجهين صوب المشرق([75]) من هذه الطبقة من المصامدة أيضاً، يعرف تومارت بن تيدي([76]) ووصف بأنه من الفقهاء الفضلاء ولعله أخذ عنه أبي عمران أو عن أحد تلاميذه، وذلك بحكم كون مفهوم الطبقة قد لا يعني مجرد التزامن بين انسحاب التراجم بل إن مشموله قد ينسحب على التقاليد العلمية ممثلة في الأسانيد أو التلمذة أو هذا بأجمعه([77]).
– من صنهاجة الصحراء: لا تنسب المصادر إليهم من هذه الطبقة غير المسمى لمتاد بن نفير اللمتوني الذي كان من العباد الفقهاء المعروفين بين قبيلته، كما كان “المثل يضرب بفتياه” في بلاد الصحراء وتعظيم أمرها([78]). والمفهوم أنه كانت للمتاد هذا صلة بمدرسة أبي عمران أو بوجاج نفسه، وإلا لعارض ابن ياسين عندما حل ببني لمتونة([79])، فضلاً عن أنه هو الذي أفتى بقتل زعيم المغراويين في سجلماسة، جزاء قدره بالمرابطين، إذ لا يمكن أن يصدر هذه الفتوى، وفي عهد الحركة الأولى وعلى مسمع ومرأى من ابن ياسين، إلا فقيه ذو شأن علمي مكين تعضده صلة وطيدة، أيّاً كان شكلها، بفقيه الحركة أو بشيوخه.
– أغماتيون: من تلاميذ الفاسي تذكر المصادر كلاًّ من عبد العزيز والتونسي الزاهد ومحمد بن صدين المتوفيين في سنة (486 ﻫ/ 1093 م) في أغمات، ولعلهما عرفا في نفس المدينة قاضي المرابطين بازكي المتكلم محمد بن الحسن الحضرمي (ت. 489 ﻫ) والذي وصل إلى أغمات قادماً من القيروان([80]). وهنا ينبغي التساؤل عن طبيعة هذا لحضور المتزامن نسبياً بين المعنيين الذين للفاسي، إلا أن القدوم من نفس الوجهة وفي فترة زمنية لم يكن الفاسي قد توفي فيها([81])، أمور يمكن أن تؤكد وجود هذه التلمذة ومع ذلك فإن سند الحضرمي يبقى مشرقياً في معظمه باستثناء الأديب المغربي المعروف بالقصديري([82]). ومهما يكن من أمر فإننا نحسب تعثر أمر الحضرمي الذي تشير إليه المصادر، ربما كان راجعاً إلى الزاد العلمي العقدي الذي جاء به هذا المتكلم إلى المغرب في محيط مالكي يحمل إزاء هذا الجانب من المعرفة موقفاً أسلفنا إليه الإشارة، إلا وقد ابتغى إليها الوسيلة([83])، كما أن المصادر تشير إلى حضوره في سجلماسة ربما على عهد حكامها الزناتيين([84])، فهل يعني ذلك الترحال الدائب إلى أرباب السلطان، عملية بحث عن أفق سياسي يمكن لمشروع سياسي كان الحضرمي يحمله، إننا نعتقد أن الأمر كذلك وأن هذا المشروع قد يكون ذا صلة بآراء الفاسي الذي نشر تلاميذه في الغرب ومهد المرابطين، أو يكون الحضرمي متأثراً بمناخ المد السني الذي ساد المشرق منذ القرن الرابع ومعظم القرن الخامس الهجريين.
وعلى العموم فإن ما يهمنا من هذه الأسماء هو ما لاحظناه من روابط علمية جمعت بينها، كما أن المعنيين كانوا ينتسبون إلى جل القبائل والمجالات التي ساندت حركة المرابطين في زحفها نحو الشمال فضلاً عن أن ابن ياسين كان مندرجاً في سلك المعنيين كما كان قد خبر أمور قبائلهم وجاس خلال ديارهم قبل الدعوة المرابطية وبعدها فهل كانت طبقة الفقهاء تلك هي الإطار المذهبي الأوسع الذي أفرز شبكة فقهاء المشروع المرابطي؟ وكيف تَمّ ذلك وما هي ملابساته؟ وإلى أي حد كانت آراء المعنيين حاضرة في المشروع التوحيدي الذي حبكه تلميذهم المحنك ابن ياسين؟.
إننا نعتقد أن مشروع الحركة المرابطية تبلورت في ذهن ابن ياسين على مراحل وارتبط بقوة بتجارب الدعوة والجهاد التي قادها قبل وجاج وأبو عمران حيث تسربت آراء هؤلاء إلى “برنامج” الحركة المرابطية وأهدافها. فكيف تبلورت هذه “البرامج الجزئية”؟ وكيف تداخلت مجتمعة في ذهن ابن ياسين مع “برنامجه الخاص”.
1 – أبو عمران ومواجهة “المظالم” الزناتية
لقد عرف عهد أبي عمران الفاسي استقلال بني مغراوة الزناتيين عن الأمويين سنة 390 ﻫ/ 1000 م وبسطهم تدريجياً سيطرتهم بدءاً من فاس حتى سجلماسة وأغمات وتامدولت، وقد تَمّ ذلك في ظل صراعات مستمرة وفوضى سائدة جعلت الحياة اليومية لا تطاق وحالت دون أي نشاط اقتصادي طبيعي في عهعد الزناتيين([85])، ويبدو أن شيئاً ما في هذه الوضعية العامة قد استفز أبا عمران الفاسي، وربما أيضاً بعض فقهاء المنطقة، ودفعهم إلى التنديد بها وعارضتها علنياً، خصوصاً وأن الزناتيين لم كونوا خصوماً من الوجهة الدينية بحكم كونهم من أهل السنة في ذلك الوقت، بل أن منهم من كان مولع بجهاد برغواطة (…) يغزوهم في كل سنة مرتين فيقتل منهم ويسبي([86])، كما أن الأمراء الذين ثاروا على رعيتهم بشكل حاد وفظيع لم يكونوا هم المعاصرين للفاسي، إذ تولوا الإمارة بعد وفاته بعقدين على الأقل([87]). فما هي هذه الوضعية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في عهد الفاسي ودفعه إلى الصدام مع حكام فاس؟ إننا نعتقد أن سلسلة المجاعات التي بدأت من سنة 380 ﻫ واستمرت إلى 462 ﻫ، هي التي جعلت الزناتيين ينتهكون حقوق رعاياهم ويستطيلون على أموالهم بشكل دفع الفاسي إلى إعلان الثورة ضدهم بدعوته إلى تغيير منكر (المظالم) وأمره بمعروف رد (الحقوق) إلى أصحابها ومن هنا اكتسبت دعوته منذ البداية طابعها السياسي فكيف تَمّ ذلك؟ إن المصادر لا تذكر سبباً لرحلة الفاسي إلى القيروان وحلوله بين فقهائها، سوى أنه رحل إلى المدينة ليتفقه بأبي الحسن القابسي (3-404 ﻫ)([88]). لكن صاحب “بيوتات فاس” يمدنا برواية جديدة تفصح عن السبب الذي أزعج أبا عمران في موطنه الأصلي ودفعه إلى الهجرة عنه نهائياً وقطب الرواية يدور حول معارضة الفقيه قيام أهل قياس بإحداه «البدع والمظالم والمغارم وأخذهم أموال الناس بغير حق»([89]). وقد اتخذ هذا النهي بالطبع طريقة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبسبب ذلك أخرجه من فاس الطغاة من أهلها العاملين بمغراوة.. حيث أعانوا على ذلك ولاة أمورهم من بني العافية المكناسيين ومغراوة وبني يفرن وكلهم من زناتة من البربر حيث ولوا من ولوا [كذا في الأصل] من على مدينة فاس بعد الأدارسة من الظلم والجور ما لم يسمع بمثله…»([90]). ومن هناك فإن دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرف الفاسي كانت تتعلق بالتصدي للحكام الزناتيين ومظالمهم وما أحدثوه من المظالم وهذا البعد كان حاضراً وبجلاء ضمن “برنامج” حركة المرابطين ولذلك فإن البكري الذي عاصر بدء أمر الحركة بالمغرب قد عرف القبائل المرابطية من الصحراء بأنها «هي التي قامت بعد الأربعين والأربعمائة بدعوة الحق ورد المظالم وقطع المغارم»([91]) الأمر الذي يؤكد الروابط الوثيقة بين آراء الفقهاء المعنيين بالحركة المرابطية منذ أن كانت مشروعاً إلى أن أضحت حركة فدولة ومن هنا لا يمكن التعويل على الرأي القائل([92]) بأن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرف أبي عمران هو ذلك التقليد الذي تلقاه عن شيخه القادسي والقاضي بالنهي عن اجتماع أهل الزهد والعبادة الذي كانوا يجمعون بين قراءة القرآن وحكاية قصص الصالحين وإنشاد الشعر وهي حلقات كرسها أو تغاضى عنها المغراويون من حكام فاس الذي كانوا يحاربون غيرها من التجمعات التي ربما مثلت خطراً على سلطتهم وإنما كانوا يسمحون بإنشاء الرابطات بغية الجهاد ضد النحلة البرغواطية ولو كان طابع دعوة الفاسي بهذا الشكل من المهادنة لما ظهر من خطاب لزعيم صنهاجة، الذي مر به قادماً من المشرق حرصه على التأكيد بضرورة قلب الأوضاع الصنهاجية من خلال ثورة إصلاحية لا تخلو من العنف. وهو ما يتضح من استبيان المحادثة التي جرت بين الفقيه القيرواني والأمير الصحراوي وذلك بالتشديد على جمل منها بعينها تحمل مضامين لا تخلو من نفس سياسي.
فالسؤال عن بلد الكدالي وسيرته وما ينتحله قومه من المذاهب([93]) يبدو سعياً من الفاسي للتأكد من خصوصية حقل الدعوة المرتقبة من حيث خلوه من الدوائر المذهبية والنّزعات المناوئة للمذهب المالكي وبذا فإنه عندما تأكد من ذلك صرح أن الأمير الصحراوي كان «صحيح النية واليقين»([94]) أي لا صلة له بآراء الفرق المبتدعة أو غيرها من الدوائر ذات الخطاب السياسي الذي يعارضه الفاسي وأضرابه من فقهاء الغرب الإسلامي، ومن هنا كان أبو عمران منتظراً من محاوره بسط القول في معوقات القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ([95]) أي الثورة على الأوضاع السياسية والاقتصادية المهترئة أو جمع شمل قبائل صنهاجة المتحدة وقتها في حلف قوي يقود الكدالي نفسه، من أجل تحقيق مطالب الفاسي وتلاميذه بالمغرب الأقصى وكان تعليل أمير صنهاجة لأسباب عجز قومه عن القيام بالدعوة المطلوبة لضعف صلاتهم في الصحراء بمنابع الإسلام السني فلم يكن يصل إليهم «إلا معلمون لا ورع لهم ولا علم بالسنة»([96])، ولا يعني هذا النفي أن القادمين كانت بضاعتهم من العلم مزجاة، بقدر ما هو تأكيد على أن هؤلاء المعلمين ليسوا مالكيين أو غير سنيين حسب معايير الفاسي كما قد يعني الخطاب أن المعنيين ليسوا من أهل الدعوة والنهوض بأمورها بل هم ممن لا ورع له أو مدار حرفته على المتاجرة حصراً([97]).
إن قراءتنا للألفاظ ومراميها في خطاب أبي عمران لشيخ صنهاجة ليست مجرد تمحل، بل هو تأكيد منا على أن مدلولها ينبئ عن مشروع جهادي إصلاحي كان أبو عمران يسعى إلى تحقيقه وهو ما تصرح به رواية “بيوتات فاس” بقولها «إن الفقيه الفاسي قد ندب الزعيم الصنهاجي إلى قتال برغواطة ببلاد السوس وقتال زناتة على ما صدر منهم من الظلم واستنْزال رأسائهم من الولاية»([98])، أي مواجهة التفكك المذهبي في المنطقة وتصحيح الأوضاع التي بسببها خرج الفاسي من موطنه مكرهاً، ونظراً لبعد الفاسي عن حقل التغيير فقد أحال الأمير الصحراوي إلى وجاج ابن زلوه اللمطي ليجد عنده بغيته، حيث كان اللمطي من أصحاب الرباطات المقامة للجهاد والتعليم فضلاً عن أنه كان تلميذاً للفاسي وأحد أبرز فقهاء المرابطين فكيف أسهم في بلورة “مساهمته” في الحركة المرابطية؟
2 – اللمطي ومواجهة التفكك المذهبي
انتمى وجاج قبل تلمذته للفاسي إلى نظام للمرابطة أسسه فقيه أغماتي يدي ابن تيسيت ولعل ذلك قد ترك في نفسه أثراً قوياً، فقد جاء في كتاب “القبلة” (مخطوط بالرباط) عند الحديث عن المساجد العتيقة أغمات ذكر «المساجد التي بنتها تلامذة أبي محمد بن عبد الله بن تيسيت لأنهم جعلهم الله سبباً لإطفاء فتنة برغواطة الذين قاموا بالمغرب سنة ثلاث مائة..»([99]). وتستطرد الرواية في القول إن تلاميذ هذا الفقيه الأغماتي قد أخذوا يقاتلون الكفار ولعله لم يحبذ أن تكون الأعمال انتحارية، وهو ما يتبين من تشاور التلاميذة مع شيخهم بشأن مجاهدة البرغواطيين([100]) حيث كانت إجابة الشيخ قصيرة: إن كانت لكم بهم مقدرة فجاهدوهم([101]).«ورغم ما يحمله هذا الجواب من شك في فترات هؤلاء المتحمسين إلا أن الشيخ قد انتدب للجهاد ثلاثة من تلاميذه منهم داوود بن يهلل الصنهاجي ويحيى بن ويدفا ويعلي بن مصلين وذلك حسب كثرة قبائل الموجهين للمعركة»([102]). ويذكر عن المنتدب اللثالث يعلي بن مصلين أنه كان ثالث ثلاثة انتدبهم شيخهم أبو محمد تيسيت بأغمات لقتال برغواطة وهو الذي بنى مسجد رباط شاكر وكان ذلك قرابة المائة الرابعة للهجرة([103]).
أما وجاج بن زلوه اللمطي فيؤكد صاحب كتاب “القبلة” أنه كان من تلامذة ابن تيسيت بأغمات قبل قيام دولة المرابطين ومن طلبة هذا الشيخ الذين جاهدوا برغواطة والمعلوم أن وجاج كان إذاك في ريعان الشباب وربما توجه بعد انفراط عقد رباط الأغماتيين هذا إلى شيخه أبي عمران حيث درس عليه في فاس قبل أن يكر راجعاً صوب السوس ليؤسس رباطه الخاص.
إن المهم من صلة وجاج لابن التيسيت هو أنه قد تلقى عنه تقاليد المرابطة والجهاد التي عمقتها المعارف المتلقاة عن الفقيه الفاسي مما جعل وجاجاً يؤسس رباطاً أكثر أهمية سماه “دار المرابطين”([104])، ولعل هذا التأسيس كان المرحلة الأكثر اكتمالاً لتقاليد المرابطة في بلاد المغرب، ومن هنا لم يقتصر الرباط الجديد على التعبئة للجهاد والمرابطة على تخوم أصحاب البدع بل إنه ركز على بث العلم ونشر الخير حرصاً على تحصين السكان وطلبة الرباط، أما نحل السوس ومذاهبه فكأن “دار المرابطين” أضحت المقابل “المغربي المالكي” “للمدرسة النظامية” التي أنشأها الحكم السلجوقي ومتكلمو الأشاعرة في المشرق بغية تكوين جبل من الدعاة السنيين القادرين على مواجهة أفكار الباطنية أو وأدها في المهد ومهما كانت دقة المقابلة بين المؤسستين، فإن “دار المرابطين” قد ركزت على نفس البرنامج الذي اتخذته “نظيرتها المشرقية”. فقد ركز عميد الدار على التهيئة الروحية بإخضاع الملتحقين بالرباط الجديد لنظام “حركي” خاص قوامه اعتياد شظف العيش والصرامة في السلوك والدقة في التعلم وهو أسلوب مكن خريجي دار المرابطين مثل ابن ياسين، من التعامل مع مجتمعات بدو الصحراء الذين يؤثر فيهم «بالسلوك والعمل لا باللسان والجدل» ولو لم تكن وظيفة دار المرابطين كذلك لما كان هناك داع لأن يستقر في رحابها داعية المرابطين والأول عبد الله بن ياسين بعد أن وصل من الأندلس وقد ملأ وطابه علماً ولو لم يكن الرباط الجديد قادراً على تخريج دعاة يقومون بأمر الدعوة المستهدفة لما قال أبو عمران لأمير صنهاجة محيلاً إياه إلى وجاج معرّفاً بهذا الأخير أني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيهاً حاذقاً تقياً ورعاً لقيني… وأخذ مني علماً كثيراً وعرفت ذلك منه([105])، وأسلوب الثقة هذا واضح من تقديم ابن ياسين إلى أمير صنهاجة من قبل عميد دار المرابطين، وهي ثقة تظل مبنية على ما يعرفه المعنيون عن بعضهم البعض من الهم الإصلاحي المشترك ومن قضايا الجهاد والمرابطة التي تبلورت مجتمعة على مراحل لتتضح في ذهن ابن ياسين مشروعاً إصلاحياً توحيدياً يقوض أركان النّزعة الإقليمية التي اجتاحت المنطقة وهددت أمان ومصادر عيش السكان.
3 – ابن ياسين ومواجهة التفكك السياسي
أنجز ابن ياسين بدعوته بين صنهاجة الصحراء مشروعاً توحيدياً شمل قبل وفاة مؤسسه جل مناطق المغرب وحمل برامج شيوخ ابن ياسين الذين انتدبوه للدعوة.
لكن المتمعن في عملية التوحيد تلك يلاحظ ارتباطها بمجالات قبيلة معروفة كان ابن ياسين قد خبر أحوالها أيام كان مسافراً، وإليها ينتمي جل “أعلام طبقة فقهاء المرابطين”، مما يعني التساؤل عما إذا كان صنهاجة الصحراء أداة الإنجاز لمشروع لم يكونوا على علم بتفاصيله التي اتفق هذا الداعية مع قبائل الشمال على تنفيذها؟
إننا نحسب أن الأمر كان كذلك ولكن هموم الملثمين الصحراوية قد تسربت إلى إبعاد المشروع التي تبلورت في ذهن صاحبها على مراحل. غير أن هذا التسرب لم يمنع المشروع التوحيدي من أن يستمر في اتجاه مراميه النهائية، فقد انتدب ابن ياسين للدعوة في الصحراء وهو إذاك مقيم مع عميد دار المرابطين([106])، ووجد في حقل الدعوة الجديدة الأداة الضرورية لإنجاز الدعوة مشروعه الأصلي معاً ويبدو أن إحساس ابن ياسين بضرورة مواجهة وضعية التفكك في الأندلس والمغرب وهو مشروعه الأول كان قد تبلور بعد رحلته إلى الأندلس التي دخلها في عهد ملوك الطوائف([107])، وهي فترة عرفت قمة تفكك مسلمي الأندلس وفي وقت استأسد عليهم الإفرنج في بداية الهجمات التي عرف بحرب الاسترداد (Rconquista) ناهيك عن أنه قد أمضى في الأندلس مدة سبع سنوات كانت كافية ليلمس بدقة درجة ضعف المسلمين وتخاذلهم أمام الأعداء وليعود مفعماً بالحماس من أجل الدعوة لوحدة الجهاد، ولكن هل تأثر ابن ياسين بآراء فقهاء الأندلس ممن يحملون نفس الهموم التوحيدية؟ إن المصادر لا تتحدث عن مثل هذه الصلة، غير أن ابن ياسين قد يكون ربط لبعض الوقت على ثغور الأندلس اتباعاً لسنة المرابطة ودفاعاً عن دار الإسلام، وربما جرياً على تقليد عرف عن بعض علماء المغرب، قبل ذلك، ممن رحلوا إلى الأندلس مثل دراس بن إسماعيل([108]). ومهما يكن فإن المرحلة الأندلسية من حياة ابن ياسين هي التي أذكت في وعيه ضرورة توحيد صفوف مسلمي المنطقة. ولو لم يكن الأمر كذلك لما تتبع هذا الداعية مجالات قبائل المغرب لحث هذه الأخيرة على الوحدة والتكاثف، أو حتى للجهاد على أساس من مشروع توحيدي محدد. ففي طريق عودته من الأندلس، مر ابن ياسين ببلاد “تامسنا” فلمس قوة سيطرة برغواطة على المنطقة، ومدى تفرق أهل الإقليم تحت سلطتهم، ومن الواضح أنه لم يستفسر عن أحوال البرغواطيين لأنه اعتبرهم، بلا شك، أصحاب نحلة خارجة عن الإسلام، لا يتم إصلاحها إلا باجتثاثها بغزو مسلح لا هوادة فيه. لكنه اهتم بقبائل الغزو المسلمة المجاورة لهذه النحلة وهو استفسار اعتبره بعض الإخباريين من باب «الإلهام»([109])، وهو نعت قد يعني أن الاستفسار كان في محله، كما أن اللفظ يعني أن هذا الداعية في طرحه الأسئلة عن الوحدة والانسجام لم يكن على وعي مسبق بها أو اعتناق بها عميق. غير أننا نحسب ابن ياسين كان على بينة من أمره، وآية ذلك دعوته التوحيدية للمصامدة ومحاورته لشيوخهم في ذات الشأن. فعندما مر ببلادهم طرح عليهم جملة من الأسئلة المترابطة التي تقودهم، من باب الفهم، على الاقتناع بضرورة رص صفوفهم إتباعاً لأوامر الشرع القويم، فقد سألهم عن مدى التزامهم بالإسلام، وهو يعلم أنه كذلك فعلاً، فأجابوا أنهم باقون على الإسلام الصحيح، لكنه أبدى استغرابه لغياب سلطة يقودها إمام طبقاً للمعايير المعمول بها شرعاً ([110])، غير أنه لم يكن يعلم أن المجموعة المصمودية كانت تعيش تنامياً عميقاً للنّزعة الإقليمية، جعل كل فئات المجموعة ترفض الانقياد لطاعة أي قائد ينتمي للمجموعة الأخرى. ومن هنا كانت الإجابة عن أسئلة ابن ياسين «بأن قال له بعض أشياخ المصامدة لا يرضى أحد منا أن ينقاد إلى حكم أحد من غير قبيلته»([111]) مما جعل الداعية «يرحل عنهم إلى بلاد جزولة»([112]) أي إلى بلاده هو نفسه، حيث كان الجزوليون يعيشون وضعية لا يبدو أنها أقل سوء من حيث التفكك والصراع القبلي وهو ما لا تصرح به المصادر الموجودة لكن صمتها لا يشير إلى عكسه، فلو كان الوضع مختلفاً لألقى ابن ياسين عصى التسيار بين قومه بني جزولة وعبأهم من أجل تحقيق مشروعه. إلا أن الملاحظ على عملية دعوة الداعية من الأندلس هو هذا الترحال الذائب بين تلك المجالات القبلية، وابتعاد ابن ياسين في خط سيره عن ديار نحلة برغواطة ربما اتقاءاً لشرها، بينما شق طريقه عبر ديار المصامدة والجزوليين. وبغض النظر عن الظرفية والعوامل التي حددت خط السير هذا، فإن التساؤل وارد عما إذا كان ابن ياسين في مروره بتلك القبائل كان باحثاً عن مجتمع قبلي يعيش حداً أدنى من الانسجام الاجتماعي والسياسي يصلح به لأن يحتضن المشروع التوحيدي المستهدف؟
إننا نعتقد أن الأمر كذلك، ولذا فإن ابن ياسين عندما لم يجد بغيته بين تلك المجالات القبلية، اتجه صوب “دار المرابطين” ليحل قرب شيخه وجاج ربما انتظاراً لفرصة كانت تلوح في الأفق([113])، ذلك لأن هذا الرباط الكبير كان قريباً من المناطق التي ظلت تمثل المجال الرعوي المفضل لبعض صنهاجة الصحراء قبل أن يزعجها عنه الزناتيون([114])، وهذا القرب النسبي جعل أخبار الصحراء والمغرب تسير في اتجاه كلتا المنطقتين، وهو ما نبه إليه صاحب “بيوتات فاس”([115]) بإشارته إلى أن وفد صنهاجة الذي مر بالقيروان، جاء ليتبرك بأبي عمران الفاسي بعد أن سمع بنفي الفقيه من موطنه الأصلي. ولا يبدو أن الوفد الصنهاجي قد بلغته هذه الأخبار وهو في طريقه إلى الحج لأن الفاسي كان في عهد رحلة المعنيين قد استقر بالقيروان، منذ عهد طويل نسبياً. وإذا تركنا جانباً طابع التبرك بفقيه مالكي ورع، وهو أمر مفهوم بالنسبة لمسلمي المنطقة، فإن أخبار “النفي” قد تكون تسربت إلى الصحراء من خلال القوافل التي تمر بالمنطقة على مدار العام.
ثم إن انسياب الأخبار بالموثوقية التي يزكيها منطق الأحداث، هو الدافع، في نظرنا، الذي حفز ابن ياسين إلى المسير صحبة أمير صنهاجة، خصوصاً بعدما عرف أخبار هذا الأمير وأوضاع قومه من وجاج أو من الأمير نفسه، إذ لا يمكن أن يقتحم ابن ياسين مجهول الصحراء إلا بعد أن يتأكد من أهمية الحلف الصنهاجي الذي ينتظره، خصوصاً وأن صنهاجة وقتها كانوا فعلاً يمثلون حلفاً قبلياً منسجماً مما يمثل الأداة الضرورية التي يبحث عنها ابن ياسين لإنجاز مشروعه([116]). ومع ذلك فإن ابن ياسين عندما أنجز دعوة المرابطين في الصحراء لاحظ مدى جدية بعض قبائل الدعوة لمشروع كلمتونة «فأراد أن يملكهم المغرب»([117]) فاتجه بهم صوب سهول السوس متقدماً نحو الشمال دون أن يمنعه موعود التمليك الذي يربطه بالمعنيين عن هدفه الأصلي القاضي بتوحيد المغرب فكيف كان ذلك؟
وقد لفتت انتباهنا تلك الصلة الواضحة بين عبد الله بن ياسين والمصامدة وقادتهم لكن الروايات التي تتحدث عن هذه الصلة لا توضح بما فيه الكفاية نوعية المتصلين بابن ياسين أي أنها لا تميز بين المصامدة في مفهومهم الخاص كقبيل متميز وبين الحلف المصمودي وقادته كفضاء بشري وإيديولوجي ينتظم جل طبقة فقهاء المرابطين وقبائلهم، ولكي يرتفع هذا اللبس سنقوم بالفصل إجرائياً بين المجالين المشار إليهما ثم نسعى لعرض صلة ابن ياسين بكل منهما على حدة.
المجال المصمودي العام
بعد وصول ابن ياسين إلى الصحراء يردد مجدداً أول ذكر لاتصاله بهذا الحلف القبلي وفقهائه، فبعدما استطاع المرابطون بمعارك طاحنة أن يجتثوا النحلة التي كانت تسيطر على جبل آدرار شمال موريتانيا الحالية فإن ابن ياسين استولى على أسلاب المقتولين في ذلك الغزو وجعلها فيئاً للمرابطين وبعث بمال عظيم مما اجتمع عنده من الزكاة والأعشار والأخماس إلى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها([118])، وإلى جانب أهمية هذه الغنائم بوصفها كانت أول فيء قسمه المرابطون في صحرائهم([119]) فإن الرواية تصرح بأن الطلبة والقضاة المشار إليهم هم من بلاد المصامدة وليسو من قبيل المصامدة حصراً، هذا إذا كان للإسم الأخير من دلالة خاصة. فهل أرسل ابن ياسين تلك “الهدايا” إلى المعنيين بوصفهم طرفاً في المشروع أي أنه اعتبرهم شركاء في أمر “دعوة الحق؟” ومن هم هؤلاء الطلبة والقضاة وما صلتهم ببلاد المصامدة؟ إننا إذا قصرنا لفظ المصامدة على قبيل بعينه فإنه يصبح من غير المفهوم أن يضرب ابن ياسين صفحاً عن مواصلة شيخه وجاج، الذي هو لمطي وليس مصمودياً، فضلاً عن طلبة هذا الأخير وهم من مختلف القبائل ومن بينها جزولة قبيلة ابن ياسين نفسه. لكن الإجمال وغياب التفصيل الذي نلمسه في الرواية يصبح مفهوماً عندما نتذكر أن مجموع المصامدة ينسحب على قبائل عديدة منها لمطة قبيلة وجاج بن زلوه نفسه([120])، ناهيك عن صلة هذا الفقيه اللمطي بالمصامدة الذين كانوا يتبركون به وإليه يفزعون لطلب الدعاء إذا ما نزل القحط بمرابعهم([121]). ومن هنا تكون عملية توجيه الأموال المذكورة قد تمت بإرسالها إلى وجاج نفسه وإلى من حوله من طلبة القبائل الداخلة في الحلف المصمودي، إضافة إلى أنهم زملاء ابن ياسين في رباط السوس قبل بدء أمر الدعوة ثم إن شمولية اللفظ تلك هي ما يفسر مرور ابن ياسين عندما كان يوجه جيوش المرابطين في المغرب بمختلف القبائل التي تنتمي للحلف المصمودي وهي نفسها التي سبق له أن مر بها وهو عائد من الأندلس ومن بينها قبيل مصمودة “الأصلي” وعندما رجعت جيوش المرابطين بقيادة أبي بكر بن عمر إلى سجلماسة اتجه ابن ياسين إلى القبائل التي كان قد مر بها سابقاً قبل الدعوة، لأن هذه المجموعة القبلية كانت جزءاً من الحلف المصمودي الواسع([122]). كما كان لابن ياسين، فيما مر بنا، سابق عهد في الاتصال بها وإلا لما استطاع أن يجوس خلال ديارها منفرداً وأن يدعوها للالتحلاق بدعوته، أما المصامدة “الأصليون” فهم في سياق آخر يردون في «صفة قبائل المصامدة وقبائل بلاد تامسنا»([123])، وهي مجموعات عاد ابن ياسين إليها فاتحاً ومبشراً بالوحدة بعد أن تذكر كما تقول الرواية ما كان قد تركها عليه من فرقة وشتات، ولذا فإنه عندما اجتمع بهذه القبائل وجدها ترزح تحت الوطأة المأساوية نفسها فجدد لها التأكيد على أن حروبها جاهلية([124]). حسب معيار الشرع الإسلامي وكان رد القبائل المعنية أن تعللت بعامل التحاسد العصبي المستشري بينها([125])، غير أن الداعية وقد ترك وراءه جيوش المرابطين قد أصبح قادراً على دعوة المعنيين إلى مشروع ملموس ولذلك فإنه عرض عليهم الالتحاق بصفوف الحركة وبين لهم مزاياها وورع قادتها وقد قبلوا منه ذلك فكان أن رجع إلى أبي بكر بن عمر ليبشره بفتح بلاد المصامدة صلحاً([126]). وهكذا استطاع ابن ياسين أن يحقق المشروع الذي تبلور في ذهنه قبل الدعوة المرابطية وهو مشروع سياسي توحيدي ولم يكن أبداً مجرد انتداب من هذا الفقيه للدعوة في الصحراء من أجل إصلاح أمور صنهاجة وحدهم، وما كان له أن يوفق في ذلك لولا ما خبره من أمور القبائل التي شكلت مجالاتها المسرح التقليدي لعمليات الجيوش المرابطية القادمة من الجنوب وهو ما يفسر كون ابن ياسين قد توفي سنة (451 ﻫ) وفي عهد مبكر من الحركة التي قادها، بعد أن تقدم في بلاد برغواطة، التي لم يكن له علم بأخبارها فأطبق عليه البرغواطيون واستشهد قبل أن يرى بعينيه نتيجة هذه المعركة الجهادية الحاسمة. ولعل هذا كان هو الخطأ “الاستراتيجي” الوحيد الطي ارتكبه هذا الداعية الفذ بعدما استطاع النجاح في مشروع التوحيدي الذي حبكه بعناية، ولعل التساؤل يبقى وارداً عما إذا كان لمتونة أنفسهم بناء على انتماء فقيههم ابن نفير إلى طبقة الفقهاء المرابطين ينتمون هم أيضاً إلى الحلف المصمودي الذي ارتبطت به الدعوة المرابطية من خلال مشروع ابن ياسين؟ ذلك ما ينبغي بحثه واستجلاؤه.
مراجع
([1]) من أمثال هؤلاء: يوسف أشباخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، الترجمة العربية، القاهرة، 1958.
([2]) كالدراسة القيمة “حول المرابطين إبان ارتباط الحركة بالسودان، نشرت بالإنجليزية في مجلة IFAN، سنة 1968.
([3]) راجع: أ. دفيس هربك، المرابطون، ضمن المؤلف الجماعي: تاريخ إفريقيا العام، (المجلد الثالث، إشراف محمد الفاسي، اليونسكو، 1994)، ص. 371-402 حيث يؤكد دفيس أن هذه الدراسة تسعى إلى أخذ جميع جوانب الحركة في الاعتبار وتفسيرها تفسيراً جدلياً بوصفها عوامل مترابطة، لكنه يركز مع ذلك على الإطار السياسي والاقتصادي فحسب ولا يخص العوامل الدينية والفكرية إلا بالتفاتة خاطفة.
([4]) نعني بشكل خاص الملاحظات الهامة التي قدمها عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، 1994، ص. 111-116؛ وهناك دراسة حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، القاهرة، 1957 إلا أنها تشكو من ضعف منهجي واضح فضلاً عن تقادم العهد بها.
([5]) من أشهر هذه الحملات ما تحدث عنه أبو الخطاب الأسدي أو الأزدي (ت. 145 ﻫ/ 762 أو 147 ﻫ/ 764 م) فقد اقتبس في رواية من رواياته نقلها ابن الفقيه العبارة الآتية عن القائد العربي المشترى بن الأسود: «غزوْتُ بلاد أنبية عشرين غزوة من السوس الأقصى فرأيت النيل (عله نهر السنغال) بينه وبين الدجْو الأجاج كثيب..» وحسب ابن الفقيه فإن بلاد أنبية هي أرض صنهاجة الواقعة بين السوس وغانا أي تلك الممتدة عبر مسيرة 70 ليلة في سهول وصحراوات، مما يعني أن هذه الغزوات قد اخترقت هذه المنطقة في نظرنا بمحاذاة الساحل حتى مصب النهر، فلعلها خضدت شوكة قبائل كدالة التي كانت تنتشر في غرب موريتانيا على طول الشاطئ الأطلسي الحالي. وينبغي التساؤل عن أسباب ورود اسم أبي الخطاب هذا وعن علاقته بابن الأسود فأبو الخطاب هو محمد بن أبي زينب الأسدي ويعرف بمقلس الأجدع وكان من أصحاب جعفر الصادق، قبل أن يتبرأ منه الأخير لمغالاته فيه، وقد اكتسب أنصاراً لآرائه حتى بلغت فرقهم 50 كل منها تسمى الخطابية ولا يُعرف عن حياته =
= الأخرى سوى أن عيسى بن موسى والي الكوفة من قبل العباسيين قتله عام 143/ 760، راجع: (مادة: أبو الخطاب) في 2، 1 E وانظر الكشي، معرفة الرجال، بومباي، الهند 1317 ﻫ والنوبختي، فرق الشيعة، نشر H. Ritter، اسطنبول، 1921، أما المشترى ابن الأسود ويوجد اسمه بصيغ مختلفة في المخطوطات، فلا تشير المصادر إلى معلومات أخرى عنه لكننا نحسبه هو القائد المسمى المستنير بن الحرش الذي كان قائد للجيوش في عهد عبيد الله بن الحبحاب 116/ 724 و122/ 740 فلعله تولى قيادة الحملات على الصحراء والتي كانت تنطلق من السوس في عهد إسماعيل ابن عبد الله بن الحبحاب الذي تولى حكم ولاية السوس (سنة 116 ﻫ/ 734 م)، (راجع: ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، طبعة ليدن، د. ت، ص. 24؛ ليفيسكي T. Le Wiski، دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب ضمن تاريخ إفريقيا العام، صص. 342-343).
([6]) يعتقد ليفيسكي، مرجع سابق، ص. 343 أن الأنْبيتا هو اسم الاتحاد اللمتوني الذي كانت الحملات العربية موجهة ضده وذلك بناء على أن ملوك الاتحاد لم يكونوا قبل سنة 306 ﻫ وهي تاريخ تلاشيه، مسلمين أو حتى يرتبطون بديانة معينة، وهو ما أكده اليعقوبي في “البلدان”، طبعة ليدن، 1892،
ص. 360 حين تحدث عن بلاد أنبية وقاعدتهم غست، غسط (أوداغست) وأن لهم ملكاً لا دين له يغزو بلاد السودان.
أما محمد بن مولود بن داداه الشنافي (مقابلة معه بعين السلامة، 30 أكتوبر 1994) فيرى أن الأنبية تحريف للفظ الأنباط المعروفين اليوم في عداد إدوعيش بأصولهم الصنهاجية وأنهم في ذلك الوقت كانوا النبلاء ضمن قبيلة لمتونة فلعل الصحراء نسبت إليهم إبان قيادتهم للحلف المذكور.
كما يؤكد أن الإسلام لم يكن قد وصل إلى المنطقة بدليل غياب التعرب ضمن شجرات الأنساب، وهو ما سيبدو جلياً في أسماء أبي بكر بن عمر وغيره من القادة اللمتونيين في عهد الحركة المرابطية ومن هنا فلا عبرة بالتشابه الذي يبدو بين “نزار” في شجرة ملوك الاتحاد نفسه و”نزار” المعروف في الأنساب العربية لأن نزار الصنهاجي لا يزال يوجد اليوم في أسماء مجموعات صنهاجية بحتة.
([7]) راجع: أبو عبيد البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، نشر ج، دوسلان، الجزائر، 1757، والطبعة المصورة في القاهرة، 1992، خ. 175.
([8]) يتأكد ذلك من قول مالك حين سأله رجل عن أهل السنة من هم؟ فأجابه قائلاً: «هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا رافضي ولا قدري..»، (راجع: عباس الجراري، أسباب انتشار المذهب المالكي بالمغرب، ضمن ندوة الإمام مالك، وزارة الأوقاف المغربية، الرباط، 1980، ص. 177).
([9]) عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، نشر المركز الثقافي العربي، بيروت – الرباط، 1994، صص. 111-112.
([10]) يتضح ذلك من طريقة قيام الدولة الفاطمية في المغرب حيث اتصل الداعية الشيعي بركب حجيج كتامة، في موسم الحاج وبعد مقابلته اصطحبوه معهم إلى مرابعهم وفيها (رابط) في بلدة اكجان وانطلق منها مواجهاً للأغالبة. (راجع: فرحات الدشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994، ص. 81-84 وما بعدها.
([11]) العروي، المرجع السابق، ص. 112.
([12]) يتضح ذلك من إحالة أبي عمران للكدالي إلى وجاج بن زلوه اللمطي في أقصى المغرب. راجع: ابن أبي زرع، روض القرطاس بأخبار مراكش ومدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 1961، صص. 122-123.
([13]) العروي، المرجع الساق، ص. 112.
([14]) راجع: سالم يفوت، «الأشعرية بالمغرب»، مجلة الفكر العربي المعاصر، 1989، العدد 68-69، ص. 61.
([15]) سالم يفوت، المرجع السابق، ص. 62.
([16]) المرجع نفسه.
([17]) المرجع نفسه.
([18]) المرجع نفسه.
([19]) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي، عرف بابن الباقلاني (ت. 4-403 / 3-1012 م) متكلم سني سكن بغداد، وأصله من البصرة، كان أعرف الناس بعلم الكلام له التصانيف الكثيرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم وله المناقشات البارعة مع علماء النصرانية ألممنا بجوانب من ثلته بفقهاء الغرب الإسلامي، في مواطن عديدة من البحث راجع: (عياض السبتي، المدارك، تحقيق أحمد بكير محمود، دار الفكر، بيروت، 1967، ج 4، ص. 587-602؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، المكتبة السلفية، د. ت، د. م الترجمة رقم (2906)، ج 5، ص. 379؛ خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1989، ج 6، ص. 176).
([20]) عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، نشرة كاترمير، باريس، 1958، إعادة تصوير، مكتبة لبنان، 1992، ج 3، ص. 9.
([21]) عياض، المدارك، مصدر سابق، ج 4، ص. 587.
([22]) في أواخر القرن الرابع وصل دفق من تلامذة الباقلاني إلى القيروان وسعوا لبسط آراء الأشعرية في المنطقة، ومن هؤلاء أبو عبد الله الأذري وأبو طاهر البغدادي، إلا أن الأشعرية ظلت محدودة في الأوساط الثقافية القيروانية نظراً لضعف اهتمام فقهاء المدينة بها، رغم أن الأشعرية قد تسربت إلى مؤلفاتهم ودافعوا عنها بعض الأحيان مثل ما يذكر عن ابن زيد القيرواني (ت. 386 ﻫ) الذي دافع عن أبي الحسن الأشعري، وكالقابسي (ت. 4-403 ﻫ) الذي تسربت إلى آرائه في العقيدة بعض أقوال الأشعري. (راجع: عبد المجيد عمر النجار، فصول في تاريخ الفكر الإسلامي في المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1992، صص. 27-28).
([23]) يتحلى ذلك في كتبه التي ألفها لذات الشأن مثل: كتاب في إمامة بني العباس، ذكره عياض، المدارك، مصدر سابق، ج 4، صص. 601-602.
([24]) راجع: المدارك، المرجع السابق، ج 4، صص. 702-703.
([25]) النجار، فصول في تاريخ الفكر الإسلامي في المغرب، المرجع السابق، ص. 25.
([26]) المرجع نفسه.
([27]) عن هذه الاستفتاءات راجع: متشل بارت فتويان، من أواخر القرن الرابع الهجري، تتعلقان بالتجارة في الصحراء، ضمن المجلة التاريخية، مركز دراسات جهاد الليبيين، 1981، ص. 61-73.
([28]) عبد الحميد سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994، ج 4، صص. 161-162.
([29]) عياض، مصدر سابق، ج 4، صص. 586-587.
([30]) المصدر نفسه.
([31]) زغلول، مصدر سابق، ج 4، صص. 161-162.
([32]) راجع: مثلاً قصة بهذا الشأن يرويها يوسف بن يحيى التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية الآداب، الرباط، 1984، صص. 87-88.
([33]) راجع: سعيد بنسعيد العلوي، الخطاب الأشعري، دار المنتخب العربي، بيروت، 1992، ص. 10.
([34]) عياض، مصدر سابق، ج 4، صص. 586-587.
([35]) زغلول، مصدر سابق، ج 4، ص. 162.
([36]) النجار، مصدر سابق، صص. 28-29.
([37]) ابن عذاري، البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب، نشر كولان وبروفنصال، دار الثقافة، بيروت، 1983، ج 4، ص. 20.
([38]) راجع حول الموضوع: محمد الجابري، تكوين العقل العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، 1987، صص. 269-270.
([39]) سالم يفوت، مرجع سابق، ص. 63.
([40]) المرجع نفسه.
([41]) هناك دوائر غير مسلمة أو ليست في عداد أهل السنة ومثال هذه الأخيرة مجموعة سكان أوداغست وهم في أغلبهم زناتيون إباضيون وقد هاجمتهم فيالق المرابطين فدكت عليهم المدينة دكّاً سنة 449 ﻫ/ 1054 م، لكن أخطر الجيوب البدعية في الصحراء كانت هي ولا شك نحلة أدرار التي كان أصحابها يعتنقون اليهودية أو آراء الخوارج أو هذا جميعه، وإن كان بعض الباحثين يعتقد أنهم من الخوارج نظراً لأنه كانت تشيع بينهم عادة تربية الكلاب وقرم لحمها (Cynophajie) وهي عادة كانت منتشرة بين الأباضية الميزابيين كما يعرف أصحاب نفس النحلة بالبافور وذلك ضمن الرواية المحلية في موريتانيا اليوم وقد أباد المرابطون أصحاب هذه النحلة في يوم أغر من تاريخ الحركة، ولم تذكر المصادر أن أصحاب النحلة قد قبلوا الحلول الوسط، أو دخلوا في نقاش مع ابن ياسين مما يعني أنهم كانوا على غير دين الإسلام وهو ما أكده ابن عذاري في رواية من أدق الروايات حول الموضوع مما يبين أن الحركة المرابطية كانت تواجه خصومها في الصحراء بالمواجهات الاستئصالية لا بالمحاورات والمجادلات. (راجع: ابن عذاري، البيان المغرب…، مصدر سابق، ج 4، ص. 13؛ ليفيسكي، الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص. 347).
([42]) هربك، انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ضمن “تاريخ إفريقيا العام”، مصدر سابق، ج 3، ص. 96.
([43]) متكلم أشعري قيرواني الأصل، سكن أغمات ثم اصطحبه منها إلى الصحراء أمير المرابطين أبو بكر بن عمر، وولاه قضاءها، راجع عن حياته وآثاره: (رضوان السيد، مقدمة تحقيقه لكتاب “الإشارة إلى أدب الإمارة، للحضرمي، دار الطبقة، بيروت، 1981.
([44]) التادلي، مصدر سابق، ص. 1069.
([45]) رضوان السيد، مرجع سابق، ص. 17.
([46]) التادلي، مرجع سابق، صص. 105-106.
([47]) مجمل تاريخ المغرب، مصدر سابق، ص. 120.
([48]) الجراري، مرجع سابق، ج 3، ص. 194.
([49]) المقدمة، مصدر سابق، ج 3، ص. 9.
([50]) تشدد ابن ياسين في تطبيق الأحكام حتى اعتبر ذلك مأخذاً على دعوته وعلمه من ذلك أنه كان يعاقب المتخلف عن صلاة الجماعة بضربه 25 سوطاً، أما الذي تفوته الركعة الواحدة فيضربه 5 أسواط. (راجع” البكري، ص. 169) لكن يبدو أن هذا التشدد قد اقتضته اعتبارات ظرفية وهو ما أشار إليه عياض السبتي حينما نبه إلى أن ابن ياسين قد أخذ صنهاجة «بصلاة الجماعة.. إذ كانوا عنده ممن لا تصح له صلاة إلا مأموماً لجهلهم بالقراءة والصلاة»، (المدارك، ج 4، ص. 781).
([51]) يذكر البكري، ص. 169، أن ابن ياسين قد شذ في «أخذه الثلث من الأموال المختلطة ورغم أن ذلك يطيب باقيها»، غير أن هذا الحكم الذي أصدره ابن ياسين قد شوش عليه عنصر الإجمال الذي صيغ به في رواية البكري، كما أنه هو نفسه (تقريباً) الذي أجاب به ابن رشد عن نفس النازلة في فتوى عن استفتاء وصله من مرابطي الصحراء. (راجع: الإحالة 51).
([52]) الجراري، مرجع سابق، ص. 193.
([53]) راجع الونشريشي، المعيار المغرب…، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981، ج 9، صص. 542-543.
([54]) محمد بن أحمد بن رشد (450-520 ﻫ/ 1058-1126 م) أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة على عهد المرابطين من أعيان المالكية له تصانيف عديدة، مولده ووفاته بقرطبة، راجع: ترجمته ومصادرها في” الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج 5، صص. 316-317.
([55]) المعيار…، مصدر سابق، ج 10، صص. 449-450.
([56]) أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدين (439-508 ﻫ/ 1048-1114)، أجل فقهاء الأندلس وزعيمهم لعهده، كان على ما يذكره تلميذه عياض ذا نظر صحيح في الفقه والأدب البارع، ولي قضاء الجماعة سنة 490 ﻫ / 1097 م على عهد أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين. (عياض السبتي، الغنية، فهرس شيوخه، طرابلس – تونس، 1978، ص. 116).
([57]) راجع: محمد القبلي، مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، دار توبقال، الدار البيضاء، 1987، ص. 30.
([58]) القبلي، مرجع سابق، صص. 30-31.
([59]) المعيار، مصدر سابق، ج 9، ص. 543.
([60]) المصدر نفسه.
([61]) محمد بن داده، مفهوم الملك في المغرب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1977، ص. 111-114، والمصادر والدراسات التي أحال إليها.
([62]) راجع مثلاً الجنابي، العليم الزخار والبحر التيار، (مخطوط بالرباط) تحدث عن خلفاء أبي بكر بن عمر في الصحراء. (راجع: Fagnan, Extrait inedit Alges, 1924-27, pp. 354-359).
([63]) مثل رواية محمد أمبارك اللمتوني (القرن 19 م)، نظم تاريخ الدولة اللمتونية، مخطوط.
([64]) البكري، ص. 158.
([65]) موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي (363-430 ﻫ) أصله من فاس وبيته فيها مشهور ويعرفون ببيت أبي حاج استوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم، أما عن دراسته وصلاته بمعاصريه فقد تناولها في هذا البحث. (راجع: عياض، المدارك، مصدر سابق، ج 4، ص. 703-706؛ التادلي، التشوف…، مصدر سابق، ص. 87-89؛ مجهول، بيوتات فاس، دار المنصور، الرباط، 1961، ص. 45).
([66]) زغلول، مصدر سابق، ج 4، ص. 157.
([67]) المصدر نفسه.
([68]) مصدر سابق، ج 4، ص. 779.
([69]) مجهول، بيوتات فاس، مصدر سابق، ص. 28. ولفظ أجاج (أكاك) في لسان البربر هو الشخص الملم بالقرآن ومبادئ الدين فيكون واجاج: هو ابن الطالب، ويذكر المختار السوسي أن وفاة وجاج كانت سنة 445 ، وفي موريتانيا اليوم لا يزال يوجد انتشار لهذا الاسم. (مقابلة مع محمد بن مولود الشنافي، 30 أكتوبر 1994) (راجع عن حياة وجاج: ابن أبي زرع، ص. 123؛ الناصري السلاوي، الاستقصا، الدار البيضاء، 1990، ج 2، ص. 6؛ المختار السوسي، إليغ قديماً وحديثاً، المغرب،
د. ت، ص. 7).
([70]) ذكر البكري اسم المدينة بصيغة تامنارت وأنها في طرف صحراء غانة مما جعل الباحثين يعتقدون أن المدينة تقع قرب غانة نفسها، والأصح أن الاسم الصحيح هو تمنارت في بلاد جزولة التي تقع في الطرف الشمالي لصحراء غانة. (البكري، مصدر سابق، صص. 160-170؛ عياض، مصدر سابق، ج 4، ص. 781؛ ابن أبي زرع، مصدر سابق، ص. 78؛ حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1994، ص. 103).
([71]) عياض، مصدر سابق، ج 4، ص. 78.
([72]) المدارك، مصدر سابق، ج 4، ص. 780.
([73]) المصدر نفسه.
([74]) زغلول، مصدر سابق، ص. 139.
([75]) المصدر نفسه.
([76]) عياض، مصدر سابق، ج 4، ص. 780.
([77]) يتضح ذلك من مرجع عن طبقات المالكية في “مدارك” عياض في مواطن كثيرة.
([78]) عياض، مصدر سابق، ص. 780.
([79]) البكري، مصدر سابق، ص. 165. هاجر من تونس فقهاء عديدون إلى أغمات ومن أبرزهم الفقيه أبو محمد عبد العزيز التونسي، أصله من تونس وأخذ الفقه عن أبي عمران الفاسي وأبي إسحاق التونسي، وفضلاً عن صلة عبد العزيز بأبي عمران فقد كانت له علاقة هامة بالمصامدة (ربما تعلق الأمر بمشمول هذا الاصطلاح كما رأينا في البحث) الذين أخذوا عنه الفقه ثم عادوا إلى بلادهم (فسادوا في مواطنهم بما تعلموه من الفقه وصاروا قضاة وشهوداً وخطباء) فلعل عبد العزيز في اتصاله بالمصامدة وبتلاميذه منهم قد قام بدور ما في نشر تقاليد الجهاد والمرابطة التي قام بها أضرابه من تلاميذ الفاسي، ناهيك عن أنه قد رحل إلى “أقصى المغرب” ليتفقد أحوال تلاميذه وبأغمات توفي أيضاً محمد بن سعدون بن علي بن بلال القيرواني (ت. 480 ﻫ) أصله من القيروان، كان من أهل العلم والفضل، أخذ بمكة من المطوعي، ونحسبه أخذ أيضاً عن الفاسي بحكم أصله القيرواني ومهجره الأغمات واندراجه في طبقة عبد العزيز التونسي، إننا نحس أن المترجمين قد عاصروا الحضور المرابطي في أغمات على عهد أبي بكر بن عمر وكان الذي تشوف منهم لصحبة الأمير الصحراوي هو الحضرمي وحده بتميزه بمشروع خاص يظل يسعى له بين الممالك وهو ما سبقت منا إليه الإشارة. (رضوان السيد، مصدر سابق، ص. 7-10؛ التادلي، مصدر سابق، ص. 83-84 و93-110).
([80]) رضوان السيد، المصدر نفسه، ص. 10.
([81]) لا شك أن الحضرمي قد هاجر إلى أغمات قبل 444 على الأرجح لأن الإقامة لم تعد مأمونة بالقيروان بعد هذه السنة نظراً لتعرض المنطقة لطلائع زحف الهلايين. (راجع: ﻫ. ر. إدريس، الدولة الصنهاجية، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1990).
([82]) عبد الرحمن بن عمر بن محمد، اللغوي القزديري (أو القصدير) أبو القاسم: فقيه مغربي قرأ على شيوخ إفريقية وألف “بدعة الخاطر ومتعة الناظر” في المكاتبات الجارية نظماً ونثراً، لكننا نتساءل عن صلته بالمسمى أبا الحسن القزديري (أو القصديري) الذي يذكر أنه أول من ضرب الدراهم المعروفة باسمه (القزديرية) في السوس؟ (راجع: عبد الرحمن السيوطي (ت. 911 / 1505 م)، بغية الوعاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ط. 2، 1979، الترجمة رقم (150)، ج 2، ص. 85).
([83]) ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1979، القسم الرابع، ج 1، ص. 364.
([84]) ج. دفيس، المرابطون، مصدر سابقن ص. 374.
([85]) ابن أبي زرع، مصدر سابق، ص. 110
([86]) نعني عهد الأمير بن الفتوح وعجيسه ابين دوناس بن حمامة اليفرني، وهو عهد تدهورت فيه أوضاع السكان نتيجة لصراع الأميرين وظلم ولاتهما وظهروا المرابطين على أطراف البلاد. راجع: ابن أبي زرع، مصدر سابق، صص. 110-111.
([87]) عن هذه الطرق الظرفية راجع: ابن أبي زرع، المصدر نفسه، ص. 114-118.
([88]) المدارك، مصدر سابق، ج 4، صص. 702-703.
([89]) بيوتات فاس، مصدر سابق، ص. 28.
([90]) المصدر نفسه.
([91]) البكري، مصدر سابق، ص. 164.
([92]) راجع: عبد الله ﮔﻨﻮن، أبو عمران الفاسي، مجلة الثقافة العربية، يناير – فبراير 1970، صص. 52-53؛ ذكره زعلول، مصدر سابق، ج 4، ص. 160.
([93]) ابن عذاري، مصدر سابق، ج 4، ص. 7؛ البكري، مرجع سابق، ص. 165.
([94]) البكري، المصدر نفسه.
([95]) المصدر نفسه.
([96]) المصدر نفسه.
([97]) ابن عذاري، مصدر سابق، ج 4، ص. 7.
([98]) بيوتات فاس، مصدر سابق، ص. 28.
([99]) ذكره أحمد التوفيق، مساهمة في تاريخ المجتمع المغربي خلال القرن 19 (إينولتان 1850-1912)، منشورات كلية الآداب، الرباط، 1983، ص. 57؛ وانظر التادلي، مصدر سابق، ص. 89، الهامش.
([100]) المصدر نفسه.
([101]) المصدر نفسه.
([102]) المصدر نفسه.
([103]) التشوف، مصدر سابق، ص. 89.
([104]) اختلفت المصادر في تحديد مكان رابطة وجاج: البكري، مصدر سابق، ص. 165 يجعلها في ملكوس، وابن أبي زرع، ص. 123 يجعلها في نفيس، والإدريسي (ق. 6 ﻫ/ 12 م) يذكر موضعاً يسمى دار المرابطين؟ غير أننا نحسب الرباط كان موجوداً في “تيزنيت” بصحراء المغرب سكنها آولا.
([105]) ابن أبي زرع، مصدر سابق، صص. 122-123.
([106]) المصدر نفسه، ص. 123.
([107]) ابن عذاري، مصدر سابق، ج 4، ص. 10.
([108]) سعد زغلول، تاريخ المغرب، مصدر سابق، ج 4، ص. 154.
([109]) ابن عذاري، مصدر سابق.
([110]) المصدر نفسه.
([111]) المصدر نفسه.
([112]) المصدر نفسه.
([113]) المصدر نفسه.
([114]) راجع: ابن خلدون، العبر، 1925-1956، ج 1، ص. 257 ضمن دفيس، مصدر سابق،
ص. 376.
([115]) صص. 27-28.
([116]) التأم الحلف قبل وفاة عبد الله بن تيفاوت، ثم خلفه صهره يحيى بن إبراهيم الكدالي. (راجع البكري، مصدر سابق، ص. 175؛ بيوتات فاس، مصدر سابق، صص. 27-28).
([117]) راجع: ابن عذاري، مرجع سابق، ج 4، ص. 13.
([118]) ابن أبي زرع، مصدر سابق، ص. 126 و128.
([119]) ابن عذاري، مصدر سابق، ج 4، ص. 18.
([120]) لا تعني مصمودة قبيلاً واحداً بل إن الحلف المصمودي يشمل مجموعة من القبائل يذكر منها ابن خلدون قبائل جبل درن: هنتاتة وهرغة ووريكة، هذا إلى جانب قبائل برغواطة وغماره (المعارضين للحركة المرابطية) لكن عبد الواحد المراكشي يضيف أيضاً: صنهاجة وجزولة ولمطة وهزميرة وهزركة وهيلاته ووريكة. ولهذا فإن مؤلفي العصر الوسيط اختلفوا في تعداد قبائل المصامدة وهو ما يرجع إلى أن عملية التصنيف خضعت لمعايير الوزن البشري والفعل السياسي والموقف من الحركة الموحدية عموماً، ناهيك عن أنه في عهد الموحدين، وتبعاً لسياستهم التمييزية، قد ميزوا بين أنصار الحركة والقبائل “المغضوب عليها”. (راجع: الحسين بولقطيب، الحياة الاقتصادية للحلف القبلي المصمودي في القرنين الخامس والسادس الهجريين، مجلة الاجتهاد، عدد 18، 1993، ص. 59؛ محمد القبلي، حول مضمرات “التشوف” ضمن: التاريخ وأدب المناقب، دار عكاظ، 1987، ص. 66 وما يليها).
([121]) راجع: التادلي، مصدر سابق، صص. 89-90.
([122]) راجع: عبد الوهاب المراكشي، المعجم، ص. 483؛ ذكره بولقطيب، مصدر سابق، ص. 59.
([123]) ويضيف له ابن خلدون، العبر، ج 6، ص. 275 برغواطة وغمارة. (بولقطيب، مرجع سابق).
([124]) ابن عذاري، مصدر سابق، ص. 15.
([125]) المصدر نفسه.
([126]) المصدر نفسه. راجع ابن أبي زرع، مصدر سابق، ص. 36؛ وابن عذاري، مصدر سابق، ج 4، ص. 17، والمعلوم أن ابن ياسين لأسباب أشير إليها، لم يتعرف على البرغواطيين عندما كان راجعاً من الأندلس، أما عن النحلة البرغواطية ومعتنقيها فلا يعرف الشيء الكثير إلا أن أصل اسمهم في لسان البربر، هو يلغواطن أو الغواطن: المنحرفون، مما يعني أن النحلة أعطت اسمهما لأتباعها الذين لم يكونوا أبداً من قبيل واحد. (التادلي، مصدر سابق، ص. 52، هامش رقم 37؛ ابن عذاري، مصدر سابق، ج 4، ص. 10).
* أستاذ التاريخ بجامعة نواكشوط/مجلة “التاريخ العربي”
 مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير