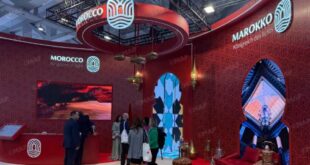ليست هناك دولة في ليبيا، ومع ذلك هناك قضاء يُصدر أحكاماً بالإعدام لعدد ممّن كانوا مسؤولين في العهد السابق. قد يقال إن «عدالة» نظام القذافي، إذا وُجدت، كانت فضيحة، وإن «عدالة المليشيات»، مهما شابتها العيوب، تبقى أقل ظلماً، لكونها «ثورية». هذا هو المنطق الأعوج الذي لا يقود إلى أي عدالة على الإطلاق. قد يكون بين المتهمين من يستحق الحكم بالموت، لكن إلباس الإجراءات ثوباً قضائياً يفترض أصولاً يجب اتّباعها، فهذه فرصة مزدوجة، أولاً لتأسيس مسار عادل وقانوني كان مفتقداً في البلد طوال عقود، وثانياً لكشف وقائع جنائية، سياسية وأمنية، ارتكبها رجالات القذافي، ومنهم نجله سيف الاسلام ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي. غير أن العملية برمّتها، محاكمة وأحكاماً، لم تحقق أياً من هذين الهدفين.
لم يكن الهدف من جلسة النطق بالقرارات سوى التقاط الصور وتعميمها للإيحاء بأن ثمة «دولة» في طرابلس، بدليل أن قضاءها يعمل كالمعتاد، كما سبق وفعل القضاء الدستوري في نوفمبر 2014 عندما أفتى بـ«عدم شرعية» البرلمان المنبثق من انتخابات يونيو من العام الماضي، موفّراً بذلك المبرّر «الدستوري» لإعادة تفعيل «المؤتمر الوطني العام» المنتهية صلاحيته، فقط لأن المليشيات التي سيطرت على العاصمة احتاجت إلى غطاء سياسي «شرعي» للانقلاب الذي نفّذته بعد فشلها الثاني في الانتخابات الثانية التي تشهدها ليبيا منذ سقوط النظام السابق.
أما لماذا السعي الى الإيحاء بوجود «دولة» في طرابلس فلأن مليشيات «فجر ليبيا» تريد إسقاط الاتفاق الذي وقّع في الصخيرات (المغرب) بين القوى السياسية وبإشراف الأمم المتحدة، ولأن «المؤتمر العام» الناطق باسم المليشيات لا يزال ينتظر تعديلات يصفها بـ«الجوهرية» على نص الاتفاق الذي يكرّس عملياً واقع أن هذا «المؤتمر» انتهت صلاحيته وأن البرلمان المعترف به داخلياً وخارجياً هو ذاك المنعقد في طبرق والمخوّل صلاحية التشريع. ولم يكن في إمكان المتحاورين في المغرب، أو المبعوث الأممي وفريقه، أن يحافظوا على ازدواجية «الشرعية» التي اعتقدت المليشيات أنها فرضتها كأمر واقع، وأن أي تسوية سياسية ستعتمد التقاسم في أسوأ الأحوال كي تتوصل إلى حل.
لم تفقد المليشيات الأمل في إفساد الاتفاق الموقّع، على رغم تأكّدها بأن فعاليات الشعب الليبي تؤيده، ومنها ما يمثّل جهات تدعم جماعات مسلّحة مشاركة في ما يسمّى «فجر ليبيا». ذاك أن واقع الفوضى الأمنية لا يزال يسهّل لعدد من «أمراء الحرب» إجهاض أو على الأقل تأخير الشروع في أي حل سياسي. وهذا التأخير ينطوي على مخاطر جدية كثيرة، بينها اثنان بارزان: أولهما أن الوجه «الثوري» لمليشيات طرابلس بات مدخلاً مشَرّعاً لنشاط إرهابي متوسع تحت رايتي «القاعدة» و«داعش»، وثانيهما أن التلكؤ في تنفيذ الاتفاق حتى أكتوبر سيدرك نهاية صلاحية مجلس النواب المنتخب، ما يعني نشوء وضع جديد ملائم للمليشيات، إذ تضيع فيه كل «شرعية» وتسوده الفوضى الكاملة.
كل ذلك جعل من محاكمة «القذافيين» أشبه بمشهد سوريالي تنطبق فيه المواصفات نفسها على المحاكِمين والمحاكَمين، وليس المقصود هنا شخوص القضاة أنفسهم. فالاتهامات التي وجّهت إلى الجالسين في قفص الاتهام، من قتل وتخريب وإشعال حرب أهلية وتفتيتٍ للوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلّحة وغيرها، يمكن أن توجّه أيضاً إلى الجهة (السياسية- المليشياتية) التي تحاكمهم. وكانت المحكمة الجنائية الدولية سجّلت اتهامات لعدد من «القذافيين» وتتناول عمليات الاغتصاب وجرائم حرب وضد الإنسانية، ولكن هذه المحكمة لم تمكّن من مهمتها رغم وجود قرار لمجلس الأمن يلزم ليبيا بتسليم المتهمين إليها. إذ أصرّت طرابلس غداة سقوط القذافي، على محاكمتهم جميعاً في الداخل. وكانت الحجّة آنذاك سيادية ووطنية، فالحكام الجدد أظهروا تصميماً على بناء «نموذج للعدالة» يقطع مع النمط السابق.
كان ذلك تحدّياً واعداً ولكنه سرعان ما انهار بفعل هيمنة المليشيات واعتراضها مسيرة إنهاض الدولة، حتى إنها تقاسمت احتجاز المسؤولين السابقين بين طرابلس ومصراتة والزنتان لأسباب شتى منها السياسي طبعاً ولكن أهمها البحث عن الأموال والأرصدة التي أخفاها نظام القذافي في بنوك خارجية. أما القوانين التي أصدرها «المؤتمر» تحت عنوان «العدالة الانتقالية» فاتخذتها المليشيات مسوّغاً لتصفية حسابات سياسية وجهوية أفرغت الإدارة من كوادرها وخبراتهم، كما أنها واصلت نهج التصفية الجسدية للعديد من العسكريين وكبار الموظفين والقضاة. وأكثر من ذلك ارتكبت المليشيات بعد سقوط القذافي أعمال قتل وتهجير واغتصاب وتدمير في سرت وبني وليد وتاورغاء لا تقل بشاعة عن جرائم من يحاكمون اليوم باسم «الثورة”.
* كاتب صحفي ومحلل سياسي/”الاتحاد”
 مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير