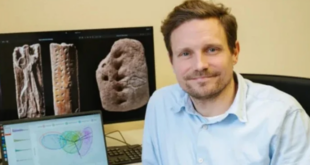يكتسب هذا الموضوع أهميته من التعثر الحاصل في التجربة الديمقراطية في بعض البلدان العربية، بعد ثورات “الربيع العربي”، حيث باتت التيارات الدينية والعلمانية والليبرالية في حالة صراع فيما بينها، إلى درجة باتت تهدد معها وحدة المجتمعات العربية واستقرار نظمها السياسية.
الجدير ذكره أن هذه الصراعات أو التوترات ليست جديدة إذ أن الثقافة السياسية العربية ظلت تكابد، منذ مطلع القرن العشرين، في سبيل توطين مضامين التحولات الفكرية والسياسية الكبرى، التي كانت ظهرت في المجتمع الغربي، وبالخصوص منها نزعات العلمانية والليبرالية والديمقراطية والشيوعية والقومية، والتي كانت أسست لحداثته ونهضته، وأيضا لمجادلاته وانقساماته.
وكما هو معلوم فقد تمت محاربة كل هذه التيارات بدعوى أنها مستوردة من الغرب وباعتبارها دخيلة على الواقع والثقافة العربيين، في وضع عربي كل شيء فيه مستورد، من الملابس، إلى تنظيم الجيوش والطرق والمدن والبنوك، ومن أنظمة التعليم والصحة والريّ والقضاء والاقتصاد والحكم، إلى العادات الاستهلاكية والترفيهية والصحية، وصولا إلى الثلاجة والغسالة والتلفاز والساعة والحاسوب والهاتف والموبايل.
على أية حال فإن مدركات الثقافة العربية السائدة للأفكار المذكورة جاءت جد متفاوتة، إذ تم تمثل فكرة القومية، مثلا، أكثر من غيرها (مع أنها فكرة غربية)، بسبب وجود خلفيات تاريخية وثقافية لها، وبواقع استنادها لزعامة كبيرة بحجم الرئيس جمال عبد الناصر.
ولنا أن نتخيل مآلات هذه الفكرة لولا هذه الشخصية، بدليل عدم نشوء أحزاب قومية في العالم العربي، ولا سيما في مغربه، إذا استثنينا حزب البعث (الذي نشأ في سوريا والعراق أساسا)، وحركة “القوميين العرب” التي انتهت في فترة مبكرة.
وبالنسبة لفكرة الشيوعية فقد لاقت نجاحا محدودا، في مراحل معينة، على خلفيات سياسية فقط، وليس لاعتبارات أيديولوجية أو ثقافية، أي بحكم قوة الاتحاد السوفياتي، وشبكة العلاقات التي كانت ربطته بالأنظمة (كما بالأحزاب الشيوعية) في البلدان العربية، وبواقع المناخ الجماهيري المعادي للإمبريالية الأميركية المتحالفة مع إسرائيل، وربما بحكم توق الناس في هذه البلدان للعدالة الاجتماعية المتضمنة في فكرة الاشتراكية.
أما فكرة الديمقراطية فقد لاقت قبولا أكبر، بالقياس لغيرها، في الثقافة السياسية السائدة في المجتمعات العربية، باعتبارها تغذي الحاجة، عند أطراف وتيارات متضاربة، للتغيير السياسي، وتمهد لوضع حد لنظام الحكم المطلق، وللتخلص من ويلات الفساد والاستبداد، في آن.
وكان أن بات ثمة نوع من إجماع على الديمقراطية لدى مختلف التيارات الفكرية والسياسية العربية (يسارية وإسلامية وقومية ووطنية وليبرالية وعلمانية)، باستثناء الأنظمة المتسيدة التي ناهضتها العداء، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تيار اشتهى الديمقراطية كوسيلة، وبالمعنى المحدود لها.
مقابل ذلك فإن فكرتي العلمانية والليبرالية ظلتا في مكانة محاصرة، أو هامشية، أو في مكانة استبعادية وعدائية في الثقافة السياسية السائدة.
الأولى (أي العلمانية) بسبب عداء التيارات الدينية لها على طول الخط، إلى درجة “التكفير”! وأيضا بسبب عدم هضمها من قبل التيارات الأخرى (القومية والوطنية والليبرالية)، التي أبدت أيضا نوعا من الانتهازية في تعاطيها مع فكرة العلمانية (وهذا ينطبق على النظم السياسية السائدة)، وذلك بدعوى مراعاة الميول الدينية في المجتمعات العربية، وبهدف توظيف المشاعر الدينية في الأغراض السياسية.
أما الثانية (أي الليبرالية) فقد نبع العداء لها من عدم تبني معظم التيارات السائدة قضايا الحرية والتحرر، أي حرية الرأي والفكر والمرأة والأفراد والجماعات، ومن ضعف الثقافة الحقوقية، وأيضا بسبب ارتكازها إلى فكرة الفرد المواطن، والمساواة أمام القانون، وفصل السلطات، والدولة الدستورية، في واقع يؤبد السيطرة الأحادية والشمولية (الأب في الأسرة وزعيم العشيرة في عشيرته، ورجل الدين في مسائل الدين، وزعيم الحزب في حزبه، ورئيس الدولة في دولته).
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الدعوة إلى العلمانية لم تلق ما كابدته الليبرالية من إشكاليات أو ادعاءات، مع أنها في حقيقتها دعوة للحرية والتحرر، للأفراد والمجتمعات، إزاء مختلف أنواع الهيمنة الفكرية أو السياسية، المجتمعية أو الدولتية. هكذا وصمت الليبرالية بشبهة التبعية السياسية (وليس فقط الفكرية) للغرب (المتحالف مع إسرائيل)، أي أنها وصلت إلى درجة “التخوين”، مع أن قوامها التحرر من أية تبعية، ربما لارتباط هذه الفكرة بالفئات المدينية التي صعدت في بلادنا في مرحلة الاستعمار، وأسست للاستقلال، في بلاد عانت من الاستعمار.
ومشكلة الليبرالية عندنا، أيضا، أنها ارتبطت بالليبرالية الاقتصادية، أكثر من ارتباطها بالدولة الدستورية وبالحريات السياسية وبحقوق المواطنين، ما وضعها على الضد من العدالة الاجتماعية، في مجتمعات ترزح تحت نير الفقر والحرمان.
المفارقة اللافتة أن الفكرة الليبرالية راجت في البلدان العربية في المجال الاقتصادي، وفي مجال علاقة البلدان العربية مع الدول الغربية، أي فقط في المجالات التي نبذت من أجلها، في حين أنها ما زالت محاصرة، وموضع شبهة في المجالين السياسي والثقافي، حيث الحاجة لها ملحة.
في المحصلة فقد نشأت كل تلك التيارات مأزومة، إذ لم تتشكّل بوصفها تيارات واعية لذاتها، لا من جهة تمثيلها لكتل مجتمعية معيّنة، ولا من جهة تعبيراتها أو دلالاتها السياسية أو الثقافية.
ثمة عدد من الأسباب التي تفسّر ذلك، أهمّها أن هذه التيارات لم تنشأ في البيئات المحليّة لهذه البلدان، أي في جامعاتها وأحزابها ومنتدياتها وصحفها ودور النشر والثقافة فيها، وإنما بفضل الاحتكاك أو الاصطدام مع الغرب، لا سيما في التجربة الاستعمارية.
والمفارقة أن هذه البلدان تمثلت المنجزات المادية، الاستهلاكية والتكنولوجية، للحداثة الغربية، في حين تحفّظت على منجزاتها الثقافية، وضمنها أفكارها السياسية والثقافية الكبرى، في ما بات يعرف بالتحديث من دون حداثة.
طبعا يمكن إحالة هذا التحفّظ إلى المصادفة التاريخية، التي جمعت بين الاستعمار الذي يمثّله الغرب والأفكار السياسية والثقافية الصادرة عنه، والتي ظهرت باعتبارها بمثابة دعوة للالتحاق بالغرب، لا اللّحاق به، وباعتبارها محاولة جديدة لطمس الهوية، لا لمواءمتها مع حقائق العصر ومتطلّبات التطوّر.
عدا كل ذلك، ثمة، أيضا، العامل المتمثّل بقوّة الموروث الديني، الذي بات بمثابة خطّ دفاع عن الذات وعن الهويّة، والذي تفاقم دوره بعد أن تجاذبته الأهواء السياسية وحوّلته إلى نوع من أيديولوجيا مغلقة، ذات نزعة سلطوية، مع التحفّظ على الادّعاء المتعسّف القائل بأن ثمة شيئا جوهريا في الإسلام يحول دون التطبّيع مع الحداثة الثقافية.
لكن السبب الأساس لتعثّر الأفكار الأساسية للحداثة الغربية، باعتبارها منجزا إنسانيا، لاسيما المتمثلة بالعلمانية والليبرالية والديمقراطية واليسارية، إنما يعود إلى طبيعة السلطات التي تحكّمت في البلاد والعباد في العالم العربي.
وقد بيّنت التجربة أن هذه السلطات بطبعتها الشمولية، القائمة على الاستبداد والفساد، عوّقت قيام الدولة، باعتبارها دولة مؤسّسات وقانون ومواطنين، وعوّقت تحوّل الكتل المجتمعية إلى مجتمعات بمعنى الكلمة، بتكريسها إياها عند حدود الانتماءات الأوليّة، ما قبل المدنية (المذهبية والطائفية والإثنية والقبلية)، كما عوّقت قيام الفرد/المواطن، بتنميطه على صورتها، وبحرمانه من حريته وحقوقه، وامتهان إنسانيته وفرديته.
فهذا النوع من الأنظمة هو المسؤول عن تأخّر البلدان العربية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والتعليم والثقافة والفن، وعن غياب المجال العام المشترك (الجامعات والسينما والمسرح والمنتديات الثقافية والفنية)، وعن تزييف المدينة، فضلا عن أنه المسؤول عن تحريم السياسة والحياة الحزبية.
هذا الوضع، الناجم عن تسلط النظم الاستبدادية، هو الذي أدّى إلى تأزّم مفاهيم العلمانية والليبرالية والديمقراطية واليسارية في البلدان العربية، وتشوّه ونقصان مفاهيمها وحمولاتها الثقافية والسياسية والحقوقية، وهو ما بتنا نشهد تمثّلاته وعواقبه في معمعان الثورات الشعبية الحاصلة، التي تتوخّى قيام الدولة القائمة على المواطنة وعلى الحرية والكرامة.
ففي خضم هذه الثورات بدأت المجتمعات تنفتح على ذاتها وتكتشف تعدديتها وتنوّعها، وتصوغ إجماعاتها الوطنية، وتتعرّف على هويتها الجمعية، وعلى مشتركاتها واختلافاتها، بطريقة هادئة وصامتة أو بطريقة عنيفة وصاخبة.
المشكلة أن هذه الثورات كشفت حدود مكانة مختلف التيارات العاملة في المجتمعات العربية، واختبرت صدقيّة ادعاءاتها، وتناقضات مواقفها.
هكذا شهدنا، مثلا، وقوف أحزاب شيوعية ويسارية مع نظم استبدادية، تتبنى الليبرالية الاقتصادية المتوحّشة، وهذا ما حصل أيضا مع اتجاهات يفترض أنها ليبرالية! كما شهدنا اتجاهات علمانية وديمقراطية ويسارية تمحض تأييدها نظما لمجرّد رفضها صعود التيار الإسلامي، ولو في انتخابات حرّة!
هذا يعني أن النظم الشمولية التي عمّمت خاصيتها على المجتمع، طبعت، أيضا، مختلف التيارات بطابعها، أي بـ”طبائع الاستبداد” (بحسب تعبير لعبد الرحمن الكواكبي)، ما يفسّر تحالف بعض من تيارات ليبرالية وعلمانية وديمقراطية ويسارية معها، والتي تعاني، بدورها، من قصور في النضج، ومن تشوّه في محاولاتها تمثل مدلولاتها السياسية والثقافية.
وقد يمكننا ملاحظة كل ذلك في قصور التأسيس لمفاهيم ونظم الديمقراطية، فهذه، مثلا، لا يمكن اختزالها إلى محض عملية انتخابية، أو مجرّد تبادل أو تقاسم للسلطة، بين لاعبين سياسيين باسم أكثريات معيّنة.
وفي الواقع فإن منشأ هذا القصور ناجم أساسا عن نقص تمثّل الديمقراطية عندنا للحمولات الليبرالية، في محدّداتها السياسية والقانونية والثقافية، التي تعلي من قيمة الفرد، ومن حريته، واستقلاليته، ومن حقوقه، والتي تؤكّد الدولة باعتبارها دولة مؤسسات وقانون ومواطنين.
فالديمقراطية من دون ليبرالية (كمذهب في الحرية الفكرية والفردية) تبدو ناقصة ومشوّهة، لأنها لم تنبن على حرية الأفراد والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان.
في المقابل فإن الليبرالية من دون ديمقراطية هي ليبرالية ناقصة ومشوّهة، أيضا، لأن حرية المواطنين المتساوين في الحقوق هي الأساس في الليبرالية، أي في مذهب الحرية، لأن هذا النوع من المواطنين هم الذين يتمثّلون ويتخيّلون ذواتهم الجمعية كشعب ويقيمون العقد الاجتماعي اللازم لبناء الدولة الديمقراطية.
ويستنتج من ذلك أن مجتمعاتنا، على تنوّعها وتعدّدها، في حاجة إلى اعتماد النظام الديمقراطي الليبرالي، الذي يعني قيام دولة المواطنين الأحرار والمتساوين، دولة المؤسسات والقانون، لأنه في مثل هذا النظام فقط ليس ثمة أغلبية دائمة وأقلية دائمة، وليس ثمة أكثرية لا تحترم رأي الأقلية، ولا أكثريّات وأقليّات على أساس هويّات فرعية، دينية أو إثنية، وإنما ثمة أكثريات وأقليّات وفق المصالح الاقتصادية/الطبقية والتوجهات السياسية والفكرية.
هكذا، لا يمكن تأسيس الديمقراطية من دون حامل ليبرالي، أي بدون حمولات تتضمن معنى الحرية، وهذه أيضا مسألة لم تطرح في التجربة الديمقراطية الأوروبية، لأنها مسألة ناجزة، كونها أسبق من الديمقراطية (أجاز البرلمان الإنجليزي مُسوَّدة حقوق الإنسان 1789).
فالديمقراطية ينبغي أن تتأسس أصلا على الحرية والعقلانية والدولة الدستورية، وعلى فصل السلطات، والمساواة أمام القانون، وتداول السلطة، واحترام حقوق الإنسان والجماعات، من دون أي تمييز ولا لأي سبب.
قصارى القول، ففي نظام الديمقراطية الليبرالية تكون الحرية مضمونة للجميع، أفرادا وجماعات، على قاعدة المساواة، فلا حظر ولا منع لأي تيار أو حزب، طالما هذا التيار أو الحزب يؤمن بالحرية وبالمواطنة المتساوية، وطالما أنه يدعو لأفكاره، أو لبرنامجه، بتوسل الطرق السلمية، وطالما أنه يحاول الوصول إلى السلطة بالطرق الديمقراطية.
“الجزيرة”
 مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير